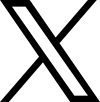ويدفع الأطفال الأبرياء ثمن الحرب وتعدّد الأسلحة
أسبوع واحد، بعد أن دفع أطفال قرية مجدل شمس الجولانيّة الأبرياء، حياتهم في مذبحة أوقعت بينهم 12 ضحية وعشرات الجرحى، ثمنًا لحرب السابع من أكتوبر 2023 العبثيّة، وخمسة أيام قبل أن تُنهي هذه الحرب شهرها العاشر، مسجّلة بذلك أرقامًا قياسيّة في فظاعتها ومدّتها وغموضها، وتعدّد أسمائها وأوصافها ومحاولات تبرير

بل شرعنة بدايتها ومسوّغات استمرارها، مع اختلاف الروايات وتبدُّلها، بات واضحًا أنها تختلف عمّا سبقها من حروب، وهي كثيرة، للأسف، في منطقتنا. وأنها حرب يصحّ فيها وصفان أوّلهما ما قاله ابن خلدون في مقدّمته الشهيرة، حول كون أصل الحرب إرادة انتقام بعض البشر من بعض، وهي إرادة أسبابها أربعة تتوفّر كلّها في الحرب الحاليّة، والتي تحوّلت بشكل واضح إلى حرب انتقاميّة، بل بدأت كذلك بهجمات حركة "حماس" في السابع من أكتوبر،
وهي فرض السيطرة وتوسيع النفوذ ومحاولة انتزاع ما يملكه آخرون بالقوّة، إضافة إلى الجانب الدينيّ بمسمّياته "الجهاد" فلسطينيًّا، أو " القضاء على العمالقة" إسرائيليًّا، والصدام بين الدول والمانعين لطاعتها ، وثانيهما أنها حرب اختلط الحابل فيها بالنابل،
وتغيّرت فيها أنماط المواجهة، لتؤكّد بذلك أنها ربما المثال الساطع والمؤلم والخطير لما ستكون عليه الحروب القادمة وخاصّة ما يسمّيها خبراء العسكر الحرب المختلطة أو المشتركة، وهي تطبيق، أو استخدام لاستراتيجيّة عسكريّة تدمج الحرب السياسيّة والحرب العسكريّة الكلاسيكيّة وتلك غير النظاميّة، والحرب الإلكترونيّة السيبرانيّة عبر منصّات الإنترنت المختلفة،
وتشمل نشر المعلومات المُضلّلة والأخبار المزيفة، إضافة إلى النشاطات الدبلوماسيّة، وحرب الدعاوى أمام المحاكم الدوليّة، والمطالبة بالتحقيق مع المسؤولين وأصحاب القرار السياسيّ والعسكريّ في كافّة أطراف الحرب بتهم ارتكاب جرائم حرب وأعمال منافية للقانون الدوليّ وحقوق الإنسان، كما يتم اليوم بما يتعلّق بطرفي الحرب الحاليّة من الفلسطينيّين والإسرائيليّين، وربما سينضمّ إليهم قادة "حزب الله" بعد الاعتداء الآثم في مجدل شمس، والتدخّل في انتخابات الدول،
ومحاولات المسّ باللحمة الداخليّة للدول والأقاليم ودفع مواطنيها إلى الهجرة، أو التخلّي عن التطلّعات والثوابت، هذا إضافة إلى محاولات نزع الشرعيّة الحضاريّة والثقافيّة عن الطرف الآخر ،كما جاء في خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس من أنها حرب بين الحضارة والتزمّت الدينيّ، وبين قوى النور والتقدّم وقوى الظلام والإرهاب. وهي محاولات تذكي الصراع الدينيّ والعرقيّ، وتحاول رفع ألسنة الفتنة بكافّة أشكالها المذهبيّة والدينيّة والجغرافيّة والأيديولوجيّة، تمامًا كما جاء في دراسة مساعد وزير الدفاع الأمريكيّ الأسبق والخبير في الشؤون العسكريّة الدكتور فرانك هوفمان، حول هذا الموضوع بعنوان: "الصراع في القرن الحادي والعشرين: صعود الحروب الهجينة".
وإذا كانت الحرب التي لا تبدو نهايتها في الأفق، رغم حديث يتكرّر دون نتائج، أو تطوّرات على الأرض حول صفقات لتبادل الرهائن والسجناء، ووقف مؤقّت ومرحليّ للحرب، عبثيّة وغير واضحة الأهداف والمعالم في قطاع غزة، كما تؤكّد مجرياتها العسكريّة إسرائيليًّا، وتكرار اجتياح مناطق في القطاع كان الجيش الإسرائيليّ قد اعتبرها مناطق آمنة في عرفه،
وفلسطينيًّا عبر إصرار قيادات "حماس" على إطالة المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن، رغم استهداف واغتيال بعضهم وآخرهم رئيس المكتب السياسيّ إسماعيل هنية الذي اغتيل صبيحة الأربعاء ، الحادي والثلاثين من تموز ،فإنها عبثيّة أكثر، بل أضعاف ذلك، على الحدود الشماليّة، وأصبحت دمويّة بامتياز بعد الاعتداء الآثم على قرية مجدل شمس،
والذي كان حدثًا أدرك الجميع إسرائيليًّا ولبنانيًّا وفلسطينيًّا، وعلى صعيد "حزب الله" ، بل ربما على الصعيد العالميّ، أنه يغير قواعد اللعبة، وأنه يتجاوز قواعد الاشتباك المتعارف عليها في المنطقة الشماليّة، وهي قواعد يقبلها البعض جزافًا متناسين الحقيقة الصارخة، أن لا مبرر ولا سبب منطقيًّا ومفهومًا، لاندلاع الحرب والصدام العسكريّ فيها وعليها، باستثناء الجانب الدينّي الجهاديّ، والرغبة في تعزيز السيطرة السياسيّة والشعبية لإيران التي تدعم "حزب الله" و"حماس" بالعتاد والمال، وقبلها الرغبة في الانتقام واستغلال الفرصة،
لتحقيق مكاسب لا علاقة لها بالحرب، يستعين "حزب الله" خلالها بأيديولوجيّات، بل حجج ، لم ينزل الله بها من سلطان، تشكّل إضافة بعد جديد إلى حروب القرن الحادي والعشرين تحت مسمّى" حرب الإسناد" وهو التسمية الدبلوماسيّة والناعمة والفضفاضة، لواقع هو في الحقيقة اختلاق أسباب غير قائمة للمواجهة والصدام العسكريّ، وزجّ الجنوب اللبنانيّ ومعه لبنان كلّه في أتون حرب لا ناقة له فيها ولا جمل، في تأكيد ساطع على خصوصيّة حالة لبنان الذي يمكن دون أيّ نوعٍ من التجنّي،
اعتباره كيانًا سياسيًّا من نوع خاصّ، يفتقر إلى مقوّمات الدولة السياديّة عبر فراغ دستوريّ غير مسبوق يشمل رئيس الدولة ورئيس الوزراء والسلطة العسكريّة التي لا تستطيع ضمان مبدأ الجيش الواحد والسلاح الواحد، بل تقبل مرغمة بواقع يشكّل "حزب الله" فيه القوة العسكريّة التي تحدّد وجهة البلاد وصاحبة القرار حول خوض حرب أم لا، وحكومة تسيير أعمال لا حول لها ولا قوّة تحاول إرضاء "حزب الله" برلمانيًّا، وتكرّس حالة التشرذم السياسيّ والتقسيم الطائفيّ، بخلاف كافّة أسس الدولة ذات السيادة السياسيّة والعسكريّة والاقتصاديّة، الدولة القابلة للحياة، وهي حالة تؤكّد خطورتها التطوّرات الأخيرة التي ترتبت على مصرع الأطفال في مجدل شمس، والذي كان وفق كافّة الدلائل، خطوة واحدة أبعد ممّا يمكن احتواؤه ضمن قواعد الاشتباك المتّبعة في الشمال في الأشهر العشرة الأخيرة.
إزاء ما سبق لم يكن غريبًا، أن يدرك "حزب الله" أن الاشتباك المذكور تحوّل إلى أتون حرب مشتعلة، وقودها هذه المرّة الأطفال الأبرياء، وأن يدرك أن ذلك وعلى خلفيّة الوضع المميَّز لهضبة الجولان وقراها المختلفة، يسحب البساط من تحت ادّعاءاته حول الإسناد ووحدة الأراضي السوريّة واللبنانيّة ودعم الأخوة الفلسطينييّن وضرب الأهداف العسكريّة الإسرائيليّة. ولعلّ أفضل تعبير عن هذا الإدراك هو إسراع" حزب الله" إلى التنصّل من المسؤوليّة ونفي التصريحات الإسرائيليّة المدعومة بالأدلّة،
حول قيامه باستهداف قرية مجدل شمس في الجولان بصاروخ إيرانيّ الصنع يحمل عشرات الكيلوغرامات من المتفجّرات، وتأكيده على حدّ تعبيره، أن "لا علاقة للمقاومة الإسلاميّة بالحادث على الإطلاق"، وذلك في محاولة منه لاحتواء الأزمة، ومحاولة تخفيف الصدمة وربما منع إسرائيل من استخدام واحد من وسائل "الحرب الهجينة" وهي محاولة اثارة الخلافات الداخلية،
خاصة وان القرية المنكوبة تحمل رمزيّات كثيرة وكبيرة باعتبارها أكبر القرى في الجولان ومركز للقيادة الدينيّة والروحيّة فيها وموقف أهلها من العلاقة مع سوريا ورفض قانون الجولان، أو الهويّة الإسرائيليّة عام 1982، وما تبع ذلك من تحرّكات شعبيّة وسياسيّة هناك، ناهيك عن تأثيرات التركيبة الطائفيّة في سوريا ولبنان، وتحديدًا العلاقة بين الطائفة العربيّة الدرزيّة بدورها التاريخيّ والقوميّ والتحرّريّ البارز في سوريا، وبحكم العلاقة القريبة بين "حزب الله" ووليد جنبلاط في لبنان اليوم،
خاصّة على ضوء أصوات في لبنان تطالب بوضع حدّ لفوضى السلاح الذي يملكه "حزب الله"، ومنعه من جرّ لبنان إلى حرب هو في غنىً عنها، ستدمره اقتصاديًّا وعسكريًّا، وستهدم البنى التحتيّة، خاصّة مع تضاؤل دور الدول الخليجيّة في لبنان وقلّة حماسها لإعادة البناء ، بعكس الحروب السابقة، وبالتالي برزت في لبنان أصوات اعتبرها البعض، تكشف عن حقيقة الانقسامات الداخليّة، وتكشف الحقيقة التي يحاول الكلّ إخفاءها، مقابل دعوات إلى الامتناع عن إعطاء إسرائيل ما تريد من دقّ لأسافين الفتنة بين طوائف لبنان وسوريا، بادّعاء يعيدنا إلى سبعينيات القرن الماضي حول ضرورة إخفاء الخلافات والنقاشات الداخليّة، وإبداء موقف موحّد تجاه الخارج، بادّعاء أن اختلاف الرأي مثل هذا الظرف يضرّ ولا ينفع، وأنّ المطلوب إظهار حدّ أدنى من التفاهم الوطنيّ،
على شاكلة ووزن الدعوات إلى تأكيد "الوحدة العربيّة من الخليج الهادر إلى المحيط الثائر" بينما في الحقيقة لا وحدة ولا لُحمة، وكلّها نقاشات تؤكّد، بغضّ النظر عن النوايا الإسرائيليّة وردّ فعلها ضد "حزب الله" ودولة لبنان، أن ضربة مجدل شمس في هذا الإطار أخرجت الأمور عن السيطرة،
وأنها تشكل سببًا كافيًا، أو ذريعة لضربةٍ يتعرّض لها لبنان، قد تكون محدودة زمنيًّا لكنها قاسية قياسًا بما كان حتى اليوم، وهو ما كان قد رشح عن مصادر إسرائيليّة من حديث حول جولة عسكريّة تستمرّ عدّة أيام لا تتحوّل إلى حرب شاملة، في حديث يعيد إلى الأذهان ما قيل عن هجمات السابع من أكتوبر والتي لم ترد لها قيادات "حماس أن تتحوّل إلى حرب كما اليوم، والحديث حينها عن ردّ إسرائيليّ حاسم وسريع لعدّة أيّام، تحوّل إلى حرب تقترب من عامّها الأوّل يجزم كثيرون أنها ستبلغه، وكلّ ذلك وسط إجماع على اختلاف هجوم مجدل شمس عن غيره من الأحداث والتطوّرات التي سُجّلت على الجبهة الشماليّة منذ الثامن من تشرين الأول الماضي، إذ أعلن "حزب الله" إطلاق عمليّات عسكريّة أسماها معركة إسناد لقطاع غزة، شهدت تصعيدًا أكثر من مرّة، دون أن تشهد حدوث مثل هذا الهجوم والتصعيد من قبل.
والحديث السلاح الواحد ، هو الحديث بكلمات أخرى عن كون الدول تتفتّت أولًا من الداخل، والخطوة الأولى نحو هذا التفكّك هي اختفاء الجيش النظاميّ الواحد خاصّة في الشرق الأوسط والأمثلة كثيرة، وبالتالي فالحديث يتمحور حول "حزب الله" اليوم بفعل الوقائع والأحداث الآنية، لكنّه ليس حديثًا نظريًّا، كما أنه ليس حالة وحيدة في منطقة الشرق الأوسط، والتي " تعشق" فئاتها السلاح ،
دون أن تدرك، أو ربما لا تريد أن تدرك ، أن السلاح الواحد ليس أمرًا عسكريًّا وأمنيًّا فقط، بل إنه رمز سيادة وقانون ونظام، يعني توزيعًا للمهام والصلاحيّات والمسؤوليّات ويمكن من محاسبة ومساءلة من ليس على قدر مسؤوليّته، ناهيك عن أنه يعني قبل ذلك ، اعتبار سلاح جيش الدولة وسلاحه واحدًا من مقوّمات وجودها كدولة موحّدة تحمي جميع مواطنيها وتضمن أمنهم، وتصون حدودها الخارجيّة ومياهها الإقليميّة، وتكفل تنفيذ قرارات المستوى السياسيّ الوطنيّ،
أو العام أي الحكومة الشرعيّة ، وليس محاولة الإطاحة بها، أو منافستها في السيطرة على مناطق من البلاد كما يسيطر "حزب الله" اليوم على الجنوب اللبنانيّ جغرافيًّا وعسكريًّا، ويعتبر قواته بمثابة الجيش النظاميّ هناك، ما يفتّت سلطة الدولة ويمنع استمرار وجودها، وهي حقيقة تكرّرت في الشرق الأوسط مرّات عديدة في دول قائمة، وأدّت إلى انهيارها كما حدث في سوريا وليبيا والسودان واليمن والعراق بفئاته من الأكراد والسنة والشيعة، ولكلٍّ قوّاته وسلاحه، إضافة إلى لبنان ،
كما أن عدم وجود سلاح واحدٍ، هي قضيّة قد تحول دون قيام كيان ما، أو تعيق ذلك ، سواء كانت أسباب تعدد الأسلحة والجهات الأمنيّة سياسيّة تهدف إلى ضمان الولاء للرئيس دون غيره ، أو فئويّة تعكس الانقسام، ولعلّ المثال على ذلك هو الحالة الفلسطينيّة والأسئلة الكثيرة التي أُثيرت فور قيام السلطة الفلسطينيّة بعد اتفاقيّات أوسلو عام 1993، حول تعدّد الأجهزة الأمنيّة وأسلحتها ووظائفها، كالأمن الوقائيّ والشرطة ( العاديّة والبحريّة والجوّيّة) والمخابرات العسكريّة والمخابرات العامّة والأمن الرئاسيّ وخاّصة ما تم تسميته "القوّة 17" والتي تحوّلت من قوّة عسكريّة تابعة لحركة " فتح" إلى جزء لا يتجزّأ من الحرس الرئاسيّ، بمعنى تكريس "تعدّد الأسلحة"، في حالة تفاقمت، بعد أن تشكّلت الوحدات العسكريّة والمسلّحة التابعة لحركة "حماس"، وغيرها من الجماعات المسلحة المنتمية إلى فصائل فلسطينيّة مختلفة كالجبهة الشعبيّة مثلًا، أرادت كلّ منها السيطرة على منطقة ما.
وهي حالة منعت وحدة مناطق السلطة الفلسطينيّة وربما منعت إقامة كيان فلسطينيّ خاصّة وأن العمليّات العسكريّة لحركة "حماس" فور توقيع الاتفاقيّات كانت السبب الرئيسيّ في وقف تنفيذها ناهيك عن صعود اليمين وبنيامين نتنياهو في إسرائيل، وحوّلت لاحقًا وبعد العام 2007 قطاع غزة إلى كيان منفصل، تم تسخير كافّة مقدراته وأمواله لغرض واحد، وهو بناء قوّات مسلحة وحفر أنفاق بطول مئات الكيلومترات، وصولًا إلى الوضع الحاليّ من مواجهة عسكريّة متواصلة مع إسرائيل، وحرب دمّرت القطاع بالكامل، ليصبح أكثر ممّا كان سابقًا غير قابل للحياة، وهي حالة تتكرّر اليوم، وتتواصل عبر خلق مناطق لا تتمكّن قوات الشرطة الفلسطينيّة، أو الأجهزة الأمنيّة الرسميّة فيها، من دخولها خاصّة مخيّمات منطقة جنين ومناطق أخرى في نابلس وغيرها.
أمّا إسرائيل، والتي شكّل السابع من أكتوبر 2023، ضربة كبيرة وقاسية وغير مسبوقة، لقوّتها العسكريّة وجيشها القويّ ومخابراتها التي لا تخفي عليها شاردة أو واردة، ليست بمنأىً عن الحديث حول سلاح واحد وجيش واحد وأوامر عسكريّة واحدة وموحّدة تُطاع دون تردّد أو نقاش، باعتبارها أوامر عسكريّة يقال عنها في العُرف الإسرائيليّ العسكريّ:" إذا تلقيت الأوامر، أطع ونفِّذ، وناقش بعد التنفيذ، إن أردت".
وهي التي اعتمدت في قيامها على جيشها الواحد وسلاحها الواحد، باعتباره المبدأ الأوّل والأهمّ، بل المصيريّ الذي صانه أولئك الذين عملوا على إقامتها، ومنهم رئيس وزرائها الأوّل دافيد بن غوريون، والذي رفض رفضًا قاطعًا وجود أكثر من سلاح حتى أنه أصدر أوامره بقصف سفينة" التالينا"، التي حاولت قوّات "الإيتسل" المسلّحة والتي تنتمي إلى التيار اليمين المتشدّد حينها برئاسة مناحيم بيغن، استخدامها لنقل أو تهريب أسلحة ، وذلك في حزيران 1948، أي بعد شهر واحد من إعلان استقلال إسرائيل،
وتحديدًا مرحلة الهدنة الأولى في الحرب بين اسرائيل والدول العربيّة، وبعد أسبوعين من الإعلان في مطلع حزيران نفسه عن إقامة الجيش الإسرائيليّ، تمهيدًا لتنظيم العمل العسكريّ في إطار واحد وموحّد، يجمع كافّة المنظّمات اليهوديّة المسلّحة التي كانت تنشط قبل ذلك، ومنع القيام بأيّ نشاط أو تحرّك عسكريّ إلا تحت مظلّة الجيش الاسرائيليّ المُعلن عنه، لكن مناحيم بيغن ومنظمة "إيتسل" حاولوا تهريب أسلحة على متن هذه السفينة ، بينما اعتبر بن غوريون ذلك نوعًا من عصيان أوامره وأوامر الحكومة ومسًّا بوحدة القوّات الإسرائيليّة في جسم عسكريّ واحد تحت قيادة واحدة،
وأمر بقصفها بالمدافع في الثالث والعشرين من الشهر ذاته، حتى غرقت في ميناء يافا، إسرائيل هذه أصبحت جزءًا لا يتجزّأ من الشرق الأوسط حتى في هذا السياق، وهي تتقدّم كمًّا وبخطىً واثقة نحو تعدّد الأسلحة وتنوّع واختلاف قياداتها، وهذا ما كنت قد حذّرت منه كثيرًا وقبل سنوات، انطلاقًا من تزايد الأصوات التي تعتبر أوامر قيادات الجيش توصية فقط وربما غير ملزمة، وتعلن أنها تعتبر رجال الدين المرجعيّة الأعلى، خاصّة إذا كانت هذه الأوامر تتعلّق بإخلاء مستوطنات معيّنة، أو بقضية خدمة المجنّدات في كافّة وحدات الجيش الإسرائيليّ،
ورفض ذلك من جهات دينيّة واستيطانيّة باعتباره مخالفًا لقواعد التوراة اليهوديّة، مرورًا بأصوات اتهمت الجيش الإسرائيليّ بأن قياداته نخبويّة غربيّة أي أشكنازيّة، تمنع اليهود الشرقيّين من التدرّج والتقدّم في سلّم الدرجات والرتب العسكريّة، وتتّبع التوجّهات اليسارية خاصّة بكلّ ما يتعلّق بأوامر إطلاق النار وحقوق الفلسطينيّين وغيرها، وصولًا إلى قيام وحدات حراسة خاصّة في المستوطنات لا تخضع مباشرة لإمرة الجيش، انتهاء بموافقة رئيس الوزراء ،
كجزء من تعهداته لضمان ائتلاف يمينيّ خالص، بتخصيص مئات ملايين الدولارات لإقامة "حرس قوميّ" يخضع لأوامر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي حاول تزامنًا مع ذلك تقليص صلاحيات المفتّش العام للشرطة، ومنح نفسه صلاحيّات عملياتيّة وليس فقط صلاحيّة وزاريّة ، بمعنى تحويل الشرطة إلى شرطة خاصّة لوزير معيَّن. وهو ما تجلّى في حادثة التحقيق مع جنود احتياط في معتقل " سديه تيمان" بشبهة التنكيل بفلسطينيّ غزيّ والاعتداء عليه، حيث يتّضح أن قوات الشرطة لم تحاول منع المحتجين على هذا التحقيق من أنصار اليمين والمستوطنين،
ومعهم عدد من نواب البرلمان من حزب بن غفير، من اقتحام قواعد عسكريّة ومحاولة تخليص الجنود المعتقلين، ومنع التحقيق معهم، ومن ثم اقتحام المحكمة العسكريّة في معسكر " بيت ليد" وتخريب ممتلكاتها وسط اعتداء على جنودها والشرطة العسكريّة، إضافة إلى عدم اعتقال، أو توقيف أيّ من المقتحمين رغم معرفة هويّاتهم ومن يقف وراءهم خاصّة وأنهم وصلوا بسفريات منظَّمة ومدفوعة التكاليف من جهات يمينيّة. في حالة كان مشهدها الأخير قيام مسلحين ملثّمين يقف إلى جانبهم عدد من نواب البرلمان حتى من حزب رئيس الوزراء، باقتحام معسكرات محاولين بقوّة السلاح، إلغاء أو منع تنفيذ أوامر عسكريّة رسميّة، رافضين الاعتراف بسلطة الجيش وقادته وهيئاته العملياتيّة والقضائيّة. وكلّها أمور إذا ما أضيفت إلى قيام وزير الأمن القوميّ إيتمار بن غفير، بتوزيع آلاف قطع الأسلحة على مواطنين، كلهم من اليهود طبعًا ومن أنصاره سياسيًّا وعقائديًّا، دون فحص يضمن أهليّتهم لاستخدامها،
بشرط ضمان ولائهم للوزير شخصيًّا الذي أصرّ على تسليم السلاح لهم بشكل شخصيّ، تنذر، بل تؤكّد نهاية عهد السلاح الواحد والسلطة الأمنيّة الواحدة في إسرائيل، خاصّة مع اتّساع رقعة العداء الداخليّ خاصّة بين اليهود الشرقيّين ومعهم المتديّنين والمستوطنين من جهة واليهود الغربيّين وأنصار المركز واليسار من جهة أخرى، كما أكّدت المواقف المتنافرة حول الانقلاب الدستوريّ وحول السابع من أكتوبر ، والتي وصلت حدّ إبداء بعض أنصار اليمين، ويهود من أصل شرقي الفرح والشماتة بكون معظم قتلى هجوم "حماس" من سكان التجمّعات الزراعيّة الكيبوتسات المنتمية سياسيًّا وعقائديًّا إلى الأحزاب اليساريّة والمركز،
حيث يكثر الحديث اليوم إسرائيليًّا عن احتمال نشوب عصيان داخل وحدات معيّنة من الجيش بفعل مواقف سياسيّة للجنود وقادتهم وبتحريض من السياسيين، وفي مقدمتهم حزب وزير الأمن القوميّ، وأعضاء من الليكود، يعتبرون قيادة الجيش الحاليّة يساريّة ومتخاذلة ويريدونها متساهلة، بل متغاضية تمامًا عن خروقات ضد الفلسطينيّين والمواطنين العرب، وتجاهل تفشّي العنف في المجتمع العربيّ باعتباره في عرف الوزير، ساحة خلفيّة في أحسن الأحوال وطابورًا خامسًا في حقيقة مواقفه، ما قد يصل إلى محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوّة، والقيام بنشاطات غير قانونيّة خاصّة في الضفة الغربيّة،
بعكس أوامر الجيش. وهو ما تزداد وتيرته من قبل المستوطنين وخاصّة المجموعات المسمّاة " شبيبة التلال"، وإيتمار بن غفير أحد المنتمين إليها سابقًا، ومن أكبر مؤيّديها وداعميها اليوم، علمًا أن ذلك يشمل اعتداءات على قادة كبار في الجيش، وليس فقط الجنود العاديين وتعطيل سياراتهم وآليّاتهم العسكريّة، ورفض أوامرهم بصفة الجيش المسؤول الفعليّ عن الضفة الغربيّة وخاصّة بعد تعيين أو تنصيب الوزير سموترتش "وزير الأمن" للمستوطنين اليهود في الضفة الغربيّة.
إزاء ذلك، ورغم اختلاف المواقف حول ما إذا كانت قضية الانقلاب الدستوريّ هي بداية نهاية السلطة الواحدة العسكريّة، خاصّة مع إعلان بعض المتطوعين في سلاح الجوّ، وقف تطوّعهم بسبب الانقلاب القضائيّ، أو ما إذا كان الحرس القوميّ تحت إمرة بن غفير والوحدة رقم 100، والتي تم تشكيلها لحراسة منشأة " سديه تيمان" والتي قاد أفرادها الملثّمون والمسلّحون اقتحامات معسكرات الجيش، بما فيها المنشأة التي أوكلت اليهم مهمّة حراستها، دون اعتقال، أو محاسبة، أو التحقيق مع أيّ منهم، فإن الدلائل كلّها تؤكّد أن مرحلة التفكّك التي تعيشها إسرائيل،
وصلت إلى المعقل الأخير الذي يرمز إلى الوحدة، وهو الجيش وبالتالي فإن القول الدارج بأن انهيار، أو تضعضع الكيانات السياسيّة الديمقراطيّة يبدأ من الداخل، أصبح حقيقة واقعة وأن إسرائيل ،إذا لم يوقف عقلاؤها، وهم في الائتلاف الحاليّ معدومون، الأمور قبل أن تصل الهاوية، تسير نحو واقع فيه أكثر من سلاح، أو وضع يكون لكلّ مجموعة عقائديّة وسياسيّة وأيديولوجيّة سلاحها وجيشها الخاصّ، أو المليشيا المسلّحة الخاصة بها. وهذا ما دفع البعض إلى القول إن حكومة نتنياهو الحاليّة فقدت السيطرة على اليمين المتطرّف، وأنه إذا لم يوقف هؤلاء عند حدّهم فإن الأمر سينتهي بتفكيك إسرائيل، أو إلى اقتتال داخليّ خطير.
وهنا عود على بدء، وإلى قول ابن خلدون أن أّول أسباب سقوط الدول هو التفريط بالعدل. أما الحديث عن انقسام داخليّ وتشتّت للسلطة والصلاحيّات وتدهور للأوضاع وضياع لبوصلة السيادة والوحدة السياسيّة والقضائيّة ووحدة السلاح، يجعل الدولة ، أينما كانت وأيًّا كانت تدخل صراعًا، وتجعل مواطنيها، يدخلون مرحلة الخوف والقنوط واليأس، دون أن يأمنوا غدهم، فيقودني إلى قول ابن خلدون التالي:" الدولة إذا دخلت في سنّ اليأس لا تعود لشبابها أبدًا ولو حاول حكّامها التغيير، فلكلّ زمان دولة ورجال"، فهل يعتبر القادة في لبنان وغزة وإسرائيل وغيرها، أم أن "شبابهم" السياسيّ ومصلحتهم الآنيّة والشخصيّة والحزبيّة الفئويّة هي الأهمّ من حياة الأطفال وسلامة وأمن الناس، وحتى "شباب دولتهم"، وبالتالي لا ضير حتى لو أوصلوا بلدهم سنّ اليأس؟؟ " ولعلها عقوبة الإنسان ألأزليّة أنه لا يفهم قيمة الشيء في حياته إلا حين يخسره".