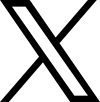هل أصبحت الحرب الضمان للبقاء في كرسيّ الحكم !!!
لم نكن بحاجة إلى أحداث الأعوام الأخيرة على الساحتين العالميّة والإقليميّة، وتحديدًا الحرب التي دخلت عامها الثالث بين روسيا وأوكرانيا، والحرب في قطاع غزة، والتي تقترب من نهاية عامها الأوّل، دون أن تبدو نهايتها في الأفق، كي ندرك أننا، وللأسف، ورغم دخولنا القرن الحادي والعشرين

والذي توسّمنا فيه خيرًا وتمنيّنا أو منينا أنفسنا، أن يكون قرنًا يسود فيه السلام والأمن والهدوء. وتنتهي فيه الحروب، أو تتضاءل مدّتها، وأن تصبح بمثابة الخارج عن المألوف، أو الشاذّ عن القاعدة وليس القاعدة، بمعنى أن لا تنشب، إلا لأسباب خارقة ولدوافع لا يمكن تفاديها، ولا مجال لحلّها سياسيًّا، أو دبلوماسيًّا، وبالتالي يضطر الزعماء إلى إعلان الحرب لفترة ما، وهذا في أسوأ الأحوال، حتى تتهيّأ الظروف لحلّها ، لنجد أنفسنا في الشرق الوسط نعيش حربين، الأولى بين إسرائيل والفلسطينيّين والعرب، والثانية بين الإسلام الشيعي والإسلام السنيّ،
وأننا في عصر جديد، مختلف تمامًا، بل مناقض تمامًا، تطول فيه الحروب أحيانًا دون سبب، وتتواصل المعارك، وتكاد في بعض المواقع ومنها كأوكرانيا اليوم ، تكرّر ما كان في القرن العشرين الذي تيقنّا فيه جميعًا، أن عهد الحروب الطويلة والمتواصلة قد انتهى مقارنة بالقرنين الماضيين، التاسع عشر والثامن عشر، واللذان تميزا بحروب قصيرة استمرت عدّة شهور لا تزيد عن أربعة، وذلك من منطلق إدراك القيادات حينها، وخلافًا لليوم،
أن الحروب هي أسوأ طريقة لتسوية الخلافات السياسيّة، خاصّة عندما تتّضح تكاليف القتال الباهظة، ليبحث المتحاربون عادة عن تسوية، بعد أن تتّضح أثمان الحرب المباشرة وغير المباشرة، ليتّضح أننا اليوم وللقرن الثاني على التوالي نعيش حروبًا طويلة، أو بالحرى تتم إطالتها تعدّدت أسبابها، وتجاوزت المتعارف عليه من أنها شرّ لا بد منه، وبالتالي نرى ونواكب اليوم حروبًا تنشب لواحد من أسباب أربعة، فإما للمصلحة الذاتيّة للقادة، بمعنى رغبة بعضهم في إعلاء شأنهم، أو تمجيد أنفسهم، أو ضمان بقائهم في السلطة وموقع القيادة، وهذا ما يلمّح إليه البعض اليوم في حالة الحرب في غزة، خاصّة بما يتعلّق بموقف حركة "حماس"،
ورفضها لأيّ وقف لإطلاق النار مرحليًّا، ومنح مواطنيها الهدوء والراحة والطمأنينة ولو قليلًا، وفي حالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وما يرشح عن عرقلته لأيّ صفقة لتبادل الرهائن ووقف إطلاق النار وذلك من منطلقات شخصيّة وخاصّة تتعلّق باستمرار ائتلافه، ومنع سقوطه عبر وضع شروط جديدة وإضافية يعتبرها هو توضيحات بينما يعتبرها البعض عراقيل مقصودة، ومنها الإصرار على التمسّك بمحور فيلادلفيا، أو محور صلاح الدين بتسميته العربيّة، والفاصل بين قطاع غزة ومصر، معتبرًا عدم التواجد فيه خطرًا وجوديًّا، ليس أقلّ من ذلك، على إسرائيل، دون أن يكون ذلك واحدًا من أهداف الحرب المعلنة باعتبار التواجد العسكريّ الإسرائيليّ فيه، يشكّل خرقًا لاتفاقيّات السلام في كامب ديفيد، والتي تمنع ذلك التواجد لمسافة عدّة كيلومترات، مع تزامن هذا الأمر مع تسريبات على لسان وزيرة في حكومته هي أوريت ستروك من حزب الصهيونيّة الدينيّة الاستيطانيّ المتزمّت، والذي تقول فيه إن حزبها يمارس ضغوطًا على رئيس الوزراء،
وأنه أبلغه أن أي انسحاب للجيش الإسرائيليّ من قطاع غزة عامّة، أو من محور نتسريم في أواسط القطاع، أو حتى من محور صلاح الدين في جنوبه، معناه انسحاب الحزب من الحكومة والائتلاف وبالتالي انهياره ، وإما للحوافز غير الملموسة وتعظيم الإيديولوجيّا، وهو سبب رفض أقطاب اليمين الاستيطانيّ والدينيّ في الحكومة الحاليّة وقف الحرب طمعًا بالعودة إلى قطاع غزة، أو كما قالت النائبة عن حزب الليكود، عيديت سيلمان "استعادة ما هو ملك لشعب إسرائيل"، وبغية تعظيم الأيديولوجيا اليمينيّة التي تطالب بأرض إسرائيل الكبرى التاريخيّة وحتى التوراتيّة، أو من الجانب الغزي تعظيم الأيديولوجيا التي يتبناها "حماس" وهي أيديولوجيا جهاديّة تعتبر أرض فلسطين كلّها وقفًا إسلاميًّا لا مكان فيه لغير المسلمين عامّة ولليهود خاصّة، وإما رغبة أحد الأطراف في الاستيلاء، أو الحصول على بعض، أو كل المزايا الماديّة، أو المعنويّة التي يملكها الطرف الآخر بمعنى الحوافز الاقتصاديّة،
وهي ربما كانت أحد أسباب الحرب في اليمن التي اعتبرها البعض تهدف إلى تعزيز نفوذ بعض الدول الخليجيّة الاقتصاديّ هناك، وإما لحالة التخوّف والترقّب من اختلال توازن القوى مع هذا الخصم بمعنى نشوب حرب استباقيّة، أو وقائيّة لمنع التعاظم العسكريّ لطرف ما، أو وكما حدث في السابع من أكتوبر 2023، التقديرات الخاطئة للقوى المتبادلة، فإسرائيل اعتقدت أن "حماس" خائفة ومرتدعة، ولن تجرؤ على أيّ عمليّة عسكريّة، بينما لم تقدر "حماس" الرّد الإسرائيليّ المحتمل والمتوقّع حقّ قدره، ما يعني أننا في عصر تستمر فيه الحروب، والمسماة اليوم بالحروب المعاصرة، فترات طويلة، دون التوصّل، أو السعي إلى التسوية، لأسباب منها تيقن القادة، أو مجرد اعتقادهم أن الهزيمة، أو حتى انتهاء الحرب يهدّد بقاءهم، وعندما لا يكون لدى القادة التقدير الحقيقيّ، أو الواقعيّ لقوّتهم وقوة خصومهم والتصور الصحيح لنتائج وعواقب الحرب التي تدمّر في عصرنا الحاليّ المجتمعات والأسر، وتمسّ النمو الاجتماعيّ والاقتصاديّ للأمم، بل تؤدّي إلى شلله، ناهيك عن الأضرار الجسديّة والنفسيّة طويلة المدى، وعندما يخشى القادة من أن خصمهم العسكريّ الخارجيّ، أو حتى السياسيّ الداخليّ سيزداد قوّة في المستقبل.
صحيح أن التاريخ لا يتكرّر، لكن عبره ووقائعه تتشابه، وبالتالي يصحّ قول الباحث والروائيّ الإيطاليّ إدواردو غالياني، من أن التاريخ بوقائعه ومجرياته بصورتها العامّة، لا يقول وداعًا ولا يختفي أبدًا، بل إن له دورة خاصّة تجعل أحداثًا آنيّة تبدو مشابهة لما كان في السابق، أو شبيهة به، وكأن التاريخ يقول سأراكم لاحقًا، خاصّة وأن بعض الحروب ومنها ما يحدث اليوم في أوكرانيا وغزة على حدّ سواء، وكذلك الحدود الشمالية من حرب طويلة ومتواصلة بدأت هنا منذ عقود وفي أوكرانيا كذلك(احتلال شبه جزيرة القرم عام 2014)، وهو ما يحاول الباحث والمؤرخ كريستوفر بلاتمان مؤلّف كتاب "لماذا نحارب..
جذور الحرب وطرق السلام" أن يشرحه قائلًا إن العامل الأيديولوجيّ يفسّر أسباب العديد من الحروب الطويلة، وهي حروب يخلق حالة مزمنة من انعدام الثقة تتحوّل إلى عداء ورفض وإقصاء، مؤكّدًا أن كل حرب طويلة تصنع ما يصفه هو بأنه "مشكلة التزام"، نتيجتها عدم قدرة أحد الجانبين، أو كليهما على الالتزام باتفاقيّة سلام، أو حتى السعي إليه تخوّفًا من أن يؤدّي ذلك إلى تغييرات في مجال القوى أو ميزانها، وربما هذا ما يفسّر مثلًا الرفض الذي قوبلت به اتفاقيّات أوسلو من طرف جهات إسرائيليّة وفلسطينيّة على حدّ سواء، اعتقدت أن هذه الاتفاقيّات، قد تؤدّي إلى تغيير في ميزان القوى لصالح الطرف الآخر، وتمكينه من تخصيص مقدرات أوسع وأكثر لتحقيق أهدافه، ومنها كما اعتقد اليمين في إسرائيل، إنهاء الاستيطان وإنهاء الاحتلال والخروج،
أو الانسحاب من الضفة الغربيّة، وبالمقابل اعتقاد جهات فلسطينيّة أن اتفاقيّات السلام هذه ستؤدّي إلى تغيير في ميزان القوى ليس لصالحها خاصّة وأنها تعني انتهاء عهد النضال المسلّح، والتوجّه إلى المسار الدبلوماسيّ برعاية أميركا وعلاقاتها معروفة مع إسرائيل، وهو ربما السبب وراء معارضة إسرائيل التامّة لأيّ اتفاق نوويّ بين إيران والأمم المتحدة والدول الكبرى، وربما بل يقينًا الدافع أمام عمليّات اغتيال وتشويش سيبرانيّ للعمل في المنشآت النوويّة الإيرانيّة نسبتها مصادر إعلاميّة أجنبيّة إلى إسرائيل، باعتباره سيؤدّي إلى تغيير في ميزان القوى بينها وبين ايران التي اعتبرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومنذ اكثر من عقد من الزمن، وكما ورد على الأقل في خطاباته وتصريحاته العلنيّة والإعلاميّة،
وإن كان ذلك بدون أفعال، خطرًا وجوديًّا على إسرائيل كما كرّر ذلك أمام عائلات المختطفين والرهائن في قطاع غزة مؤخّرًا ، وهو ما سنعود إليه لاحقًا، خاصّة وأنه يكرّر استخدام نفس المصطلح في كثير من الأحيان، كما في موضوع محور فيلادلفيا( صلاح الدين)، وبالتالي يحاول اتّخاذ خطوات تشكّل في نظره، كما يحدث اليوم في الضفة الغربية من حملات عسكريّة إسرائيليّة يوميّة، أو كما يحدث عبر قصف شاحنات يقال إنها تحمل أسلحة إلى مليشيّات تابعة لإيران في سوريا والعراق ولبنان، أو كما حدث قبل أسبوعين مع حزب الله، ضربة استباقيّة، أو حربًا وقائيّة،
وهو ما حصل في أوكرانيا حيث شنّت روسيا الحرب على أوكرانيا استباقًا لانضمامها إلى حلف شمال الأطلسيّ، ومنعًا لذلك، باعتباره خطوة ستغير ميزان القوى لصالح أوكرانيا وتمنحها دعم دول الأطلسيّ والاتّحاد الأوروبيّ والولايات المتحدة، وهي تصرّف يسميه كثيرون مصيدة ثوسيديديس، المؤرّخ من أثينا أو الحرب الوقائيّة، وتعبّر عن حالة يشنّ أحد الجانبين هجومًا، لتغيير ميزان القوة الحاليّ، أو استغلال ظرف ما قبل أن يتغير ، وبالتالي يجب أن نسأل أنفسنا هنا، عن سبب تكرار مثل هذه الحالات التي ينحو فيها السياسيّون إلى إعلان الحرب أو المبادرة إليها، أو إطالة أمدها رغم معرفتهم المسبقة بنتائجها وأبعادها السيّئة والسلبيّة والخطيرة، وهو ما تطرّق إليه غريغوري داديس الخبير في التاريخ العسكريّ الأميركيّ، والمحاضر في جامعة سان دييغو، وعلى ضوء خدمته لسنوات طويلة في صفوف الجيش الأميركيّ، قائلًا إن السؤال الجوهريّ هو لماذا يثق صانعو السياسة،
وليس فقط في روسيا، بجدوى الحرب رغم أن الحسابات الخاطئة الصغيرة بشأنها يمكن أن تؤدّي بسهولة إلى كارثة، وهو قول ينطبق على كافّة حروب العصر الحديث كالحربين العالميّتين الأولى والثانية، وحرب فيتنام وكذلك الحروب في منطقة الشرق الأوسط بما فيها حربي الخليج الأولى والثانية، واللتين يمكن اعتبارهما ضمن الحروب الاستباقيّة، والتي اتّضح لاحقًا أنها كانت غير مبرّرة فالعراق لم يكن يمتلك أسلحة كيماويّة، أو بيولوجيّة، ناهيك عن أنه يمكن القول أنهما لم تنتهيا نهائيًّا، ولم يتّضح نصر أي طرف من طرفيهما، فالعراق ما زال يشهد عدم الاستقرار والصراعات المسلّحة وتنظيم "داعش" سليل تنظيم "القاعدة" وطالبان في أفغانستان ما زال حيًا يرزق رغم الضحايا وعددها بالملايين من كافّة الأطراف.
الصراعات العديدة التي يشهدها العصر الحاليّ، ومنها الصراع الإسرائيليّ الفلسطينيّ، والنزاع أو الحرب الباردة بين إسرائيل وإيران حول السلاح النوويّ من جهة علاقتها بتنظيمات مسلّحة في دول متاخمة لإسرائيل ضمن مساعي إيران الثورة الخمينيّة، تعزيز سيطرتها الإقليميّة في المنطقة، وإقامة نقاط تواجد وارتكاز لها، سواء في العراق، أو لبنان، أو سوريا، أو اليمن، أو غزة كما اتّضح في الحرب الحاليّة في القطاع، تؤكّد لكل من يشكّك في ذلك أن النصر لا يتحقّق بسرعة وبتكلفة زهيدة كما هو متوقّع، بل أنه يكلّف غاليًا هذا إن تحقّق أصلًا. ومن هنا لا بد من طرح السؤال حول الدوافع التي تؤدّي بالسياسيّين كأشخاص،
أو بدولهم إلى تعزيز "نزعة الصراعات" وربما نقلها، أو المخاطرة إلى حالة المواجهة العسكريّة سواء كانت مباشرة، أو غير مباشرة وعبر وكلاء ووسطاء ومبعوثين ،بدلًا من البحث عن حلّ دبلوماسيّ، أو سياسيّ هو دائمًا موجود أو مطروح، وهو ما يحدث بالضبط في حالة إيران وإسرائيل، حيث يواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومن على كلّ منصّة بما فيها منصّة الكونغرس الأميركيّ التصريح بأن إيران النوويّة هي الخطر الوجوديّ الأوّل على دولة إسرائيل، والتأكيد على دورها ليس فقط في الشأن النوويّ، بل أيضًا في دعم حركات وتنظيمات تصنفها إسرائيل ودول أخرى في العالم، ومنها الولايات المتحدة ضمن قوائم المنظمات الإرهابيّة، كالحرس الثوريّ والحوثيّين و"حزب الله" و"حماس"، مشيرًا كلاميًّا على الأقلّ إلى ضرورة التصدي لكافّة هذه الأبعاد والجهات،
قائلًا في العام 2021 ، خلال عهد حكومة التغيير برئاسة نفتالي بينيت وبعده يائير لبيد، إن الإرهاب يرفع رأسه عندما يشتم رائحة الضعف، لكنّه ينحسر أمام القوة والعزم والحزم، وهو ما فنّدته مواقف إيران واستمرار مساعيها النوويّة وتسليحها لمنظّمات مسلّحة مجاورة لإسرائيل، وإطلاق مئات المسيَّرات وأعداد من الصواريخ بعيدة المدى من إيران باتجاه إسرائيل في أبريل الأخير، رغم ما يعتبره نتنياهو ومعاونوه وجوقة مؤيّديه صمودًا أمام إيران، رغم أن الحقائق على الأرض مغايرة ومناقضة، ممّا يستوجب السؤال،
ماذا فعل رئيس الوزراء نتنياهو طيلة نحو 20 عامًا من حكمه لكبح جماح إيران ووقفها عن التسلّح، اللهم باستثناء التصريحات الرنانة والخطابات في الكونغرس واستعراض الملصقات والمعروضات على الملأ، وباختصار هل تشكّل إيران فعلًا خطرًا على العالم وحريّة أفرادها، ونظامه الديمقراطيّ؟ وإذا كانت كذلك فإنه لا بدّ من الإشارة إلى أن الولايات المتحدة، ووفق مراجعة التاريخ قدّمت أكبر خدمة للنظام الخمينيّ الجديد في إيران بعد ثورة الخميني الذي كان لاجئًا في فرنسا، وعاد إلى طهران بموافقة أميركيّة، وبالتالي السؤال حول تغيّر السياسات وتغيّر التحالفات، والأمثلة على ذلك عديدة فالولايات المتحدة كانت في سنوات الثورة الإسلاميّة الأولى حليفة طهران، ليتغيّر الحال عام 1988 وقضية الرهائن في السفارة الأميركيّة في طهران، كما كانت الداعم الأول للحركات الإسلاميّة في أفغانستان، والتي قاومت التواجد السوفييتيّ هناك، وأسامة بن لادن السعوديّ الأصل كان أحد قادتها الجهاديّين ، قبل أن يتغيّر الحال لتصبح حركة "طالبان" العدو الأكبر للولايات المتحدة خاصّة بعد الحادي عشر من سبتمبر أيلول.
والأمر كذلك بالنسبة للسعوديّة التي كانت المموّل الأكبر للحركات الجهاديّة التي حاربت الاتّحاد السوفييتيّ، قبل انسحابه من أفغانستان، ناهيك عن دعم أميركا ودول عربيّة للمتمرّدين في سوريا ضد نظام بشار الأسد، لينتهي الحال ببقائه في السلطة، وعودته الى حضن العالم العربيّ وتحالفه مع روسيا والصين، ما يعني باختصار أن التحالفات، وهي متغيّرة أصبحت وسيلة لتحقيق الغايات وأحيانًا تنفيذ الأجندات وربما تكريس النزاعات ، وهو ما يتّضح لنا اليوم من خلال التحالفات العالميّة المتعلّقة بالحربين في غزة وأوكرانيا، الأول يضمّ أميركا والدول الأوروبيّة، والثاني يضمّ روسيا والصين ، وكذلك التحالفات المتعلّقة بالنوويّ الإيرانيّ، حيث نجد الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، مقابل إيران والصين وروسيا من جهة أخرى، وهي تحالفات تنبّئ باستمرار الأزمات وإطالتها خاصّة وأنها تُخفي خلفها مصالح خاصّة ومتناقضة لأطرافها، ومصالح شخصيّة لقاداتها وهو الأمر الخطير، في حالات الدول والعلاقات الدوليّة والإقليميّة، فكم بالحريّ في حالات داخليّة، يتم فيها تشكيل تحالفات وائتلافات حكوميّة يتّضح أنها جاءت لخدمة أجندات منفردة وحزبيّة وشخصيّة أكثر من خدمتها لأجندات عامّة ومصالح الدولة، ما يعني عمليًّا إطالة عمر الخلافات الداخليّة الفئويّة ، دينيّة كانت أم عرقيّة، أم سياسيّة وطائفيّة.
هذه الحقيقة وهي مؤلمة، تنطبق اليوم على علاقة الحكومة الحاليّة والائتلاف الحاليّ، بالمواطنين العرب في إسرائيل والذين أبدوا منذ السابع من أكتوبر عام 2023 خاصّة، مواقف يشار اليها بالبنان تشكّل مزيجًا من المسؤوليّة المدنيّة والممارسة الديمقراطيّة في دولة تعيش حالة حرب، وبشكل يختلف عمّا كان الحال عليه في أيار 2021، خلال حملة "حامي الأسوار" في قطاع غزة والمواجهات العنيفة التي شهدتها خاصّة المدن المختلطة ،
علمًا أن مواقفهم المدروسة والعقلانيّة التي أبدوها منذ السابع من أكتوبر أفشلت توقّعات سوداويّة حاول بعض أعضاء الائتلاف الحاليّ الدفع باتّجاهها، وفي مقدّمتهم وزير الأمن القوميّ إيتمار بن غفير الذي سارع بعد يومين فقط من السابع من أكتوبر إلى إعلان امتلاكه لمعلومات تنذر بتكرار المواجهات والصدامات التي شهدتها البلاد في أيار 2021، لتتبدّد مزاعمه وسط إبداء المواطنين العرب تمسّكًا بالحقوق الديمقراطيّة والمدنيّة وحريّة التعبير عن الرأي،
وتقديم الدعم الماليّ للمواطنين في غزة، مع ضمان الهدوء التام داخل بلداتهم وخارجها وفي المدن المختلطة، مع الإشارة إلى أن بعض ضحايا السابع من أكتوبر كانوا من المواطنين العرب وكذلك بعض المختطفين، ومواصلة النهج، والذي كنت أشرت إلى ضرورة تعزيزه باعتباره الردّ الشافي على كلّ محاولات الإقصاء والتخوين، وهو نهج الاندماج في كافّة مرافق الحياة الاقتصاديّة والأكاديميّة والجهاز الصحيّ، وغيره من المؤسّسات والمرافق الاقتصاديّة العامّة والخاصّة، وتأكيد كونهم جزءًا لا يتجزّأ من البلاد وبقائهم هنا، بخلاف الأصوات التي تتعالى من الوسط اليهوديّ، والتي تتحدّث عن مغادرة إسرائيل، أو الهجرة بحثًا عن الهدوء والاستقرار والحياة الهادئة،
علمًا أن امتناع المواطنين العرب عن الاندماج، أو توقفهم عن ذلك، يعني مسًّا كبيرًا وغير محتمل بالجهاز الطبيّ والاقتصاديّ والتعليميّ ومجالات الصناعة المختلفة، تحديدًا على ضوء هجرة الأدمغة اليهوديّة، ومغادرة أطباء يهود البلاد، وكذلك في مجال الهايتك والتقنيات العالية والمتقدّمة، رغم كونهم مواطنين تنتهج الحكومات الأخيرة بحقّهم سياسات إقصاء عبر تشريعات تحدّ من حقوقهم وحريّاتهم، ورغم ادّعاءاتهم الصادقة والمحقّة، وتأكيدهم مواطنتهم، وكونهم أقليّة تعيش بسلام وتناغم وعيش مشترك داخل دولة إسرائيل، رغم سوء أوضاعهم وتفشّي مظاهر العنف والإجرام، والاتهامات الموجّهة للشرطة بالتقاعس والتقصير خاصّة منذ تولّي إيتمار بن غفير وزارة الأمن القوميّ،
مع ضرورة الإشارة هنا إلى أن المجتمع العربيّ في إسرائيل لا يفهم، أو لم يذوّت حتى اليوم خطورة مظاهر العنف والإجرام التي يعانيها، وأنه لم يتّخذ داخليًّا، ما يكفي من الخطوات لمكافحتها عبر تعزيز التوجهات الأكاديميّة والتشغيليّة، مع التأكيد على أن اليمين في إسرائيل، واذا ما استمرّ في سدّة الحكم، قد يستخدم مظاهر العنف والإجرام هذه ذريعة لتقييد حريّات المواطنين العرب عبر تشريعات تمنح أجهزة إنفاذ القانون صلاحيّات غير محدودة، أو غير محسوبة من حيث أوامر التفتيش والاعتقال والتحقيق وتقييد حريّات الرأي والإبداع الفنيّ والأدبيّ وغيره، وبالتالي تغيير الوضع الحاليّ الذي يندمج فيه العرب في الدولة، ويعملون في وسائل الإعلام والأكاديميا ويخدم عدد لا بأس به منهم في الجيش وقوّات الأمن المختلفة سواء كان ذلك وفق قانون التجنيد الإلزاميّ، أو تطوّعًا.
ختامًا، نعيش اليوم في حالة يتعمّد بعض القادة إطالة الحروب الإقليميّة التي ورغم تسميتها هذه ، لم تعد كذلك من حيث التأثيرات والتبعات، فالحرب في أوكرانيا ألقت بظلالها، وما زالت على العالم وأسعار النفط وتوفير الأغذية والطاقة، وخلقت تحالفات تدمج بين المصالح الضيّقة للدول المشاركة فيها الاقتصاديّة والسياسيّة والعسكريّة، وربما المصالح الضيّقة للقيادات، دون أيّ اعتبار لمصالح الشعوب، وكذلك الحرب في غزة والتي من الواضح أنه من مصلحة إسرائيل كدولة ومصلحة شعبها كلّه أن تنتهي سريعًا، ربما بخلاف القيادات، والحرب في الحدود الشماليّة مع "حزب الله" والحرب على نار هادئة مع إيران والحوثيين،
ورغم ذلك يفضل بعض القادة استثمار أموال طائلة في شراء العتاد والسلاح، وبعضهم في منطقتنا رغم أنهم يدركون أن القوة العسكريّة الإسرائيليّة ستتفوّق عليهم في كلّ نزال ومواجهة، ورغم ذلك يتم تكديس الأسلحة وحفر الأنفاق في غزة وجنوب لبنان وبين مطار دمشق الدوليّ ومخازن أسلحة للمليشيّات المدعومة إيرانيًّا هناك وغيرها، وخوض حروب لا تترك إلا الخراب والدمار والضحايا واللاجئين والفقراء، بدلًا من البحث عن الوسائل الدبلوماسيّة لحلّ النزاعات،
دون أن يدركوا أن لا منتصر في الحرب، وأنه حان الوقت لقيادات لا تستخدم الحرب وسيلة أولى لحلّ النزاعات ولا تعمد إلى إطالة عمرها بشكل اصطناعيّ لأهدافها الخاصّة، ولكن يبدو للأسف أنها هذه سمات زعماء اليوم، وهم ليسوا بقادة ، فهم يدركون الحقائق متأخّرة وربما بعد فوات الأوان وخسارة شعوبهم لرخائها وسلامتها وصحّتها واقتصادها، وربما حياة آلاف، أو عشرات الآلاف منهم، قبل استخلاص العبر، وذلك تصديقًا لقول بنجامين فرانكلين حول كون مأساة الحياة هي أننا نشيخ بسرعة فائقة، لكننا نصبح أذكياء بوتيرة بطيئة وبعد فوات الأوان، دون أن يتحمّل القادة مسؤوليّة، ووزر أعمالهم عملًا بقوله أيضًا: "كم عدد الذين لديهم الشجاعة الكافية لتحمّل أخطائهم، أو القرار الكافي لإصلاحها".