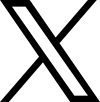ليس هناك خطأ أكبر من عدم الاعتراف بالخطأ!
دون أن يحدث أيّ تغيير عن العام الماضي، ستبقى التساؤلات نفسها، وستواصل المجريات الآنيّة المتعلّقة بالحرب في غزة، الهيمنة على الاهتمام السياسيّ والإعلاميّ في إسرائيل، وتحتل الصدارة خاصّة بجوانبها التي تتعلّق بالمفاوضات حول صفقة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليّين، والتي تتراوح التصريحات حولها ووفق هويّة مطلقيها

وربما للتمويه عن الحقيقة، وخدمةً لأهداف وأجندات أقلّ ما يقال فيها إنها ليست للمصلحة العامّة، بين الشعور بأنها قريبة لا مناص منها، وبين كونها صعبة المنال، بل ربما مستحيلة وسط تبادل للتهم وتنصّل من المسؤولية من الطرفين أصحاب الشأن أي "حماس" والحكومة الإسرائيليّة اليمينيّة التي تؤكّد استمرار الحرب، دون تحديد جدول زمنيّ لسيرها وانتهائها،
أو حتى رسم أهدافها مكتفية بالحديث عن نصر مطلق، وإبادة لقدرات "حماس" العسكريّة والمدنيّة والسلطويّة باعتبارها حركة دينيّة متزمّتة لا تقبل بالحلول الوسط، بل تسعى وفق ميثاقها إلى إبادة إسرائيل، دون الحديث عن بديل لها، ومع تكرار دخول الجيش الإسرائيليّ لمناطق في القطاع عامّة وشماله خاصّة كان قد دخلها مرّات عديدة خلال الحرب المتواصلة منذ قرابة 15 شهرًا،
وعلى الساحة الفلسطينيّة وسط استمرار العمليّات العسكريّة الإسرائيليّة في قطاع غزة من جهة وسط أنباء تتحدّث من جهة عن ازدياد المعاناة الإنسانيّة خاصّة بعد إغلاق المستشفيات، ومن جهة أخرى عن استعادة "حماس" لقوّتها خاصّة سيطرتها المدنيّة،
وتلك المتعلّقة بالوضع في سوريا واختلاف المواقف في إسرائيل حول مرحلة "ما بعد بشار" فيها، حول ما إذا كانت ستكون "سوريا أحمد الشرع" باسمه الدبلوماسيّ الجديد، أو "أبو محمد الجولاني" باسمه الدينيّ الجهاديّ القديم، ستكون ليبراليّة وديمقراطيّة(قدر الإمكان فالديمقراطيّة والشرق الأوسط ضدّان لا يجتمعان حسنًا كما يبدو)،تستحق الزحف السياسيّ والدبلوماسيّ إليها إن لم يكن الحجيج الدبلوماسيّ الغربيّ والأميركيّ والعربيّ والتركيّ،
والدعوة إلى اعتبار هيئة تحرير الشام حركة سياسيّة ورفع العقوبات عنها، أو أنها ستكون سوريا تحكمها حركة إسلاميّة متطرّفة يحاول قادتها " الضحك على العالم" وإيهامه، أو تضليله، ما دفع المسؤولين فيها إلى مواصلة إطلاق التهديدات لسوريا واستمرار المداهمات العسكريّة، التي وصلت دخول مدن في منطقة القنيطرة وعلى بعد أقل من 30 كيلومتر من دمشق العاصمة، ومواصلة قصف مقرّات الجيش السوريّ وتدمير كل قوّته وأسلحته ومستودعاته، ومهاجمة الإدارة السوريّة الجديدة، وذلك رغم الدعم والترحيب العالميّ الذي تلقته الأخيرة بشأن تصريحاتها وسياساتها وإدارتها لمرحلة ما بعد نظام بشار الأسد، والقبول الواسع داخليًّا وخارجيًّا،
وتصريحات وزير الخارجيّة الإسرائيليّ جدعون ساعر أن الإدارة الجديدة هي عصابة إرهابيّة كانت في إدلب وسيطرت على العاصمة دمشق، وأنه حتى لو أراد العالم أن يراها كحكومة جديدة ومستقرّة ، فإنه يفعل ذلك ،لأن الدول تريد إعادة اللاجئين الموجودين على أراضيها إلى سوريا، أي لمصالحها الخاصّة، وبشكل انتهازيّ وغير حقيقيّ، فإنه نظام إسلاميّ.
أقول إن هذا الوضع قد يثير التساؤلات، بل أكثر من ذلك، فهو عمليًّا يخفي خلفها أمورًا عديدة أخرى لا تقلّ أهميّة، تتعلّق بأسئلة مصيريّة أولها ما إذا كانت القيادات في إسرائيل وقطاع غزة، تملك من الشجاعة المقدار الكافي للاعتراف بالخطأ في المواقف السياسيّة والاستراتيجيّة والجرأة على تغييريها واتّخاذ مواقف جديدة، دون تحويل مواقفها السياسيّة إلى "دين سياسيّ" لا جدال فيه ولا تغيير،
بل إن مجرّد مطالبة القيادات بذلك هو نوع من التمادي، بل ربما الكفر والتكفير، وذلك عبر المزج بين عمل سياسيّ يسانده عمل إعلامي يفتقر إلى مصطلحات مراجعة الذات ومحاسبة النفس والاعتراف بالخطأ، بل مواصلته وتجنيد الإعلام لتبريره وتزيينه، وتوجيه التهمة واللوم إلى الخصم عبر الترهيب،
والتخويف، في أفضل تأكيد على أن السياسيّين والقادة يمتهنون ويتقنون، بل يتشاركون في صفة واحدة هي عدم الرغبة، أو القدرة على مراجعة الحسابات، وانتقاد الذات وتصحيح المسار والاعتراف والإقرار بالخطأ والفشل، ثقافة سلبيّة يكتسبها البشر نتيجة الخوف من الصورة التي قد يحملها الآخرون عنهم إذا ما اعترفوا بالخطأ، وذلك لثلاثة أسباب، أو تفسيرات يقول عنها بول سبيكتور، محاضر علم النفس من فلوريدا، أنها تعبير عن الضعف والضغط الناجم عن عدم اليقين والافتقار إلى الأمان النفسيّ، وهي كما يبدو،
صفات لا يملكها السياسيّون هنا وفي الطرفين، وبالتالي يتمسّكون بمواقف وتوجّهات اتّضح فشلها، ويرفضون قبول أيّ توجّهات مختلفة وحتى مجرد فحصها، وصولًا الى قمم الانتهازيّة، واستغلال كافّة الوسائل للاستفادة الأنانيّة والشخصيّة والحزبيّة من الظروف. ووضع المصلحة الشخصيّة، قبل مصالح الشعوب التي يحكمونها، أو التكيّف بمرونة مع الظروف المتغيّرة لتبجيل المصلحة الشخصيّة وتكريسها،
والاستفادة من أخطاء الآخرين، والتصرّف وفق الاهواء الشائعة وتبني المواقف وفق شيوعها وانتشارها وكونها مقبولة على العامّة والقاعدة الانتخابيّة، دون اهتمام ما إذا كانت صحيحة أو لا، أي ليس رغبة في قول الموقف الحقّ واتخاذه، بل يهدف إلى الانتماء للرأي المنتصر، وهذا ما يحدث إسرائيليًّا في قضيتي غزة وسوريا، ويحول دون طرح الأسئلة حول ما إذا كانت الاستراتيجيّات السياسيّة،
وخاصّة ما ساد منذ أكثر من عقد من قبل بنيامين نتنياهو من دعم ماليّ لحركة "حماس" يقدر بمليارات الدولارات، واعتباره كفيلًا بإسكاتها، ومنعها من شنّ حرب على إسرائيل، واستراتيجيّات عسكريّة تعتقد ان جولات مواجهة عسكرية قصيرة وسريعة مقابل الفلسطينيين، ستجعلهم يسكتون عملًا بسياسة "الجدار الحديديّ" التي وضع أسسها دافيد بن غوريون وزئيف جبوتنسكي انطلاقًا من إيمانهما بأن جولات الحرب التي تتحطّم فيها الجيوش العربيّة على هذا "الجدار الحديديّ" ستجعل دول المنطقة، وفي سياقنا هذا حركة "حماس" في نهاية المطاف،
تخشى إسرائيل وتقبل وجودها، وتغيّر استراتيجيّتها، وتختار طريق السلام، كما فعل السادات والملك حسين لاحقًا، بمعنى ترسيخ الفهم القائل إنه لا يمكن لإسرائيل فرض إنهاء النزاع بالقوة، بل يجب عليها أن تقبل بواقع لا سلام فيه، ولا حرب دائمة بل جولات عسكريّة وحملات قصيرة ،وهي الرؤية الأمنيّة الإسرائيليّة التي ظلّت حتى السابع من تشرين الأول 2023، وكان شقّها الثاني إضعافًا للسلطة الوطنية الفلسطينيّة، وتقويض إمكانيّات هي ضئيلة أصلًا لحلّ الدولتين، وذلك تنفيذًا لأجندات سياسيّة دينيّة يمينيّة تعتبر أرض إسرائيل كلها ملكٌ لليهود، ترفض الاعتراف بوجود شعب آخر في الضفة الغربيّة، أو المواطنين العرب داخل إسرائيل،
وبالتالي تنتهج طريقًا وتوجّهات تعتقد أن تطبيق هذا الحقّ الشرعيّ والدينيّ يجب أن يتم دون هوادة، ودون اكتراث للثمن الماديّ والاقتصاديّ، أو لحياة البشر، وليس ذلك فقط، بل وتزامنًا مع تحوّل إسرائيل إلى دولة تتجه شعبيًّا، أو ربما شعبويًّا إلى التدين والدين ، ما يعني رهن القرار السياسيّ في القضايا الخارجيّة، وبشكل خاصّ مسألة العلاقات مع الفلسطينيّين واستئناف المفاوضات، وكذلك القرارات الداخليّة بما فيها العلاقة بين النظام السياسيّ والمجتمع الإسرائيليّ،
لاعتبارات دينيّة وطائفيّة تؤكّد خطورة الانقسام بين المتديّنين والعلمانيّين. وهو انقسام تغلغل في جهاز الدولة، وحتى في جهاز القضاء، وأوجد مأزقًا في الخيار بين دولة يهوديّة، أو حتى دولة لليهود فقط ودولة ديمقراطيّة بمعنى أنه أخضع كافّة القضايا في الدولة لاعتبارات دينيّة يمينيّة، تصبّ كلّها في مصلحة الأجندة السياسيّة الائتلافيّة الحاليّة التي ترفض أيّ قبول لتوجهات أخرى، بل تسعى للسيطرة على مقدّرات البلاد السياسيّة والقضائيّة عبر سيطرة على الجهاز القضائيّ تمنع المساءلة ومراجعة القرارات، وسن قوانين تتيح الفساد،
مثل القوانين التي تضرب استقلاليّة القضاء، والقانون الذي يضعف المراقبة على التعيينات الحكوميّة بحيث يمكن تعيين موظّفين غير مؤهّلين في مواقع إداريّة رفيعة، وزيادة التوتّرات الداخليّة الحزبيّة والطائفيّة بين "أسباط" المجتمع الإسرائيليّ حتى حالة تنذر باحتمال نشوب حرب أهليّة، تشكّل الخطر الحقيقيّ على المجتمع الإسرائيليّ ومتانته وحصانته المجتمعيّة بعد انحسار كافّة التهديدات الخارجيّة، وعبر رفض الاعتراف بضرورة مراجعة الاستراتيجيّات والسياسات الأمنيّة، بل إخضاعها لأهداف سياسيّة وعقائديّة، جاء هجوم السابع من أكتوبر ليزعزعها نهائيًّا، ويقول إن إسرائيل تحتاج إلى رؤية أمنيّة جديدة تستبدل تلك السائدة خلال الأربعين عامًا الأخيرة،
والتي لم تنجح في حلّ المشاكل مع الفلسطينيّين نهائيًّا، رغم بعض النجاحات الإستراتيجيّة، منها إجبار منظمة التحرير الفلسطينيّة على مغادرة بيروت عام 1982، والتي لم تؤدّ إلى اختفاء العداء الفلسطينيّ من لبنان، ولم تقضِ على قوة حزب الله. وهو الأمر مع الاجتياحات في الضفة الغربيّة والحملات العسكريّة على القطاع منذ العام 2007 والتي بلغت نحو 14 حملة، دون الاعتراف بالخطأ، وأكثر من ذلك فالحكومة الحاليّة بتوجّهاتها اليمينيّة والدينيّة تعتبر كل تطوّر، أو تغيير بين الفلسطينيّين، سواء كان إقامة السلطة الفلسطينيّة واتفاقيّات أوسلو، أو المصالحة الفلسطينيّة، أو استلاء "حماس" على غزة أمرًا ليس في صالحها دون فحص كافة جوانبه، بل عبر اتخاذ خطوات جزئيّة تحاول فيها ردعه وكبح جماحه.
وهو الحال بالنسبة لسوريا الجديدة، فإسرائيل تسارع إلى اعتبار ما حدث هناك، محنة دون أن تنظر إلى احتمال كونه منحة، أي دون فحص لكافّة جوانبه وأبعاده، وإن كان ربما أمر يمكن فهمه، أن تقدم إسرائيل على شنّ الغارات على معسكرات وعتاد الجيش السوريّ لتأمن خطرها، خاصّة وأن الظروف مواتية لتدمير القدرات العسكريّة لعدو آخر، في المنطقة بعد أن نجحت في كسر شوكة "حزب الله" وضرب إيران والحوثيّين وإلحاق أضرار كارثيّة بقدرات "حماس" العسكريّة،
وإلحاق اضرار خطيرة بالبنى التحتية المدنيّة هناك ومواصلة اجتياح المدن الفلسطينيّة في مناطق السلطة متى أرادت وكيفما أرادت، لكن الحديث عن كون سوريا تشكّل خطرًا ليها بنظامها الجديد وخلفيّات قائده الدينيّة وانتهاك السلطات لحقوق الإنسان ، يشكّل ضربًا من الانتهازيّة السياسيّة وتجييرًا للمصالح السياسيّة على حساب المواقف المبدئيّة، فإسرائيل تطمح، بل ربما تلهث لتطبيع مع السعوديّة، وهي أكثر الدول العربيّة تديّنًا، بل إنها منبع ومصدر الجماعات الإسلاميّة المسلّحة فهي التي بادرت إلى إقامة جماعات المجاهدين وإرسالهم إلى أفغانستان لمحاربة الوجود الشيوعيّ السوفييتي هناك، وموّلتهم بمئات ملايين الدولارات والأسلحة ودرّبتهم في مناطق داخل حدودها،
وهذه الحركات كانت الأرضيّة الخصبة للحركات الجهاديّة ومنها "القاعدة" وطالبان وداعش ، وعنها انبثقت هيئة تحرير الشام، ناهيك عن كونها دولة تحكمها الشريعة الإسلاميّة، بما في ذلك قضايا الأحوال الشخصيّة والعقوبات والحريّات والتصرّفات وحقوق المرأة، وتشريعاتها كلها دون استثناء، يدَّعون أنها تستند إلى القرآن الكريم، أما قضيّة الديمقراطيّة والانتخابات وحقوق الإنسان والحريّات الديمقراطيّة وحريّة التعبير عن الرأي فلا حاجة للحديث عنها، فهي غير قائمة أصلًا، وهو الأمر ذاته في العلاقة الحميمة بين إسرائيل ومصر عبد الفتاح السيسي،
والذي يشتهر بكونه متزمتًا دينيًّا ويمارس ملاحقة الناشطين السياسيّين والمحسوبيّات السلطويّة ومظاهر الفساد تنخر عظام الحكم، ورغم ذلك لا تعتبره إسرائيل خطرًا عليها، بل ترحب بوساطته بينها وبين "حماس". والأمر سيان بالنسبة لدولة قطر، والتي موَّلت "حماس" بمليارات الدولارات واستضافت قياداتها في الدوحة، ولا مجال لذكر حقوق الإنسان والليبراليّة والديمقراطيّة فيها، لكن إسرائيل الحالية تعتبرها حليفة، أو تسعى إلى كسب ودها الدائم، عملًا بالقول الشهير الذي نقل عن رئيس الوزراء الإسرائيليّ أريئيل شارون أن " ما تراه من هناك لا يمكنك أن تراه من هنا" فاختلاف المصالح يتيح الانتهازيّة والتفريق بين دول تنتهج نفس النهج ،واعتبار بعضها محنة بينما الآخرى منحة.
والأمر يزداد وضوحًا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن إسرائيل الرسميّة تدرك في حالتي قطاع غزة وسوريا أن الأوضاع في السنوات المقبلة في كلا الموقعين سوف تتشكّل، أو تتبلور من الخارج إلى الداخل، وأن هناك تغيرات دوليّة قد تؤثّر على مسار الأمور في الموقعين، فمواقف أوروبا وأميركا وربما إسرائيل وعلى ضوء الهزيمة التي لحقت بالقوى الإقليميّة التي ساندت النظام السابق، وتحديدًا إيران وحركة "حزب الله" وحركة "حماس" وإنهاك قواها ، قد يعزّز من توجّهات ليبراليّة وعقلانيّة للنظام الجديد في سوريا،
ويعزّز من حاجتها للتحالف مع دول مشابهة، وربما اتفاق، أو صفقة ما مع إسرائيل خاصّة على ضوء إعلان الشرع أو الجولاني أن بلاده استنزفتها الحرب، ولا تريد معاداة، أو محاربة إسرائيل، حتى أن البعض يصل حدّ الاعتقاد أن سوريا الجديدة قد تتّجه إلى الاستعانة بإسرائيل لمنع، أو لمواجهة تأثيرات خارجيّة معينة منها تلك التركيّة، أو الإيرانيّة مستقبلًا، ويحذّرون رغم اعتقادهم أن إسرائيل قد تستفيد من حملتها العسكريّة ضد سوريا ،
من أن سوريا إذا استعادت عافيتها لن تنسى الهجمات الإسرائيليّة التي قالت عنها الإدارة الجديدة إنها اعتداء فظ بلا مبرّر ومن دون شرعيّة، وبالتالي قد يساهم هذا النهج الإسرائيليّ في إضعاف الجيش السوريّ الرسميّ وتمكين المسلّحين من مختلف الطوائف من رفض المطالب بتنحية سلاحهم، وبالتالي جرّ البلاد إلى مواجهات تنتهي إلى تقسيم سوريا وهو أسوأ سيناريو تتحدّث عنه المؤسّسات الأمنيّة، فهو يعني صداع أمنيّ مزعج على الحدود السوريّة ،ناهيك عن كونه يعني بأن الإسلام السياسيّ المنضوي تحت كنف تركيا أردوغان،
هو الذي يمثل الآن بفعل جبهة النصرة لاعبًا أساسيًّا وقريبًا، والسؤال الذي يجب طرحه حاليًّا في إسرائيل يجب أن يدور حول الجدوى من رفض مسبق لرؤية التطوّرات ، بل المسارعة إلى تكريس القناعة السياسيّة اليمينيّة الرافضة لأي احتمال لواقع جديد في سوريا، وذلك رغم المواقف التي عبّر عنها محلّلون متعدّدون بأن التطوّرات الدراماتيكيّة في سوريا إمّا أن تتحوّل إلى منحة، أو تصبح محنة، وأن المستقبل كفيل بكشف ذلك.
أقول ما سبق مع التأكيد انطلاقًا من معرفة منطلقات وتوجّهات إيران منذ الثورة الخمينيّة وسعيها إلى تطبيق مبدأ ولاية الفقيه، وامتلاك الأسلحة النوويّة، وأؤكد أنّ طهران سوف تواصل السعي إلى كونها جهة فاعلة رئيسية في الشرق الأوسط، ومواصلة سياستها المتمثّلة في محاولة ضمان أمنها عبر زعزعة أمن جيرانها في الشرق الأوسط. وهي حالة ثانية من رفض القيادات السياسيّة مراجعة حساباتها ومحاولة الاعتراف بأخطائها وبانتهازيّتها وتجيير مقدرات البلاد والعباد لمصلحة فئة ضيّقة ، وتكرار الخطأ وتوقع نتائج مختلفة ومغايرة،
وذلك خلافًا للمصلحة الإيرانيّة العامّة التي أكّدتها المعطيات والتي تؤكّد الشباب الإيرانيّين بغالبيّتهم يؤكّدون مرّة تلو الأخرى إلى أنهم يعطون الأولويّة للاحتياجات والحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة والسياسيّة المحلّية. لذا، فالتغيير مُمكن في إيران، فقط إما عبر بروز قيادة وسياسة جديدتَيْن في الجمهوريّة الإسلاميّة،
أو عبر تغيير جوهريّ أوسع، ربما سيكون بفعل عوامل خارجيّة خاصّة إذا ما صدقت التوقّعات بأن الولايات المتحدة ستمارس سياسات جديدة تجاه إيران تتجاوز العقوبات الاقتصاديّة والسياسيّة الأميركيّة والأوروبيّة وصولًا إلى نشاطات أميركيّة عسكريّة ضد المنشآت العسكريّة والنوويّة والاقتصاديّة الإيرانيّة تؤدّي إلى تغييرات داخليّة في إيران، وهي حالة تبدو اليوم بعيدة المنال وغير متوقّعة الحدوث،
ورغم ذلك يسود البعض الانطباع بأن غموض المرحلة التي تسبق ولاية الرئيسّ الأمريكيّ الجديد المنتخب دونالد ترامب قد تستوجب متابعة الأحداث لرؤية ما إذا كانت "العدوى السورية" سوف تنتقل إلى دول عربيّة وإسلاميّة وشرق أوسطيّة وإقليميّة أخرى، نحو موجة جديدة من الربيع العربيّ الجديد، الذي سيصل أولًا تلك الدول التي تسودها الظروف الاقتصاديّة السيّئة ، والظروف السياسيّة التي تمنع، بل تقمع الحريّات وتمنع التطوّر والتقدّم.
فلسطينيًّا، يمكن القول إن حركة "حماس" ماضية في نهجها رفض الاعتراف بأخطائها ، فهي بهجوم السابع من أكتوبر بشكله ومضمونه وما تم فيه، كانت العامل الأساسّي في إعادة لحمة الشعب في إسرائيل ومنع تدهوره إلى مواجهات كانت قريبة بدت بوادرها خلال احتجاجات معارضة للانقلاب الدستوريّ،
وربما كانت سببًا في إطالة عمر حكومة نتنياهو الحاليّة، هذا بما يتعلّق بإسرائيل ، كما أنها تتحمّل مسؤوليّة كبرى لمواقف بعض دول العالم والتي وقفت إلى جانب إسرائيل دون قيد او شرط، وحالت دون تمكين الولايات المتحدة من لعب دور في البحث عن إمكانيّة لأحراز تقدم في المسار التفاوضيّ، وزادت ربما من تأييد اليمين الأميركيّ لإسرائيل،
وفوق ذلك تتحمّل مسؤوليّات كبيرة وربما حصريّة للوضع الحالي في القطاع عبر عشرات آلاف القتلى وتهجير نحو مليون مواطن وهدم كافّة مقوّمات الحياة هناك في حرب يبدو أن أحدًا لا يجرؤ عالميًّا على استعجال إسرائيل لإنهائها،
كما ترفض حتى اليوم الاعتراف بخطئها من حيث عدم اتباع العمل السياسيّ الفعّال والاكتفاء بالعمل العسكريّ رغم إدراكها محدوديّة قوّتها وقدراتها، وترفض القبول بأن المقاومة المسلّحة وحدها ليست كافية لتحقيق الأهداف الوطنيّة، بل يجب أن تكون مدعومة بجهود دبلوماسيّة،
وأن العمل العسكريّ يجب أن يكون جزءًا من استراتيجيّة شاملة تهدف إلى كسب الدعم الدوليّ، وزيادة الضغط على الأطراف المعنيّة لحلّ القضيّة الفلسطينيّة.
ختامًا، يبدو أن حمى عدم اعتراف السياسيّين والقادة في الشرق الأوسط عامّة، هي حمّى أصابت الجميع دون استثناء، رغم نتائجها المأساويّة على الجميع إنسانيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا ونفسيًّا، ما ينذر ربما بان لا مكان للتفاؤل القريب وربما حتى البعيد، خاصّة وأننا أمام قيادات حولت السياسة والمواقف منها إلى دين من المستحيل التراجع عن مفاهيمه، خاصّة وأن العامّة لن تقبل ذلك، متناسين قول الفيلسوف الفرنسيّ غاستون باشلار: "لا حقيقة دون خطأ مصحح. ولا يتم الاعتراف بالخطأ إلا بعد حين. فالعقل هو الذي يعود إلى ماضيه في حدّ ذاته من أجل الحكم عليه". ويبدو أن حمى التزمّت من جهة ونشوة النصر المُتَخَيَّل من جهة أخرى أذهبت عقول القيادات وجعلتها لا تحكِّم العقل، بل الغوغائيّات والعواطف والرغبات في الانتقام ورفض التبحّر والتفحّص والاهتمام بالمصالح الشخصيّة والضيّقة والآنيّة وليس العامّة، وعدم الاعتراف بالخطأ رغم الحكمة الصينيّة الشهيرة التي تقول: "ليس هناك خطأ أكبر من عدم الاعتراف بالخطأ".
ومع حلول العام الجديد، هل سيستمر الشعور بأن مرحلةً سيّئة توشك على نهايتها، أم إنه أمل زائفٌ إذ ستتفاقم الأمور طالما لا تعود الشعوب وقياداتها إلى صوابها، بأن الإنسان هو القيمة العليا وليس المنصب، أو القوّة العسكريّة!!