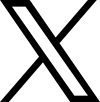سيفعل المتزمّت دينيًّا وسياسيًّا أيّ شيء للحفاظ على عرشه!
مع مرور أسبوع على اغتيال يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسيّ لحركة "حماس"، وقائدها الوحيد في قطاع غزة، بل أكبر قادتها على الإطلاق في السنوات الأخيرة، بعد أن جمع منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر عام 2023، بين الجناح السياسيّ، بعد اغتيال إسماعيل هنية، والعمل العسكريّ.

باعتباره أحد المخطّطين والمبادرين لهجمات السابع من أكتوبر، ورغم أن اغتياله، أو تصفيته ليست الأولى في تاريخ "حماس" الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعمليّات تصفية واغتيال بدءًا من الشيخ أحمد ياسين و يحيى عياش وإسماعيل هنية وصلاح العاروري وغيرهم، وربما لن تكون الأخيرة، خاصّة وأن إسرائيل أعلنت رسميًّا أنها ستلاحق كافّة قادة الحركة، وكل من كانت له يد من قريب،
أو بعيد في تخطيط وتنفيذ ومتابعة هجمات أكتوبر، إلا أن هذا الاغتيال يثير أسئلة كثيرة ربما تختلف هذه المرّة عن سابقاتها، وتزداد أهميّة وحدّة وإلحاحًا من حيث البحث عن إجابات، كونها لا تتعلّق بمستقبل ومصير واستمراريّة حركة "حماس" أو زوالها، بل تتعلّق بحالة آنيّة، وبالتالي فإن السؤال حول أهميّتها لا يدور في فلك نظريّ يحتمل البحث المطوّل ويمكنه انتظار الجواب، بل يدور حول أمور عمليّة على أرض الواقع ، سياسيّة وتنظيميّة ستحدّد نتائج عملياتيّة وعسكريّة، وستحدّد احتمالات استمرار الحرب أو توقّفها، واحتمالات صفقة تبادل،
ما زالت ماثلة رغم مرور الزمن، يتم بموجبها إطلاق سراح الرهائن والمختطفين الإسرائيليّين وعددهم 101، ومن بقي على قيد الحياة منهم، مقابل مئات السجناء الفلسطينيّين، إضافة إلى أبعاد أخرى تفوق الآنيّ والموضعيّ، أو المحليّ جغرافيًّا وزمنيًّا، خاصّة وأن انتهاء، أو توقّف الحرب في غزة ، يعني أو من المفروض أن يعني انتهاءها في الشمال، فهي حرب إسناد كما تقول حركة "حزب الله" ستنتهي بمجرد انتهاء، أو انتفاء سببها، وهي أسهل للحلّ، كما يقول الموفد، أو المبعوث الأميركيّ إلى لبنان عاموس هوخشتاين،
وربما ستصل حدّ نهاية المواجهة بين إسرائيل والحوثيّين، وربما حتى الخلاف العسكريّ مع إيران، والذي ما زال ماثلًا يلقي بظلاله على كافّة التحرّكات والتطوّرات، خاصّة وأن كلّ يوم يمضي، يعني اقتراب الردّ الإسرائيليّ على هجمات إيران مطلع الشهر الحالي، والذي رشحت معلومات حول كون الإدارة الأميركيّة قد تلقّت من إسرائيل قوائم مكتوبة وواضحة تفصِّل الأهداف التي سيتمّ قصفها، وأنها ستكون ضمن صناعات النفط ومواقع عسكريّة وحكوميّة مستبعدةً أن يشمل ذلك المنشآت النوويّة الإيرانيّة.
قبل الخوض في التأثيرات المستقبليّة وقبلها الآنيّة لاختفاء يحيى السنوار عن الساحة، وبغضّ النظر عن هويّة خلفه خاصّة وأنه اتّضح أن قيادة الحركة، أو خلافته ستكون جماعيّة، إعلاميًّا وخارجيًّا على الأقل، أي عبر لجنة، أو قيادة خماسيّة تشمل خالد مشعل رئيس المكتب السياسيّ سابقًا، والذي نجا من محاولة اغتيال إسرائيليّة في عمان مطلع القرن الحاليّ، والمقيم في قطر حاليًّا ، وخليل الحيّة نائب يحيى السنوار، وزاهر جبارين المعرَّف بأنه وزير مالية "حماس" ومحمد درويش رئيس مجلس الشورى،
وشخصيّة خامسة لم يكشف النقاب عنها، هي ربما محمد السنوار الشقيق الأصغر ليحيى. تجدر الإشارة إلى أسباب كثرة الأسئلة والتساؤلات حول الفترة القادمة، وهي أسباب مردّها الرأي السائد أميركيًّا على الأقل، بأن طيلة الفترة التي جرت فيها المفاوضات حول إمكانيّة وقف إطلاق النار الدائم، أو المؤقّت، أو المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن ضمن صفقة تبادل،
وهو ما اعتقد واتفق عليه كبار المسؤولين في الإدارة الذي جمعهم الأمل في أن يحيى السنوار ومواقفه المتعنّتة كانت السبب في فشل تلك المفاوضات خاصّة وأنه اشترط انسحابًا إسرائيليًّا كاملًا من القطاع برمّته، وتعهّدات أخرى غير ممكنة إسرائيليًّا وأميركيًّا، وبالتالي أمل الأميركيّون في أن يكون التخلّص منه فاتحة أو بارقة أمل في قيادة أقل تشدّدًا تسمح بإحراز تقدّم في المفاوضات السابقة الذكر.
ومن هنا جاءت ردود الفعل الأميركيّة التي رأى أصحابها أن اغتيال السنوار يفتح أبوابًا كانت موصدة، أو لم يكن بالإمكان فتحها بوجوده، بل ذهب بعض المسؤولين الأمريكيّين إلى أن مقتل السنوار،
يمكن اعتباره الحدث الذي تحتاج إليه إسرائيل بشدّة حتى تتمكّن من إعلان انتهاء حربها في غزة، أو تغيير قواعد اللعبة هناك. وهو موقف يشبه إلى حدّ كبير موقف جهات إسرائيليّة منها ذوي المخطوفين الذين قالوا إن مقتله يشكل صورة الانتصار الذي بحثت عنها إسرائيل، وبالتالي يجب إنهاء الحرب والتوقيع على صفقة تضمن إطلاق سراح الرهائن.
وإن كان كثيرون يتفقون، ومنهم أعضاء في حركة "حماس" وكذلك في إيران وغيرها، أن اغتيال قادة الحركة ومنهم يحيى سنوار ومحمد ضيف في غزة وصالح العاروري في بيروت وإسماعيل هنية في قلب طهران العاصمة الإيرانيّة، يشكّل ضربًا من الهزيمة التكتيكيّة ومسًّا بالقدرات العسكريّة والعملياتيّة، خاصّة وأنه كان القائد الأوحد، وأن الضرر الكبير يتمثّل في اغتيال السنوار، إلا أن هناك شبه إجماع على أن غيابه لن يغيّر وجه الحركة وسياساتها ومواقفها ودستورها تجاه إسرائيل، وهذا ما أكّدته تصريحات قياداتها في الداخل والخارج،
ناهيك عن أنه إذا اتّضح أن محمد السنوار الشقيق الأصغر هو القائد الجديد داخل غزة، ويشهد على ذلك سجله العسكريّ في ملاحقة العملاء ودوره في اختطاف الجنديّ جلعاد شاليط، وقدرته الكبيرة كما يؤكّد العارفون، على فهم الجانب الإسرائيليّ، وقدرته على تحويل أنصارها ضدّها، إضافة إلى فهمه لأنماط العمليّات السريّة الإسرائيليّة فهو كان معتقلًا في السجون الإسرائيليّة، وتعرّض أكثر من مرّة لمحاولات اغتيال، ورغم أنه لا يتمتع بكاريزما القيادة التي كان يتمتع بها شقيقه لكن يتمتّع بشهرة ،
ربما حقيقيّة، كعسكريّ ومقاتل ، ويعتبر وفق أقوال أندرياس كريغان، المتخصّص في شؤون الشرق الأوسط. أكثر قسوة وتشدّدًا وتطرّفًا من شقيقه، الذي اتهمته إسرائيل أنه يماطل في توقيع الصفقة المرجوة. وهنا لا بدّ من الإشارة إلى سياسة التهرّب والمماطلة التي انتهجها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال المفاوضات، والتي أفشلت وأحبطت صفقات كانت قريبة، من خلال شروط جديدة وضعها نتنياهو سماها" إيضاحات"، أو أسماء أخرى، وبالتالي لا بدّ هنا من أسئلة منها هل ستصل قيادة "حماس" الجديدة إلى الاستنتاج أنه إذا ما أرادت الحياة، فعليها الموافقة على صفقة لإطلاق سراح الرهائن ووقف الحرب، وبأسرع وقت ممكن خاصّة مع وجود الجيش الإسرائيليّ في كافّة مناطق القطاع من شمالها حتى جنوبها،
وإنجازاته العسكريّة والاستخباراتيّة، ونتيجتها تصفية واغتيال معظم المخطّطين لهجمات السابع من تشرين الأول، وهل سيكون للاغتيالات هذه قيمة ومعنى في الشرق الأوسط الذي يفهم استعراض القوّة واستخدامها، وكان قد شاهد إسرائيل في قمّة ضعفها بعد السابع من أكتوبر، ويشاهدها اليوم وقد أجهزت على قيادات "حماس" و"حزب الله"، أم أن التعصّب الدينيّ وتقديس الشهادة في نظر الحركات الإسلاميّة الأصوليّة والرغبة في الانتقام ستقود إلى مزيد من تعزيز قوّة الحركة، فهذا ما حصل في الاغتيالات السابقة، خاصّة على ضوء المعطيات التي تؤكّد تعمّق المشاعر والتوجّهات الدينيّة خلال العام الأخير.
ولكنّ اختصار السؤال، أو التساؤلات اليوم، بما يريده قادة "حماس" وماذا سيكون عليه الحال في الحركة في فترة ما بعد السنوار، هو عمل يجافي الحقيقة، ويصرف النظر عن الطرف الثاني في المعادلة، وهو إسرائيل، التي يجب أن تسأل قياداتها نفسها، وأن يسأل الجمهور ذلك أيضًا، ماذا تريد بعد اليوم، خاصّة في ظلّ استمرار الحرب وما يبدو أنه رغبة إسرائيليّة وخاصّة من جانب بنيامين نتنياهو في مواصلة الحرب في غزة،
وليس ذلك فقط، بل نقل الاهتمام والجهد العسكريّ والعمليّاتيّ إلى لبنان، وربما النظر، ولو خلسة، إلى إمكانيّة توسيع النزاع المسلّح ليشمل أيضًا إيران في صورة تمثّل حربًا إقليميّة واسعة، قد يعتبرها البعض نقضًا، أو نقيضًا للمقولة الإسرائيليّة المتداولة منذ عقود، من أن كل ما تريده إسرائيل هو العيش بهدوء وسلام، دون أن يعتدي عليها جيرانها، وهو ادّعاء استخدمته إسرائيل لتبرير كافّة أفعالها خاصّة في عهد حكومات نتنياهو من مواصلة وترسيخ الاحتلال وتوسيع المستوطنات والسيطرة على الأراضي الفلسطينيّة، وتكريس الجمود السياسيّ وإقصاء السلطة الفلسطينيّة، فرغم الحقيقة الواضحة أن إسرائيل محاطة بعدد من الأعداء الذين لا يتورّع بعضهم عن التصريح علنًا برغبتهم في إبادتها والقضاء عليها، من تنظيمات تتصرّف وفق ميثاق دينيّ ومنها "حماس" وتبني الأنفاق وتكرّس المال للتسلّح كحركة "حزب الله"،
وكذلك إيران التي تشتهر بتلك الساعة تنازليّة العدّ، التي تتنبأ بزوال دولة إسرائيل، لكنّ السؤال الملّح هنا وعلى ضوء ما سبق، هو كيف يمكن لإسرائيل والتي تقول إنها تريد أن تعيش وأن من حقها ذلك، أن تفعل ما تفعله اليوم للشعوب القريبة، وتحديدًا في غزة، دون أن يتحرّك الشعب فيها وأن يسأل عن التناقض العجيب بين دولة كل ما تطلبه هو العيش بسلام، وبين ما يحدث اليوم في غزة والضفة الغربيّة وغيرها، ويبدو أن الجمهور الإسرائيليّ لا يريد أن يعرف،
وأن اللامبالاة تجاه ما يحدث في قطاع غزة أصبحا السمة الملازمة لغالبيّة الشعب في إسرائيل، حتى أولئك المتنوّرين، الذين اعتادوا رؤية الآخرين بمن فيهم الفلسطينيّين في غزة والضفة الغربيّة، كائنات بشريّة مساوية لهم، أو مثلهم من حقها العيش بسلام، وأنهم مجموعة بشريّة تريد الحياة الطبيعيّة وتربية أطفالهم والاهتمام بهم، ويطمحون إلى السلام، لكنهم سرعان ما وصلوا إلى "منطقة العمى المطلق" بعد السابع من أكتوبر، ليكتشفوا كما يقولون أن الآخر لا يشبههم، وليس مثلهم،
وبالتالي عليهم دفع ثمن ذلك، وربما دفع ثمن محاولاتهم التي نجحت في جعل الإسرائيليّين المتنوّرين يؤمنون أنهم مجموعة، تختلف عن نفسها وعن طبيعتها الحقيقيّة، أو أن يدفعوا ثمن دورهم في " العمى الذاتيّ" الذي أصاب أولئك المتنوّرين، ومن هنا مواقفهم التي تشكل لا مبالاة واعية ومدركة لما يحدث للطرف الآخر، وما تفعله حكومتهم، لكن ذلك لا يهمهم، وهم يؤكّدون أنهم لا يكترثون لموت أطفال وأبناء الطرف الآخر.
وهل حقًا كل ما تريده إسرائيل هو العيش بسلام مع جيرانها؟ وكيف يتماشى ذلك مع المؤتمر بعنوان:" نتأهب للعودة للاستيطان في غزة" الذي دعا إليه ونظّمه نواب ووزراء من الليكود، الحزب الحاكم الذي يدّعي العقلانيّة، لتشجيع العودة إلى المستوطنات في قطاع غزة، وليس مجموعات الكهانيّين المتطرّفين أتباع إيتمار بن غفير الذي دعا خلاله إلى تشجيع الغزيّين على الرحيل طواعية، أو مجموعة الخلاصيّين المتطرّفين أتباع بتسلئيل سموتريتش،
ما يعني أن الليكود انضم كله إلى قائمة أولئك الذين لا يكترثون ، ما يؤكّد ضرورة تكرارهذا السؤال ، انطلاقًا من إيماني التامّ أن عدم قدرة، أو شجاعة، أو استطاعة دولة إسرائيل الردّ على السؤال المذكور، ماذا تريد إسرائيل، هو ما أوصلها إلى هذا الحال، وتحديدًا ما كتب حوله الكثير،
وأقصد قيادة بنيامين نتنياهو الذي لا تستطيع اتخاذ القرارات وحلّ النزاعات، بل تعتمد المماطلة والتأجيل وإدارة الازمات بدل حلّها. وهي سياسة تجعل من المستحيل أو الصعب على الأقل ، إنهاء الحرب خاصّة وأن عدم القدرة على حسم الأمور واتخاذ القرارات، يلغي إمكانيّة، أو احتمال رسم صورة واضحة ومسبقة للانتصار، أو صياغة صورة الانتصار.
ومع كلّ ذلك، فإن انتباه العالم سيتحوّل وبعد أن تنخفض ألسنة اللهب في قضية السنوار، إلى الساحة الإيرانيّة، وتهديد إسرائيل بردّ قريب على إطلاق نحو مئة وتسعين صاروخًا بالستيًّا عابرًا للقارات باتجاه إسرائيل مطلع الشهر الحاليّ، وهي العمليّة التي اعتبرتها إيران ردّها على عملية اغتيال إسماعيل هنية على أراضيها، واغتيال حسن نصر الله في العاصمة بيروت، والحال هنا يشهد تنافسًا ربما بين توجّهين: الأول ينظر في ردّ يؤدّي إلى التصعيد التام، وتسخين الأمور بين إسرائيل وإيران بما في ذلك المسّ بالمنشآت النوويّة الإيرانيّة،
بشكل ربما يدفع النظام في طهران إلى تسريع الخطوات لإتمام مشروعه النوويّ ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم، والثاني هو ما تريده أميركا فهي تريد ردًّا يمكن ضبطه، أو ردًّا معتدلًا ، يمكنها من مواصلة الحوار حتى لو كان غير مباشر مع القيادة الإيرانيّة حول هذا المشروع. وهو وضع يكتنفه وربما يحدّد نهايته وطبيعته أمران؛ أولهما الانتخابات الأميركيّة الرئاسيّة في الخامس من تشرين الثاني القريب، وثانيهما دخول الرئيس الجديد سواء كان دونالد ترامب أو كامالا هاريس البيت الأبيض في العشرين من كانون الثاني2025،
علمًا أن الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن أعلن مؤخّرًا، وبشكل علني، معارضته لإمكانيّة أن تشمل الضربة العسكريّة الإسرائيليّة منشآت نفطيّة أو نوويّة، لأن من شأن الأولى أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط في العالم، وهو أمر لا تريده الولايات المتحدة خاصّة وأنها اضطرّت إلى استخدام مخزونها من النفط في بداية الحرب الروسيّة الأوكرانيّة، كما اضطر جو بايدن لزيارة المملكة العربيّة السعوديّة راجيًا زعيمها وولي عهدها محمد بن سلمان زيادة صادرات وإنتاج بلاده من النفط، وهو ما ترفضه مجموعة، أو منظمة "اوبك بلوس" بزعامة السعوديّة وروسيا،
ناهيك عن تأثير ارتفاع أسعار النفط عشية الانتخابات الرئاسيّة على المصوّتين الأميركييّن فهي ستبعدهم عن التصويت للديمقراطييّن ومرشحتهم الرئاسية هاريس. أما ضرب المنشآت النوويّة الإيرانيّة فيعني إلزام إيران التي يبدو أنها لا تريد مواجهة إقليميّة مباشرة مع إسرائيل، بل تريد لحلفائها "حزب الله" و"حماس" القيام بذلك، وهما تلقتا ضربات موجعة جدًّا، بردّ قويّ قد يضطرّ الولايات المتحدة إلى التدخل. لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يجد الأمر فرصة سانحة ومواتية لتصعيد إقليميّ ومتعدّد الجبهات،
يشمل غزة ولبنان واليمن. وإذا كان الحال كذلك اليوم فلماذا لا تضاف إليه أيضًا الجبهة الإيرانيّة، أي توسيع المواجهة، لتشمل ضرب المنشآت النووية الإيرانيّة وإزالة الخطر الذي يمثّله المشروع النوويّ الإيرانيّ، وبالتالي تسود في أروقة الإدارة الأميركيّة مشاعر قوامها أن نتنياهو لن يتردّد وربما سيبادر بفرح بالغ إلى جرّ الولايات المتحدة لمواجهة عسكريّة إقليميّة يتم خلالها مهاجمة المشروع النوويّ الإيرانيّ بمشاركة أميركيّة إسرائيليّة. وهي مخاوف تساور الولايات المتحدة منذ 2012، إبان عهد الرئيس باراك أوباما، الذي بادر إلى اتصالات سريّة مع إيران بوساطة عُمانيّة ، انتهت عام 2015 إلى الاتفاق النوويّ بين إيران والأمم المتحدة والدول الخمس الكبرى.
ولكنّ الحال يختلف اليوم، فنتنياهو الذي تردّد عام 2012 في مهاجمة المنشآت النوويّة الإيرانيّة، رغم تأييد المسؤولين العسكريّين لذلك، خشية أزمة مع الرئيس باراك أوباما، يمتلك اليوم هامشًا أوسع للمناورة، فالشرق الأوسط يعيش حالة عدم استقرار بل فوضى، والحرب جارية، وربما على أشُّدها وهو ما قد يمنح نتنياهو المبرّر والشرعيّة لمهاجمة المشروع النوويّ، وبالمقابل فإن هامش المناورة للإدارة الأميركيّة الحاليّة محدود، بل معدوم، فالانتخابات على الأبواب والاستطلاعات التي تشير إلى شبه تعادل بين المرشحَين الديمقراطيّة كامالا هاريس والجمهوريّ دونالد ترامب، تمنع الديمقراطيين من أيّ مواجهة علنيّة مع نتنياهو قد تمسّ بنسبة التصويت، أو تؤدّي إلى أزمة طاقة عالميّة عشيّة الانتخابات.
ومن هنا الخشية في الولايات المتحدة من أنه، وخلافًا للعام 2012، لن يكون هناك من يتمكّن كبح جماح نتنياهو، ويمنعه من توجيه ضربة كهذه، وكم بالحريّ، بعد التغيرات السياسيّة الإسرائيليّة الداخليّة، وتحديدًا انضمام الوزير جدعون ساعر إلى الائتلاف ما يضعف قدرة وزير الأمن يوآف غالانت على منع ذلك، رغم أنه من شبه المؤكّد هنا أن نتنياهو والذي زار الولايات المتحدة الشهر الماضي والتقي بايدن وهاريس وترامب، في لقاءات تمحورت حول الشأن الإيراني ، سمع من ثلاثتهم موقفًا قريبًا أو مشابهًا ملخّصه أن الولايات المتحدة ترفض وتعارض هجومًا إسرائيليًّا على المنشآت النوويّة الإيرانيّة، وأن الثلاثة يسعون إلى اتفاق مع طهران، وهو اتفاق يعتبره نتنياهو، وبغض النظر عن مضمونه، سيّئًا لإسرائيل.
خلاصة القول أن مجمل الأمور لا يبشر خيرًا، أو أنه على الأقل، لا يثير الطمأنينة، فالحالة اليوم في كافّة القضايا سابقة الذكر ، متأرجحة يميّزها عدم الاستقرار والخوف من مغامرات غير محسوبة ، فهي تتراوح بين رئيس وزراء يعتبر إيران ومشروعها النوويّ الخطر الداهم والأكبر على إسرائيل، ويصرّح علنًا على الأقل، أن مواجهة المشروع النوويّ الإيرانيّ هي مشروع حياة بالنسبة له، لكنّه متردّد في اتخاذ القرارات ينتظر حتى اللحظة الأخيرة، قبل اتخاذها، وتتجاذبه ضغوطات داخليّة وخارجيّة وبعضها عائليّ، يضاف إليها الآن "الحساب الشخصيّ" بين نتنياهو وطهران بعد أن أصابت مسيَّرة "حزب الله شباك غرفة نومه بمنزله في مدينة قيساريا نهاية الأسبوع الماضي،
ما اعتبره محاولة اغتيال حقيقيّة، ومراوحة في المكان في غزة ولبنان ، وضغوط حزبيّة تطلب التصعيد عبر تهجّمات كلاميّة على رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال هرتسي هليفي، شهدتها جلسة الحكومة، تساءل وزراء من حزب نتنياهو تحديدًا، لماذا لم تردّ إسرائيل بما يكفي على هذه المسيرة، ما قد يشير إلى محاولة للضغط نحو ردّ يؤدّي إلى التصعيد، أو ربما يكشف حقيقة نتنياهو المتردّد في اتخاذ القرار،
عبر إلقاء التهمة على الجيش بشان عدم الردّ، رغم أن المستوى السياسيّ، وتحديدًا رئيس الوزراء ومعه ربما وزير الأمن هو من يقرّر حجم ومستوى وموعد ومكان الردّ، وانتخابات أميركيّة نتائجها غير واضحة قد ينتهي إلى رئاسة لكامالا هاريس، أو دونالد ترامب، تشكّل مرحلة ربما تمنع نتنياهو من اتخاذ قرارات قد تكون متسرّعة وغير مدروسة تجرّ المنطقة إلى حرب إقليميّة، أو ربما بالعكس تجعله يتخذها، انطلاقًا من إيمانه أنها الفرصة الأخيرة لذلك، كما يصرح نتنياهو ومقرّبوه أكثر منه،
أي أن كافّة السيناريوهات مفتوحة وواردة، وحالة جديدة في "حماس" غزة بعد اغتيال السنوار، قد تنتهي إلى اعتدال ومراجعة للحسابات، وسعي إلى وقف إطلاق النار وصفقة تبادل للرهائن، أو تقود نحو التشدد بدافع الانتقام للسنوار وهنية وغيرهما، أو من باب الرغبة في التأكيد على أن اغتيال القيادات لا يوقف عجلة الحركة ولا يمنعها من مواصلة الحرب، كما صرح مسؤولوها ومنهم خليل الحية نائب السنوار، ما يجعل كافّة السيناريوهات مفتوحة هنا أيضًا. وهو الحال في لبنان مع "حزب الله" الذي فقد رأسه حسن نصر الله وخليفته هشام صفي الدين،
ويريد أن يثبت لنفسه أولًا وللبنانيين ثانيًا ولإسرائيل ثالثًا أنه ما زال عنصرًا مؤثّرًا، وأن جبهة الإسناد ما زالت قائمة، كما يؤكد قادته ومن تبقى منهم ، وبالتالي قد يصحّ في حالنا الأوّل أن القادم أسوأ، أو أن ضباب معركة التصريحات الإعلاميّة يخفي ألسنة لهب قد تحرق المنطقة عامّة، وبضمنها دول لا علاقة مباشرة لها كدول الخليج والأردن وربما أوسع من ذلك، أو أن كافّة هذه التصريحات هي قعقعة إعلاميّة دون طحين حقيقيّ، اللهم إلا إبقاء الشعوب في حالة ترقّب وخوف وهلع والسيطرة على عقول العامّة، وكل ذلك لضمان بقاء الزعامات على عروشها، بينما جيوب شعوبها، وبطون بعض هذه الشعوب خاوية. فنحن أمام سيناريوهات مختلفة ومتفاوتة،
تكمن خطورتها وضبابيّتها في أنه ترسمها قيادات متشدّدة ومتطرّفة، أو مُحافظة في أحسن الأحوال صدق فيها قول وودرو ويلسون، الرئيس الثامن للولايات المتحدة حول كون السياسّي المحافظ عبارة عن رجل يجلس ويفكر، وغالبًا يجلس فقط. أو قول الرئيس الأميركيّ الثاني والثلاثين، فرانكلين روزفلت، أن السياسيّ المحافظ هو رجل لديه ساقان جيّدتان تمامًا، لكن لا يتعلّم أبدًا كيف يسير إلى الأمام، ولكن يبدو أن الحال أسوأ هنا، فهي زعامات تريد إعادة الجميع إلى حقب غابرة من التزمّت والتطرّف والكراهية،
وإلى حياة تحكمها توجهات أصوليّة دينيًّا وسياسيًّا تلفّها حالة فقر مدقع، وتحديد لحرية الفكر والإبداع، وإلى حروب لا تنتهي، يبرّرها القادة وتضطرّ الشعوب لتحمّل نتائجها، يقبلها كثيرون من باب الولاء الأعمى الدينيّ والسياسيّ والمذهبيّ، ولا يريده الزعماء، ليضمنوا بقاءهم متظاهرين بالعمل لمصلحة شعوبهم ومن منطلق الوطنيّة، تأكيدًا لصحّة قول السياسيّ الكنديّ، ويليام رونالدولف :"سيفعل السياسيّ أيّ شيء للحفاظ على وظيفته، حتى لو اضطرّ، لأن يصبح وطنيًّا"..فهل تعتبر الشعوب أم أن القطار قد فات؟!.