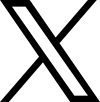حكومات لا تريد شعوبًا مفكِّرة بل جاهلة ومقهورة
بين ثلاثة أمور قد يعتبرها البعض متناقضة، وربما يعتبرها آخرون متكاملة، تجد المؤسّسات الأكاديميّة والتعليميّة في العالم عامّة، وتلك الدول التي تعتبر نفسها ليبراليّة وديمقراطيّة خلال السنوات الأخيرة، في حالة تشكّل ربما نقيض المبادئ التي بني عليها نظام التعليم الإلزاميّ في المدارس

وبالتالي الأهداف المرجوّة من التعليم نفسه،. وهي أوسع بكثير من تعليم القراءة والكتابة والعمليّة التعليميّة الضيّقة والأساسيّة، والأسس التي بنيت عليها خاصّة مناهج التعليم والتربية، وكونها كما نريد جميعًا حرّة من أيّ اعتبار سياسيّ خاصّة، أو غير تربويّ وتثقيفيّ عامّة، وكذلك عمليّة التعليم الجامعيّ بكافّة تخصّصاته التعليميّة ومكوّناته الأخرى التي تشمل حريّة التفكير والتعبير عن الرأي،
وكون الجامعات مساحة حرّة تلتقي فيها الأفكار والمواقف المتناقضة وصولًا إلى عصف ذهنيّ تكون مقوّماته ومضامينه مقبولة على البعض، ودون ذلك من البعض الآخر، لكن شرط أن يكون ذلك ضمن مساحة، أو إطار الرأي والرأي الآخر، دون إقصاء، أو رفض، أو تضييق خناق عبر تشريعات،
أو قوانين، أو حرمان من الدعم الماليّ الميزانيّات وغيرها، علمًا أن هذه الأمور الثلاثة تشكل مجتمعة، بل يشكل كل منها، ناقوس خطر وضوءًا أحمر ينذر بعالم مشوّه وسياسات تجهيل وتدجين. وأولها قول من أقوال يوهان فون غوته أحد أشهر أدباء ألمانيا المتميّزين، حين قال إنه ليس هناك أسوأ من معلّم لا يَعْرِف سوى ما يجب أن يعرفه تلاميذه.
وأضيف كم بالحري إذا كان لا يعرف سوى ما أراد السلطان أن يعرفه تلاميذه، وقول مارتن لوثر كينج أن لا شيء في العالم أخطر من الجهل الخالص والغباء المتعمّد ، فكم بالحري إذا كان الجهل متعمّدًا، أي تجهيلًا مقصودًا تقف خلفه أجندات سياسيّة ودينيّة وظلاميّة تريد خدمة الحاكم والسلطان وليس بناء الإنسان،
وثالثها ما اتّفق الجميع، حتى اليوم ربما، على صحّته وهو قول المفكّر البولندي الأصل، ألبرت باندورا الذي وصل الولايات المتّحدة في عام 1949 الذي يؤكّد أن التربية ليست خدمة عامّة تؤدّي للأفراد، وإنما هي عمليّة إنتاجيّة ينتظر منها عائد أو مردود،
ولكنه طويل المدى بمعنى أن نتائجه لن تتأتّى خلال عام، أو عامين أو خمسة، بل إن دورة حياتها هي عشر سنوات على الأقل إذا كان الهدف فعلًا هو التعليم الحقيقيّ، وضمان تأثير بعيد المدى، وبالتالي فإن ما ينفق على التعليم لا ينبغي أن يدخل في باب الاستهلاك على حدّ قوله، ولكنه بالضرورة يدخل في باب الاستثمار من منطلق الإيمان أن التربية الأساسيّة هي أكثر من غاية في حدّ ذاتها،
بل إنها الوسيلة والأساس التنمية الإنسانيّة، وبناء المجتمعات الراقية وقبول التعدّديّة والآخر. ولذلك، المطلوب هنا هو تغيير المفهوم الكلاسيكيّ للتعليم الأساسيّ وتوسيعه، وجعله يهتمّ بتزويد الفرد بالمهارات والقدرات الأساسيّة للتكييف مع بيئة ومجتمعه، وتعزيز قدراته الذاتيّة لكي يكون منتجًا قادرًا على العمل. وهو ما نسميه اليوم المهارات الحياتيّة، ولكن أقصد هنا بمفهومها الواسع,
وليس ذلك الذي يعتبر التعليم وسيلة للحصول على عمل ومردود مادّيّ، بل عمليّة تهدف إلى بناء الشخصيّة وصقلها وتذويت القيم وبناء إنسان يحاور ويناقش، يختلف ويتّفق، لكنه يملك من الشجاعة ما يجعله يقول رأيه بحريّة، ويقبل آراء الغير بشجاعة ورضىً، ومن هنا يمكن الجزم بأنه سيرفض الإملاءات والتدخّلات الغريبة التي لا علاقة لها بأهداف التعليم السامية. ويؤمن أن تغييب التعليم السليم،
وفرض القيود عليه في أحسن الحالات، أو منع المشاركين في سيرورته من معلمين ومسؤولين وطلاب من المساهمة الفكريّة والتعبير عن المواقف التي لا تطابق مواقف السلطة أو الفئة الحاكمة، يعني منع الشعب من امتلاك المعرفة والوعي. وهما شرطان اساسيان لاستقلاليّة المواطنين وإصرارهم على الحصول على حقوقهم، وقبل ذلك إدراك هذه الحقوق واعتبارها واجبات على السلطة الديمقراطيّة والليبراليّة،
أو بالأحرى الدولة ضمانها للمواطن كحقّ أساسيّ، وليس منّةً من أحد، فالتجارب التاريخيّة تؤكّد بما لا يقبل الشكّ أن الشعوب الواعية لا تقبل الظلم ولا تركع، ولا ترى أن الحكام، أو رؤساء الطوائف ورجال الدين منزَّلين منزَّهين، ولا تقدّس الأشخاص، ولا تقبل الغيبيّات والخزعبلات، وأن الشعب الواعي إنما يدرك دورة ومكانته في الحياة ويدرك حقوقه وواجباته ويصرّ على الحصول على حقوقه، ويرفض الخنوع للسياسات التي ليست في صالحه، بغضّ النظر عن هويّة من يريدها.
ما سبق هنا ليس نوعًا من التنظير، بل إنه تحذير ونذير سببه أمور عديدة تزامنت دون قصد، ترسم صورة قاتمة تؤكّد خطورة كافّة المحاولات الهادفة إلى تسييس التعليم في المدارس والجامعات، وتطويعه لخدمة أجندات الأغلبيّة، أو بقائها السياسيّ وتوجّهاتها الإقصائيّة، أولها النية المبيّتة في الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب، للسيطرة على الجامعات، وكمّ الأفواه وفرض القيود على التعليم الأكاديميّ،
وهي خطوة أولى في منزلق خطير سيصل حتمًا فرض الرقابة على المنشورات والأبحاث الأكاديميّة وربما إخضاع الجامعات خاصّة البحثيّة منها لنزوات مموّلين يشترطون تمويلهم بتكريس أجنداتهم، خاصّة إذا أقدمت الإدارة الأميركيّة فعلًا على اتخاذ خطوات عقابيّة ماليّة وإداريّة بحقّ مؤسّسات لا "تلتزم بالخطّ الرسميّ وبتوجّهات الإدارة الجديدة" والتي تعلنها صراحة أنها تريد وضع حدّ لحرية الرأي في الجامعات الأميركيّة تحت مسمّيات في معظمها سياسيّ وفئويّ،
وكلها خطيرة رغم أن الإدارة الجديدة وفي تسميات تعكس مواقفها ومن تدين له وتريد إرضاءه، تقول إنها خطوات حاسمة للقضاء على معاداة الساميّة، وتقصد المظاهرات المناوئة للسياسة الأمريكيّة تجاه هذه الدولة، أو تلك في الجامعات الأميركيّة منذ بدء الحرب في غزة،
ودعم ما تسميه الإرهاب الإسلاميّ في المؤسّسات التعليميّة الأمريكيّة، وخاصّة في الجامعات الكبرى، وهو ما أكّده دونالد ترامب بقوله الصريح إنه سيعمل على ذلك منذ أول أسبوع له في المكتب البيضاويّ، حيث ستبلغ إدارته كل رئيس كليّة أنه إذا لم تنته الدعاية المعادية للساميّة، فسوف تخسر كليّته وجامعته اعتمادها ودعمها الفيدراليّ، دون أن يكبد ترامب نفسه عناء شرح الخطوات والتصريحات التي يعتبرها معادية للساميّة،
وهل تندرج المطالبات بوقف الحرب في غزة ولبنان ضمنها، وهما حربان كان ترامب نفسه قد أعلن نيته إنهاءهما، وكالعادة دون أن يفصل ذلك ودون عرض خطة واضحة مكتفيًا بالتصريحات الواسعة، ما معناه أن الرئيس المنتخب يهدّد باتباع نظام جديد ينصّ على فرض عقوبات ماليّة على الكليّات والجامعات كوسيلة لفرض أجندته وإرضاء مؤيّديه،
وهو ما جعل الخبراء القانونيّين يحذّرون من إمكانيّة أن تواجه المدارس والجامعات قريبًا ضغوطًا خارجيّة لممارسة الرقابة على طلابها وهيئتها التدريسيّة وهيئات طلابها، وتنفيذ، أو تكريس أجندات تتّفق مع ترامب، ومن اختارهم من وزراء متشدّدين ومتطرّفين، يضاف إليه ما تعرّض له أساتذة في الجامعات وبعضهم من اليهود المعتدلين من هجوم وتحريض وتشكيك في مناهجهم، ومطالبتهم اليوم وبصراحة ودون خجل، الالتزام بالمناهج، أي بالتدريس فقط دون التربية،
أو التثقيف وبناء الإنسان الواعي والمتنوّر صاحب الرأي الخاص والمدافع عن حقوقه وحقوق الغير وبنفس الحدّة، وعدم التحدث عن قضايا العالم، وهو تكريس للبيئة، أو الفكرة المكارثيّة التي من المتوقّع أن تشتدّ مع ترامب.
والشيء بالشيء يذكر، والوضع عندنا في إسرائيل لا يختلف كثيرًا، وهو ما أشارت إليه بضوء أحمر خطير حوادث ومعطيات وتشريعات عدة، منها ما نشرته السّلطة القطريّة للقياس والتقييم في التعليم (راما)، حول مستوى اللغة العبريّة لدى الطلاب الناطقين بالعربيّة في الصفّ السادس عام 2023 ، والانخفاض الحادّ فيها؟ـ والأهم من ذلك مواقف الطلاب ومعلّمي اللغة العبريّة بكل ما يتعلّق بدراسة اللغة العبريّة واستخدامها،
والعلاقة بين الإنجازات والمواقف، وهي علاقات تتسم بالتعقيد وتحمل في طيّاتها معاني وأبعاد كثيرة لا تنحصر في جوانبها التعليميّة، بل تتعداها وصولًا إلى تعقيدات علاقة المواطنين العرب والدولة وخاصّة في السنوات الأخيرة، وتحديدًا في العامين الأخيرين وقبلها منذ العام 2018 وقانون القوميّة وغيره،
بل تصل حدّ التفكير فيما إذا كانت توجّهات وسياسات وزارات التربية المتعاقبة في إسرائيل منذ قيامها وخاصّة تلك المتعلّقة بتدريس اللغة العربيّة في المدارس اليهوديّة والعبريّة في المدارس العربيّة ليس كمادة تدريسيّة جافّة بحثًا عن علامات وشهادات، بل وسيلة لتعزيز العيش المشترك والاحترام المتبادل بين المواطنين العرب واليهود، وكسر التفكير النمطيّ والمواقف والآراء المسبقة،
مع الإشارة هنا إلى أن النتائج تؤكد حصول انخفاض حادّ في تحصيل الطلاب الناطقين بالعربيّة في الصفّ السادس في اللغة العبريّة عام 2023 مقارنة بمستوى نتائج وتحصيل الطلاب الذي بدأ عنده القياس والتقييم في عام 2022، وعليه على المسؤولين في المجتمعين العربيّ واليهوديّ عدم إبقائه في الحيز التعليميّ والمدرسيّ الضيّق، أو داخل جدران المؤسّسات التعليميّة، بل يجب دراسة كافّة أبعاده وجوانبه وهي تتعلّق، وهكذا يجب أن يراها كل من في رأسه عينان، بالعيش المشترك والشعور بالانتماء المدنيّ وضرورة وضع مناهج دراسيّة واعية ومدركة،
تعرف أن العالم أصبح قرية صغيرة، وأن المواطنين العرب لا يمكن إبقاؤهم بمعزل عن العالم خاصّة وأن التطوّر التكنولوجيّ، ووسائل التواصل الاجتماعيّ خلقت تواصلًا بينهم وبين نظرائهم العرب في العالم بلغتين هما العربيّة لغة الأم، أو الإنجليزيّة اللغة العالميّة التي تفتح العالم أمامهم، خاصة انهم يشكّكون اليوم وجراء تشريعات وسياسات وتوجّهات حكوميّة ورسميّة، إضافة إلى ما سبق من عناصر تقنية وتكنولوجيّة ، في مدى صحّة الطروحات التي تبنتها أجيال سابقة من المواطنين العرب من أن دراسة اللغة العبريّة وإجادتها هي شرط أساسيّ للتقدّم الوظيفيّ وفتح آفاق العمل، وليت هذا فحسب، فإن التراجع في مستوى دراسة وإجادة اللغة العبريّة واعتبارها في أوساط طلابيّة كثيرة في المجتمع العربيّ لغة ثالثة بعد الإنجليزية، يحمل في طيّاته وعلى المدى البعيد آثارًا وتأثيرات سلبية للغاية ،
تكمن خطورتها في أنها الطريق إلى الجهل بثقافة الأغلبيّة اليهوديّة، وعدم فهم الأمور والتفاصيل الدقيقة المتعلّقة بعادات وتقاليد وحياة الأغلبيّة اليهوديّة، وهذا الفهم هو الوسيلة الوحيدة للتفاهم والعيش المشترك عبر فهم حضاريّ وثقافيّ متبادل يكسر الحواجز، ويقرّب القلوب في أحسن الأحوال، أو يخفف من مشاعر العداء والشك في أسوأ حال، ما يعني إقصاءً متبادلًا،
وهنا الخطر وأقصد أن على المسؤولين في جهاز التعليم وفي مقدّمتهم الحكومة الحاليّة خاصّة ومن سبقتها من حكومات الاستفاقة وفهم الحقيقة الناصعة من أن اللغة وتدريسها لا ينحصر في أبعادها الثلاثة القراءة والكتابة والتكلّم، أي بمعناها الميكانيكيّ الجافّ، بل إنه تدريس يشمل أبعادًا حضاريّة وثقافيّة وتوعويّة وإدراكيّة، وكم بالحري في حالة النزاع التي تعيشها دولة إسرائيل، والتي تشكّل اللغة لو كان في رؤوس المسؤولين عقول ولو كان فيهم الوعي والإدراك والفهم الكافيين بعيدًا عن الاعتبارات الضيّقة والرؤية للمدى القصير فقط ،
وسيلة للتقارب والتعايش والعيش المشترك، وليس فقط وسيلة لفهم حديث الشعب الآخر، لأغراض مختصرة ومحدودة، وبالتالي كان المطلوب استخدام اللغة وسيلة لكسر الحواجز عبر تدريس اللغة العربيّة بشكل إلزاميّ في كافّة المدارس اليهوديّة، وعدم الاكتفاء بتدريس اللغة العبريّة في المدارس العربيّة، وبوسائل ومناهج ومضامين تجانب الحقيقة وتحول دون تحقيق الأهداف التي يوفّرها تدريس اللغات، بل تختصرها وتختزلها في جوانبها المدرسيّة الضيّقة،
في خطوة تهدف إلى ضمان نوع من السيطرة عبر إغلاق الباب أمام أيّ إمكانيّات لحوار مفتوح حول مركّبات اللغة وأبعادها الحضاريّة والثقافيّة، في توجّه يشكّل النقيض حتى لما نصّت عليه أهداف التعليم الرسميّة في إسرائيل، ومنها التربية على كون إسرائيل دولة يهوديّة وديمقراطيّة، وتنمية علاقات الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة والقيم الديمقراطيّة واحترام ثقافة واتجاهات الآخر والتربية للسعي إلى السلام والتسامح، والتعرّف على اللغة والثقافة والتاريخ والتراث والتقاليد الفريدة للسكان العرب وجماعات سكانيّة أخرى في دولة إسرائيل والاعتراف بالحقوق المتساوية لكل أطياف المجتمع في إسرائيل.
هذا هو المنشود، لكن الموجود يختلف كثيرًا، لتبقى هذه الأهداف حبرًا على ورق بحكم محاولات تشبه محاولات ترامب التي ذكرتها في البداية، السيطرة على جهاز التعليم في المدارس والجامعات والسيطرة على العقول، عبر تشريعات منها على سبيل المثال لا الحصر مشروع قانون جديد للجنة التربية في الكنيست الإسرائيليّ، هدفه الحقيقيّ التضييق على المعلمين العرب، وفرض الرقابة عليهم ومنعهم من القيام بمهامّهم في التربية واقتصارها على التعليم،
وإحكام السيطرة على جهاز التربية والتعليم العربيّ عبر الادّعاء بأنه يودّ مكافحة الإرهاب، وينصّ القانون الجديد على منح السياسيّين، أي الوزير ومسؤولي وزارته صلاحية فصل أيّ معلم عربيّ من جهاز التربية والتعليم، إذا ثبت أنه يؤيّد الإرهاب، أو يؤيّد النضال المسلّح، كما يمنح القانون الجديد الوزارة إمكانيّة منع تحويل ميزانيّة، لأيّ مؤسّسة تعليميّة أهليّة وفقًا لرأي وزير التربية إذا ثبت أن طاقم المدرسة يتماهى مع "منظمة إرهابيّة" أو "عمل إرهابيّ"،
دون شرح ذلك، ودون أي تفصيل ودون أي استشارة قضائيّة، والخطر هنا كما في حالة ترامب والحرمان من الميزانيّات، بسبب معادة الساميّة، هو أن المبادرين يريدون عمدًا إبقاء التفسير فضفاضًا كوسيلة للسيطرة وفرض الأجندات السياسيّة، خاصّة وأن مصطلح "الإرهاب" يمكن أن يشمل الدعوة لوقف حرب،
أو حلّ سلمي وكذلك مواقف إنسانيّة ترفض المساس في المدنيين، مع الإشارة خاصّة إلى أن بند الحرمان من الميزانيات يهدف للضغط على المؤسّسات والتحكم في العمليّة التربويّة، ومحاولة لكمّ الأفواه في مسعى لإحكام سيطرة على مؤسّسات التعليم، ومنع حرية الرأي والتعبير .
صحيح أن ما يحدث اليوم ليس جديدًا، وأقصد محاولات الحكومات في الدول والتي تتشدق بالديمقراطيّة وبالليبراليّة، ومعها محاولات أصحاب رؤوس الأموال السيطرة على الجامعات والمؤسّسات البحثيّة، كما حدث عبر قرارات لمموّلين أميركيّين من أصول يهوديّة وقف تمويل جامعات أميركيّة بسبب مواقف محاضريها وطلابها من الحرب في غزة، ومنهم المليارديران روبرت كرافت وليئون كوبرمان، ومقابلهم المبالغ الطائلة بل الخياليّة التي تدفقت من دولة قطر نحو الجامعات الأميركيّة وليست العربيّة في العقود الأخيرة والتي بلغت 13 مليار دولار من أصل 55 مليار دولار مجمل الدعم للجامعات الأميركيّة، وهي مبالغ اعتبرها الكثيرون محاولة لتبييض سمعة قطر على ضوء دعمها للحركات المسلّحة والمتديّنة ومنها "حماس" في المنطقة واستضافتها قادتها في الدوحة، كما اعتبرها الجمهوريّون والمحافظون محاولة لفرض وتكريس المواقف الماركسيّة واليساريّة والتقدميّة، بمعنى فرض توجّهات ما دون الأخرى، لكنها محاولات تؤكّد التراجع الخطير في القيم اللبراليّة والديمقراطيّة، وإصرار القيادات السياسيّة على تكريس مواقفها وتطويع كافّة المؤسّسات لخدمتها بدء بالجامعات مرورًا بالجهاز القضائيّ وانتهاءً بتدجين المواطنين، والسيطرة عليهم وهي محاولات كان الباحث اليهوديّ من أصل يهودي إسرائيليّ نوعم حومسكي(تشومسكي كما يلفظ الأميركيّون اسمه) قد تنبّأ بها عام 1979، قائلا إنها استراتيجيّات ينفّذها ويتبنّاها أصحاب النُّفوذ العالميّ من سياسيّين وأصحاب رؤوس أموال، كشفتها وثيقة عام 1986 عنوانها" الأسلحة الصامِتة لِخَوْض حرب هادِئَة" تهدف الى السيطرة على عقول ومُقَدَّرات وأموال الشعوب والسيطرة على سلوكهم أفعالهم، بل تفكيرهم ومواقفهم ومدى تفكيرهم وتدجينهم للقبول اليوم بما رفضوه قبل سنوات قليلة، وذلك باتّباع خطوات تتبع سياسة التدرج، ومن هذه الاستراتيجيّات، بل ربما أوّلها نشر الجهل ( وربما التجهيل المقصود) وإِضْعاف التعليم وتوسيع الفجوة بين الطبقات بمعنى جعل التعليم الحقيقيّ والذي يتمتع بالمصداقيّة والانفتاح وحريّة التفكير حكرًا على الأغنياء وطبقات معيّنة لها مواقفها الواضحة، وإثارة عواطف الشعوب أكثر من عقولهم ، وادعاء الحكومات أن كافّة خطواتها وقراراتها تنبثق عن أنها تريد مصلحة الجمهور التي تعرفها هي أكثر من الجمهور نفسه، أي اقناع العامّة أن النخبة السياسيّة والدينيّة أدرى منها بمصلحتها، والعمل على إبقائها على هذا النحو ممّا يمكن النخبة من قيادة العامّة، دون معارضة وقبول العامة بالانقياد طَواعية ، إضافة إلى إغراق العامّة بالترف واللهو، واختلاق الأزمات ومن ثم تقديم الحلول لها. وهي حلول وضعت مسبقًا للسيطرة على فكر الشعوب وحرمانها من معظم حقوقها، وفي النهاية دفع المواطن إلى الاعتقاد بأنه هو المسؤول الأول والأخير عن فشله وسوء حاله، والدليل محاولة اتهام المواطنين العرب بالمسؤوليّة التامّة والكاملة عن حالات العنف وتحميلهم مسؤوليّة مواجهتها وحدهم، دون وجود خطّة حكوميّة واضحة، وربما دون وجود إرادة حكوميّة واضحة وحقيقيّة لأسباب سياسيّة وحزبيّة هدفها النهائيّ السيطرة .
أوضاع التعليم التي لا ترضي سببها واحد وهو غياب الإرادة السياسيّة، فالسلطات والحكومات تكتفي وللأسف برسم الخطط ووضع السياسات، لكنها تبقى حبرًا على ورق يتم تغييرها صباح مساء، دون تفكير بعيد المدي يهتم بالنتائج التعليميّة، بل وفق اعتبارات سياسيّة ضيّقة ، وعبر مسؤولين ينادون علنًا بالإصلاح التربويّ، لكنهم يتمسّكون بمناهج قديمة ساعات عمل مرهقة للطالب والمعلم، وتدمير القيمة التربويّة والتثقيفيّة للمعلّم والانتقاص من مكانته ودوره وتجريده من صناعة القرار، وتغليب المصلحة الحزبيّة والطائفيّة والقبليّة عند اختيار القيادات التربويّة على المصلحة العامّة، ومحاولات السيطرة على المؤسّسات التربويّة كالمدارس، ومن ثمّ الجامعات ومعاهد الأبحاث، بكل ما يحمله ذلك من أبعاد خطيرة، يبدو أنها لا تهم صناع القرار فهم ينظرون إلى يومهم فقط دون غدهم، أما من سيدفع الثمن فهي الأجيال القادمة، وكأني بقيادات العالم اليوم تصرّ على إثبات صحة القول الشهير لبرتراند راسل الفيلسوف وعالم المنطق والرياضيّ والمؤرخ والناقد الاجتماعيّ:"لا يولد البشر أغبياء بل جهلة، ثم يجعلهم التعليم أغبياء" وربما الأصحّ أن السياسيين والقادة يجعلونهم أغبياء لا يفقهون حقوقهم، وفي هذا ضمان للسيطرة على الشعوب وإقناعها أن السياسات مقدّسة، رغم أنها تعمل على تجهيلهم وإخضاعهم لهوائها، وربما اعتبار السياسيّين مقدّسين، وعن هذا يقول راسل:" يمكن أن تكون المجتمعات جاهلة ومتخلفة، والخطر أن ترى جهلها مقدسًا"، ويبدو أن مجتمعات كثيرة في العالم تقترب طواعية من ذلك.