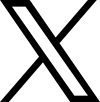المجتمعات الطامحة إلى الحياة يقودها الكرام والشرفاء
بينما يقترب القرن الحادي والعشرين من نهاية ربعه الأوّل مختتمًا بذلك سنوات لم يشهد فيها الهدوء المرجو والمطلوب، بخلاف التوقّعات الورديّة، وليس ذلك فحسب، بل تراجعت فيه الديمقراطيّة في الدول التي اعتدنا تصنيفها بحكم نظريّات ومفاهيم بدأتها الثورة الفرنسيّة

والتي اعتبرها كثيرون أنها وضعت مبادئ الدولة الحديثة وأسس الديمقراطيّة التي قال عنها جان جاك روسو أن رصيدها الحقيقيّ لا ينحصر في صناديق الانتخابات فحسب، بل في وعي الناس، قاصدًا بذلك فكرهم وحياتهم وممارساتهم وحقوقهم ورفاهيتهم.
وهي مفاهيم عزّزتها مجريات القرن العشرين بحروبها التي كان مسبّبها دول دأبت السلطة فيها على إقامة مؤسّسات أُنشئت لاستغلال الجماهير، سواء كانت أمنيّة أو اقتصاديّة، أو سياسيّة كسياسة الحزب الواحد في ألمانيا وروسيا وغيرها.
وهي توجّهات اتّضح أنها صاحبة تأثير سيّئ على صعيد النمو الاقتصاديّ بعيد المدى، وكذلك رفاهية الفرد وحريّاته، إضافة إلى فشل محاولات إدخال الديمقراطيّة إلى بعض الدول، وخاصّة الدول العربيّة والأفريقيّة. وهي محاولات مني معظمها بالفشل في أحسن الحالات، وكانت نتائجه كارثيّة في حالات أخرى ما يؤكّد التصريح الذي أدلى به مؤخّرًا الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد للعام 2024،
البروفيسور التركي عجم أوغلو المحاضر في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا، الذي فاز بالجائزة مع زميليه البريطانيين سايمون جونسون وجيمس روبنسون، إذ قال إن الديمقراطيّة ليست علاجًا لكلّ داء، وإن إدخال الديمقراطيّة أمر صعب للغاية، تعود إلى الواجهة أسئلة عديدة ومتنوّعة تشكّل في معظمها التعبير الحقيقيّ عن النتائج،
أو الاستنتاجات المؤلمة لما آلت إليه أوضاع الدول المختلفة في العالم، خاصّة بعد أن اتضح للجميع أن النظريات التي كانت في صلب محاولات العلماء والباحثين، في تكوين الدولة الحديثة والثابتة والمستقرّة قد اتضحت هشاشتها وبساطتها، أو ربما سذاجة أولئك الذين وضعوها متيقّنين من أن الديمقراطيّة هي الحلّ لجميع المشاكل، وفي جميع الدول وبين كافّة الشعوب والديانات والمجموعات، وأن تطبيق الديمقراطيّة يمكن أن يأتي بقرار من أعلى حتى لو كانت البنية الاجتماعيّة والتركيبة السكانيّة غير جاهزة لذلك.
وهو ما حصل في مصر تحديدًا بعد الضغوط الأمريكيّة خاصّة من رئيسها في حينه باراك أوباما، وتنحي الرئيس محمد حسني مبارك، وإجراء الانتخابات التي أسفرت عن فوز الإخوان المسلمين وانتخاب الرئيس محمد مرسي، وما تلاها وكذلك الانتخابات في تونس، وأن الدولة الحديثة تقام على ثلاثة أسس تكون مجتمعةً كفيلة بضمان أمنها واستقرارها ورفاهية شعبها وحريّته ومساواته تشكّل مقوّمات أساسيّة لوجودها؛ وهي السكان( مجموعة سكانيّة واحدة)، والحيّز الجغرافيّ ( المكان) والسلطة التي تحدّدها السيادة .
الأسئلة حول صحّة هذه النظريّات لا تنحصر في السؤال حول ما إذا كان وجود مجموعة سكانيّة واحدة يقود إلى بناء دولة حديثة ومستقرّة أم لا، بل إن هناك حاجة إلى مزيد من النظر بتعمّق إلى تركيبة تلك المجموعة ومدى قابليّتها لتذويت مبادئ الدولة الحديثة والديمقراطيّة التي تتميّز بالحريّة والعلمانيّة والانفتاح والفصل بين الدين والدولة على ضوء ما اتّضح من أن العلاقة بين الدين، أو التطرّف الدينيّ وبين الديمقراطيّة والحريّات الشخصيّة، وخاصّة حريّات الأقليّات الدينيّة والعرقيّة والمرأة،
هي علاقة عكسيّة دائمًا، بل تتعدّى ذلك إلى السؤال حول ترتيبها من حيث الأهميّة، خاصّة مع وضع السلطة، أو نوعيّتها ونهجها وتصرّفاتها في المكان الثالث هنا، لكن السؤال الأهمّ هنا، وبغضّ النظر عمّا إذا كانت السلطة هي العامل الثالث أو الأول، لا يتطرّق الى شكل السلطة ليبرالية او ديمقراطية بل الى توجهاتها الداخلية وسياساتها المتعلقة ببناء المؤسّسات ومنحها الاستقلاليّة إضافة إلى توزيع الثروات،
أو العمل على ضمان أكبر قدر من المساواة، أو العمل على تقليص الفوارق الاقتصاديّة والطبقيّة عبر بناء مؤسّسات سياسيّة بمعناها الواسع، وليس الضيّق كأحزاب، أو حكومة، أو ائتلاف ما، ومؤسّسات اقتصاديّة واجتماعيّة وقضائيّة، وأخرى تضمن الحقوق والرفاهية، بمعنى أن الديمقراطيّة لا تكفي إذا لم ترافقها سياسات تطمح إلى المساواة، وبناء المؤسّسات ومنع أية تشريعات تقلّل من استقلاليّة ومتانة مؤسّسات المجتمع سواء كانت حكوميّة، أو مدنية وغيرها، وإلى كل ذلك أضيف هنا السؤال الهامّ في نظري حول من يبني من، أي هل أبناء المجتمع الحديث هو الضمان لبناء دولة حديثة، وليست الدولة الحديثة هي من تبني مجتمعا حديثًا.
وهو سؤال هامّ مردّه الحقائق التاريخيّة التي تؤكّد أن السياسيّين والقادة يميلون في حالات تعذّر فيها عليهم تحديث مجتمعهم وبلادهم، إلى التخلّي سريعًا عن محاولات التغيير وتحسين الحال، والعودة إلى مربّعات ضيّقة وشخصيّة، أو ذاتيّة تنحصر في مربع السلطة والبحث عن السيطرة من أعلى لا من أسفل، أي ضمان السلطة بدل الاهتمام برفاهية المواطنين، وهذا ما أفقد الأحزاب أيديولوجيّاتها وبرامجها الانتخابيّة، وجعلها تتمحور حول الشخوص والأشخاص،
وضرورة الحفاظ على السلطة، أو على الأقلّ بذل كلّ مستطاع لمنع الغير من توليها، والانتخابات المتكررة في إسرائيل، وتلك التي جرت قبل ثلاثة أيام للرئاسة الأمريكيّة خير دليل فهي تتركز حول سلبيّات الغير، والأسباب التي يجب أن تحول دون تأييده وليس إيجابيات الأنا وأحقيتي بالسلطة، ما يشكّل الاعتراف الضمنيّ من معظم الأحزاب في الدول الليبراليّة بأنها لا تملك مشروعًا واضحًا وقابلًا للتحقيق،
وأنها تنازلت عن محاولاتها لتغييرالمجتمع عبر الإقناع والترغيب، بل تفعل ذلك عبر الترهيب، دون اكتراث لرفاهية مواطنيها الذين يتنازلون طوعًا عن حقوقهم ورفاهيتهم مقابل سلطة ترضي ميولهم السياسيّة فقط. وهو تراجع خطير ومقلق يفسّر ربما تراجع الديمقراطيّة في دول أوروبا ومحاولات إضعاف الجهاز القضائيّ في إسرائيل،
عبر قوانين تحدّ من حريّات الأقليّات، وتمنح الحكومة سلطات تبدو غير محدودة، دون أن تلزمها بأيّ عمل لرفاهية المواطن، وتعيق الاستثمارات وتوقف عجلة التقدّم الاقتصاديّ والبحث العلميّ، وتثير في نفوس المواطنين مشاعر عدم الرضى بل الخوف والقنوط، وهو ما أكّدته المعلومات التي تم الكشف عنها حول ميزانيّة إسرائيل للعام 2025، وتقليصات ميزانيّات الرفاه الاجتماعيّ، وزيادة الضرائب على المواطنين،
وتجميد مشاريع البنى التحتيّة حتى الضروريّة منها، وخطوات أخرى تمسّ برفاهية الفئات الضعيفة، وتزيد من اتّساع الفجوات بين الطبقات ما يجعل جسرها مستحيلًا.
أقول هذا خاصّة على ضوء ما كنت قد أشرت إليه من منح جائزة نوبل للاقتصاد للعام الحاليّ 2024 للعلماء الثلاثة، البروفيسور التركي عجم أوغلو والبريطانيّين سايمون جونسون وجيمس روبنسون، تقديرًا لأبحاثهم التي تطرّقت إلى ما سبق، والتي بحثت عمليًّا العلاقة بين بناء المؤسّسات بمعناها الواسع الذي يشمل السياسات وتوزيع الموارد والثروات،
والعمل لتحقيق المساواة وتوفير مقوّمات الحياة الكريمة والعمل والتعليم على رفاهية المواطن ومصلحتها، كما جاء في قرار لجنة جائزة نوبل لدراساتهم حول كيفيّة تشكيل المؤسّسات وتأثيرها على الازدهار، وبكلمات أبسط تؤكّد اللجنة أن أبحاث الثلاثة تؤكّد أن بناء الدولة ومنح مواطنيها حريّة التصويت والترشّح وحتى فصل السلطات، كما يتم في معظم الدول الليبراليّة والديمقراطيّة التي تدعي ذلك، وبرغم أنه شرط لإقامة،
أو وجود الدولة كإطار جامع حتى لو توفّر إلى جانبه شرطان إضافيّان هما السكان والمكان، لا يكفي لضمان الازدهار الاقتصاديّ والنمو والرفاهية للمواطنين، كما أنه ونتيجة ذلك لا يضمن الازدهار والرفاهية السياسيّة والاجتماعيّة والفكريّة،
بل إن الأهمّ هو بناء المؤسّسات بشكل صحيح ومستقلّ ونافع وناجع، وهو ما يسمّيه الثلاثة العلاقة بين المؤسّسات والازدهار. والأمثلة على ذلك كثيرة فدول عديدة ليبراليّة تملك المقوّمات الثلاثة الكيان والمكان والسكان، وتسودها أعراف ديمقراطيّة بما فيها انتخابات برلمانيّة ورئاسيّة، ما زالت غارقة في فخّ النمو الاقتصاديّ المنخفض والرفاهية المعدومة لمواطنيها، وهو ما يعني حرمان المواطنين من الرفاهية والتعليم وفرص العمل،
والنمو الاقتصاديّ والتطوّر الفرديّ رغم تمتعّهم بحريّة التصويت والترشّح، والنماذج عديدة كما قلنا أبرزها الفوارق بين الجارتين الولايات المتحدة والمكسيك عامّة وبشكل خاصّ، وخير مثال تلك المدينة الحدوديّة واسمها نوغاليس، التي تقسمها الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، ويعيش سكانها في الشطر الأميركيّ حياة أفضل من الرفاهية والازدهار والرغبة في العمل والإنتاج والمحفّز على مزيد من التطوّر ، مقارنة بأولئك الموجودين في الجانب المكسيكيّ،
ما يؤكّد أن الفارق الحاسم والعامل الأهمّ لضمان الرفاهية والازدهار والتطوّر ،هو ليس توفّر الكيان والمكان والإنسان، أي السلطة والجغرافيا والمواطنين، بل الطريقة التي تترجم فيها هذه المعطيات إلى عمل على أرض الواقع يشمل بناء المؤسّسات، وضمان استقلاليّتها ونجاعتها، وعدم تحوّلها سواء كانت حكوميّة ورسميّة،
أو مدنيّة إلى وسيلة لضمان المنفعة والمصالح الشخصيّة والفئويّة سياسيّة كانت أو ماليّة، أو وسيلة للسيطرة على الناس، أو صرف انتباههم عن قضاياهم اليوميّة، وهو ما قالت عنه الأكاديمية الملكيّة السويديّة للعلوم إن أبحاثهم تؤكّد أن الفارق الحاسم ليس في الجغرافيا أو الثقافة، بل في المؤسّسات.
قلت في السابق، وأكرّر هنا أن الحاجة الأهمّ هي بناء الإنسان قبل بناء المكان، وهذا القول لا يأتي من فراغ، بل إنه تعبير عن السؤال الذي يشغل بال الباحثين والدارسين، حول العلاقة بين المجتمع الحديث والدولة الحديثة، وهل المجتمع الحديث هو الذي يبني دولة حديثة، أم أن الدولة الحديثة هي من تبني مجتمعا حديثًا. وهل يتمّ البناء من الأعلى ( الدولة) إلى الأدنى ( المجتمع) أم بالعكس.
وهو سؤال هامّ للغاية تتعلّق الإجابة عنه بمدى رغبة السياسيّين في بناء مؤسّسات تضمن الرفاهية والنجاح والاستقرار الاقتصاديّ وبالتالي التطور والتقدم، من عدمه إضافة إلى مدى استعداده لبناء المؤسّسات شكلًا ومضمونًا، ولكن بشكل يضمن سيطرته وبقاءه وديمومة حكمه، كما هو الحال في تعيين قضاة المحكمة العليا في الولايات المتحدة التي توصف بأنها عرش الديمقراطيّة وبلاد الإمكانيّات غير المحدودة، الذين ينتخبهم أو يعينهم الرئيس وفقًا لرغباته واستنادًا إلى مواقفهم،
وذلك لمدى الحياة ما يضمن له شخصيًّا وبعده لمواقفه، أو استعداده لإعادة بناء المؤسّسات، ليضمن بقاءه في السلطة، كما حدث في هنغاريا من حيث سيطرة الحكومة على الجهاز القضائيّ ووسائل الإعلام ، وهو ما شهدته إسرائيل خلال محاولات تنفيذ الانقلاب الدستوريّ. هذا من جانب السياسيّين الذين أعتبروا أنفسهم أسياد الدولة، لكنّ المجتمعات في كثير من الأحيان تكون العقبة حتى لو تمّت الديمقراطية وأقيمت المؤسّسات،
وتحديدًا تلك المجتمعات التي تقبع بسبب بنيتها الاجتماعيّة والثقافيّة في مراحلها الطائفيّة والقبليّة والدينيّة والفئويّة، ما يمكن أن يعيق عمليّة التحديث والديمقراطيّة، وبناء المؤسّسات وما حدث في مصر وتونس هو خير دليل، علمًا أن الأخيرة تشكّل حالة خاصّة تراجع فيها القائد السياسيّ الذي يسعى إلى التحديث عن موقعه هناك، وعاد إلى منشئه كابن لمجتمع تحكمه الحسابات الضيّقة والانتماءات الصغيرة.
وهو ما يمكن القول إنه يصف وضع فئات سكانيّة أخرى في دول ليبراليّة وديمقراطيّة تميل بحكم ثقافتها ومفاهيمها إلى سوء فهم دور المؤسّسات، وأهميّة بنائها بشكل صحيح دون حسابات فئويّة ومشاعر انتقام وإقصاء وكراهية للغير، ومنها اليهود من أصل شرقيّ في إسرائيل الذين يميلون إلى فهم دور المؤسّسات في الدولة اقتصاديّة كانت أم سياسيّة أم قضائيّة، وفق اعتبارات ضيّقة وطائفيّة، ومثلهم المجموعات اليهوديّة الدينيّة المتزمّتة واليمينيّة الاستيطانيّة.
وهو حال الأقليّة العربيّة التي ما زالت، ولأسباب تتعلّق بثقافتها المدنيّة وحسّها المجتمعيّ الديمقراطيّ، وميلها إلى الفئويّة والعشوائيّة والمواقف غير المبنيّة على الحقائق والدراسات، عاجزة عن بناء مؤسّسات سياسيّة،
أي الأحزاب، ومؤسّسات أخرى تضمن صيانة حقوقها، وضمان مصالحها ورفاهيتها العامّة، دون أن تتحوّل إلى وسيلة للسيطرة عليها، وإسكات صوتها لاعتبارات حزبيّة، وموقف المجتمع العربيّ غير المبالي من الانقلاب الدستوريّ خير دليل، على خطورة وقوف المواطن جانبًا إزاء محاولات لبناء مؤسّسات، ولكن بمقاسات تناسب السلطة فقط.
النتائج المأساويّة التي ترزح الدول العربيّة تحت وطأتها جرّاء "الربيع العربي"، تؤكّد أهميّة الدمج بين بناء المؤسّسات وبناء المجتمعات، نحو خلق ممارسة سياسيّة حقيقيّة ومزدهرة تضمن رفاهية المواطن من كافّة نواحيها ،وتضمن من جهة أخرى وجود سلطة تعمل على بناء مؤسّسات لخدمة أهداف ومصالح المواطنين،
وليس للسيطرة عليهم عبر تعيينات وقيود تجعلها مؤسّسات مستقلّة ظاهريًّا وتابعة للسلطة عمليًّا، كما تؤكّد أهميّة فهم المواطن لدور هذه المؤسّسات، واستعداده للدفاع عنها، والعمل من أجلها. ومن هنا ورغم الحديث عن محاولات لزرع الديمقراطيّة ما زالت الأمور تتراجع، وما زالت المؤسسات رهن نزوات السلطة ووسيلة للسيطرة عليها،
وما زال الصراع يتمحور حول شكليّات وجوانب تتعلّق بالمبادئ التقليديّة لإقامة الدولة، ومنها قوانين الانتخاب، بينما ما زالت غالبيّة مؤسّسات المجتمع المدنيّ بمصالح أشخاص، أو أفراد أو طوائف، تعتبر السياسة وسيلة للاستيلاء على السلطة، وليس جهات وأجسام لها فاعلية اجتماعيّة، ما يحول دون خلق حالة وعي قادر على تغيير الحال، خاصّة مع وجود عوائق أمام نشوء مجتمع عربيّ مدنيّ يحقّق التغيير،
في الدول العربيّة والمجتمع العربيّ في إسرائيل على حدّ سواء، لأسباب عديدة منها دور الطائفيّة والفئويّة القديمة الاجتماعيّة والسياسيّة والدينيّة، وتأثيراتها على الحياة السياسيّة والمجتمعيّة، ما يكرِّس غياب الديمقراطيّة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل، وضعف الثقافة الديمقراطيّة، وغيرها.
خلاصة القول أن بناء الدولة الحديثة لا يتم دون بناء مجتمع حديث بالتوازي وبالتناسق التامّ، ومن هنا فإن إقامة الدولة لا تتم بمكانها وسكانها وحكّامها ، بل إن مقوّمات بناء الدولة والمجتمع متشابكة تشمل إقامة مواثيق اجتماعّية تضمن عدم استغلال المؤسّسات للسيطرة،
والسعي إلى امتلاك التقنيات والتعليم ما من شأنه بناء مجتمع تسوده الرفاهية والازدهار، ووجود ضوابط ومعايير ولوائح قوانين تنطبق على المواطن والحاكم بنفس المقدار ، وتعزيز القطاعات الإنتاجيّة ودور مؤسسات المجتمع المدنيّ، وتمويل أو ضمان الخدمات الاجتماعيّة والتعليميّة والمؤسّسات الأكاديميّة القادرة على إنتاج أجيال تحدث التغيير وتنشر العلم والوعي، وتكون وسيلة لذلك، وليس أداة في أيدي السياسيّين، لضمان السيطرة والبقاء في سدّة الحكم، تحسين مستويات التعليم وضمانه حتى سنّ الثامنة عشرة يضمن مستويات أعلى من الرضى عن الحياة والازدهار،
فضلًا عن أنه يعزّز الشعور لدى المواطنين بالقدرة على تغيير مستوياتهم الاقتصاديّة والشعور بجدوى حياتهم، ومن ثمّ ترتفع معدلات الرفاهية. ولعل هذا يقود السياسيّين إلى ضمان أماكن العمل وتوفير الوظائف، وهو ما اتضح أنه يؤثّر على مستويات الرفاهية ، بينما تنخفض مستويات الشعور بالرفاهية عند العاطلين عن العمل،
أو أولئك الذين يشعرون إن المؤسّسات لا تعمل لصالحهم فيبتعدون عن نشاطات المجتمع المدنيّ، وينتظرون تغييرًا سياسيًّا قد لا يأتي، وتخصيص الموارد لاحتياجات المواطنين بعيدًا عن الحرب والدمار. ويكفي الإشارة إلى تعاظم ميزانيات الجيش والحرب في إسرائيل، وكون الولايات المتحدة تنفق نحو مئة مليون دولار كل ساعة على التسلّح، دون أن يفكّر أيّ من قادتها مثلًا بتوجيه قسم من هذه المبالغ لبناء مؤسّسات تضمن الرفاهية،
وتضمن التأمين الصحيّ مثلًا للجميع، لضمان وتطبيق الديمقراطيّة الصحيحة التي تضمن المساواة وتلغي الفوارق ، لكن هذا بحاجة إلى مجتمع لا يقبل الظلم، بل يعي ما له وما عليه، أي مجتمع لائق وصحيّ. وهو ما ينطبق عليه قول تشارلز بيكيرنغ: " تتطلّب الديمقراطيّة الصحيحة مجتمعًا لائقًا، كما أنها تقتضي منّا أن نكون شرفاء وكرماء ومتسامحين ومحترمين"،
بمعنى قبول التعدديّة والاختلاف وتغليب المصلحة العاّمة على الخاصّة، وممارسة نهج إنسانيّ وديمقراطيّ يتّسم بالاحترام بشقّيه؛ احترام الذات ورفض التنازل عن الحقوق، أو تسخيرها لخدمة الغير حتى لو كان ذلك الحزب الحاكم، أو الرئيس، واحترام الغير وضمان دوره وحريّاته والعمل معًا على بناء مؤسّسات صحيحة تخدم الجميع، وتضمن الحرية والكرامة للجميع حتى لا يكون مصيرها سوء التصرف وسوء الحال، كما قال ابن خلدون من أن الشعوب المقهورة تسوء أخلاقها.
ويظهر جليًّا في أيامنا هذه بأن نمو القوى الماديّة والسلطويّة أسهل بكثير من نمو الإنسانيّة بين البشر والارتفاع إلى النجوم في السماء أسهل بكثير من ارتفاع الإنسان بأخلاقه ولو درجة واحدة . وكم بالحري بأننا نرى قوة المادّة وعجزها في عدم تحقيق السعادة للإنسان الثري بالمال فقط .