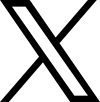الدول العربيّة بين الحاكم المستبدّ والمواطن الذي لا يفهم الحريّة انهيار النظام السوريّ
تشكّل الحالة السوريّة، ربما أكثر من غيرها، أو يجب أن تشكل، وتحديدًا ذلك الانهيار المفاجئ والسريع ،خلال 11 يومًا فقط، لنظام حكم عائلة الأسد ومعه دولة سوريا، وتحديدًا بشار الأسد، والذي أصبح حقيقة واقعة قبل أسبوع بالتمام والكمال, في الثامن من كانون الأول 2024.

بعد أن صمد بدعم من قوى خارجيّة في مقدّمتها موسكو وطهران، وبعدها شرعيّة مستعادة من دول عربيّة كانت ضد بشار الأسد ومع المتمرّدين ما لبثت أن احتضنت بشار مرة أخرى، والسماح بمشاركته في مؤتمر القمّة العربيّة، مصدرًا ولو لمرة واحدة لمراجعة حقيقيّة للحسابات وبحث حقيقيّ ومتعمّق عن الأسباب والمسبّبات، بعيدًا عن الاكتفاء بالمظاهر والأمور العاديّة،
أو تلك اليوميّة التي تشغل منذ الأسبوع الماضي صفحات الصحف ونشرات الأخبار ومواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعيّ، وكلها أمور يسود الاتفاق حولها باعتبارها ظاهرة وبارزة ومكشوفة، ملخّصها أنه انهيار ينهي 14 عام تقريبًا من الحرب الأهليّة ومحاولات تنحية بشار الأسد عن منصبه، عبر حرب أهليّة حصدت أرواح مئات الآلاف ونزح بسببها نصف السكان، وتوزّعت الملايين من أبناء الشعب السوريّ لاجئة في دول الجوار والعالم،
وانهيار الاقتصاد السوريّ، وساد الفقر أكثر من ثلثي المواطنين. ورغم ذلك أصر على البقاء في منصبه رئيسًا يتحدّث إلى شعبه من على المنابر ناسيًا، أو متناسيًا، أو غير مهتم، وهذا ربما الأصحّ، بترحيل الملايين وملء السجون بالمعتقلين السياسيّين وتعذيبهم، واتّساع رقعة المقابر في بلاده لتتّسع لكل الأموات والضحايا لتعذيب السجون والحرب الأهليّة، إضافة إلى الاتفاق على أن هذا الانهيارلا يشكّل فقط نهاية حكم الأسد، بل نهاية حقبة تاريخيّة كانت سوريا فيها معقلًا لإيران وروسيا تمارسان من خلاله نفوذهما في العالم العربيّ، بل ربما حقبة كانت موسكو وطهران الحاكم الفعليّ لدمشق،
التي حوّلت بالنسبة لروسيا إلى موطئ قدم على البحر المتوسط عبر تواجد دائم للأسطول الروسيّ في ميناء اللاذقيّة، و كانت منفذًا تنقل منه طهران أسلحتها وخبراءها العسكريّين إلى حليفتها، بل صنيعتها في لبنان حركة" حزب الله" ، ونهاية لما اتُفق على تسميته "محور الممانعة"، أو المقاومة.
وهي تسمية جانبت الحقيقة فهو محور سيطرة إيران على الشرق الأوسط، أو محاولة ذلك عملًا بمبدأ نشر ولاية الفقيه والثورة الخمينيّة. وهو محور بعد الضربات التي تلقاها "حزب الله" وإيران وانهيار نظام الأسد،
لم يعد فيه سوى ما فعلته "حماس" من تدمير لغزة ولمليوني مواطن الذين أصبحوا لاجئين في أرضهم وبيتهم، والتي سنعود لاحقًا إلى دورها، أو مسؤوليّتها عمّا حدث وتحريك الحوثيّين في اليمن، خاصّة وأن إيران أبعد ما تكون اليوم عن أي محاولة لمواجهة إسرائيل، وهي الرابح الكبير في هذا المقام، عبر مجريات كان بعضها رمية من غير رامٍ، أو ربما كما يقول البعض،
نتيجة طبيعيّة ومتوقعة لتصرّفات غير محسوبة العواقب أولها الهجوم المسلّح لحركة "حماس" في السابع من أكتوبر عام 2023، واستمرارها "مساندة" حركة "حزب الله" وتكثيف طهران نقل الأسلحة إليه، لتحقيق هدف تلك المساندة، وكل ذلك عبر الأراضي السوريّة المكشوفة جوًّا والتي يحلّق فيها الطيران الإسرائيليّ كيفما ومتى وأينما شاء، تمامًا كأجواء لبنان وطهران واليمن وغيرها.
هذه التطوّرات وما سيليها كما يستشفّ من تصريحات زعيم هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني، أمام حشد كبير في المسجد الأمويّ التاريخيّ والمعروف في دمشق: حين أكد أنه "تتم اليوم كتابة تاريخ جديد يا إخواني في المنطقة كلّها بعد هذا النصر العظيم”، وإشارته إلى سوريا الجديدة وفق تصريحاته، أو تلك التي يريدها، وهي بكلماته هو نفسه:" سوريا الجديدة التي ستكون منارة للأمة الإسلاميّة” .
وهو ما قال عنه أنه سيتطلّب عملًا شاقًا وتصريحاته اللاحقة خاصّة بعد تشكيل الحكومة المرحلة، دون الإعلان مسبقًا، أو التلميح حتى إلى موعد مقترح، أو متوقّع، أو منشود لانتخابات حرّة وحقيقيّة بعد 54 عامًا من الانتخابات ديمقراطيّة الشكل دكتاتوريّة الجوهر،
ونقل السلطة من الأب إلى الابن عبر تعديلات للدستور، تمّ تفصيلها على مقاس بشار، الذي بلغ من العمر 34 عامًا حين تولى الرئاسة بدلًا من 40 كما نصّ الدستور السوريّ، وهو ليس حالة خاصّة فقد فاقه في ذلك تعديل الدستور المصريّ، ليتمكن الرئيس المصري الحالي عبد الفتَّاح السيسي من تولي الرئاسة حتى العام 2034 وبشكل "ديمقراطيّ"، أو غير ذلك من خطوات، تستوجب الشجاعة في طرح أسئلة عديدة،
إذا ما أردنا بالدول العربيّة كلها خيرًا، يمكنني إيجازها في ثلاثة، أولها السبب غير الواضح لي على الأقلّ، في التصاق الزعماء العرب بالسلطة ورفض الاعتراف بأن عهدهم قد انتهى، ليتم الإطاحة بهم، أو قتلهم، أو اعتقالهم أو غير ذلك، كما حدث في العراق ومصر وتونس وليبيا واليوم في سوريا وغيرها، وثانيها تكرار محاولات الحركات المسلّحة المتديّنة السيطرة على دول، أو تكريس مواقفها وأجنداتها كوسيلة للحكم، رغم الفشل الذي منيت به في معظم تلك المناطق والدول بدءًا بالإخوان المسلمين في مصر وحزب النهضة في تونس، ومحاولات" داعش" في سوريا والعراق والحوثيّين في اليمن والثورة الخمينيّة في إيران، وحتى حزب العدالة والتنمية في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، والذي تأسّس عام 2001 بعد انشقاق مؤسّسيه عن حزب الفضيلة، ليصل بعد ذلك إلى سدة ألحكم في البلاد عام 2002، ويرفع شعار تركيا الجديدة( على وزن سوريا الجديدة من تصريحات أبو محمد الجولاني سابقة الذكر)، ويتبنّى نهجًا اقتصاديًّا ليبراليًّا، كما يوصف بأنه محافظ اجتماعيًّا،
ويقول البعض إنه حقّق بزعامة رجب طيب أردوغان شهرة إقليميّة وعالميّة بفضل نجاحاته السياسيّة والاقتصاديّة الكبيرة التي جعلت تركيا في مصاف الدول المتقدّمة، وكم بالحري حركة "حماس" في غزّة خاصة والمناطق الفلسطينيّة عامّة وهي الابنة الشرعيّة لحركة " الإخوان المسلمين" ، وما آلت اليه أحوال قطاع غزة منذ سيطرتها عليه عام 2007 وتحديدًا، بل بشكل مأساويّ وخطير، ما أصبح عليه الحال بعد السابع من أكتوبر 2023،
وثالثها، عدم استخلاص الشعوب للعبر التاريخيّة، وعدم تذويتها للعبر التاريخيّة من تكرار التجارب نفسها وانتظار نتيجة مغايرة، بل الاكتفاء بالنظر إلى التاريخ على أنه تسلسل للأحداث فقط دون عبرة أيًّا كانت، ما يفسّر تكرار قول كارل ماركس من " أن التاريخ يعيد نفسه مرتين، المرة الأولى كمأساة والثانية كمهزلة"، وأقصد هنا التصفيق والترحيب والاحتضان لتلك الحركات التي ترفع راية الدين، وتستغلّها لضمان الاستيلاء على الحكم وقمع الشعب وحرمانه من أبسط الحقوق، حتى لو كان مسلمًا، وكم بالحري من ديانة أخرى أو طائفة أخرى، فالشعوب العربيّة رحّبت بالإخوان المسلمين في مصر وقبلها في تركيا وبعدها تونس ومعها العراق والجزائر ولبنان.، في تكرار لنفس النتيجة، وهي الانتقال من سيىء إلى أسوأ، وكان الخيار أمام الشعوب العربيّة هو بين السيىء والأكثر سوءًا وليس البحث عن الأفضل والسعي إليه.
التصاق الحكام العرب بالكرسيّ هو أول الأسئلة، وإن كان قد برز أكثر في القرنين الحالي والماضي، خاصّة على ضوء ظهور الدول الليبراليّة والديمقراطيّة التي تشهد انتخابات دوريّة ويتم فيها، بقرار من الشعب استبدال الحاكم أو إبقائه، إلا أنها ظاهرة ليست جديدة، لكن المقلق هو استمرارها وقبولها، أو التسليم بها. فهي ظاهرة تشكّل جزءًا من ذلك الإرث الثقيل الذي تركته السلطويّة، أو مركزيّة وأحادية السلطة في كافّة مراحل التاريخ العربيّ، ويبدو أن جذورها الممتدّة مئات السنوات إلى الوراء جعلتها أيضًا وللأسف جزءًا، أو مركّبًا عاديًّا في الثقافة والتكوين النفسيّ والعقليّ والعاطفيّ للحاكم ، ومقبولة لدى المحكوم، ومن هنا أصبح انفصال الحاكم عن كرسيه حالة غيرقائمة،
يرفضها الحكام مهما كلّف الأمر شعوبهم من ذلك. وهي حالة لم ينج منها أحد من الحكام العرب، في عالمنا المعاصر، بل إن القاسم المشترك الوحيد أحيانًا بينهم كان الخوف من فقدان السلطة والتنحي على المنصب ، وهو هاجس يسيطر عليهم طيلة فترة حكمهم، وفي حالات السلم والحرب على حدّ سواء، فاتخذوا كافّة الخطوات لضمان البقاء، ولو كلف ذلك تغيير الدساتير، وشراء الذمم وقمع الشعوب بأقسى الوسائل وأفظعها، والشهادات من السجون في الدول العربيّة كلّها دون استثناء وآخرها الشهادات من سجني صيدنايا والمزِّة السوريّين أفضل دليل، ناهيك عن تحويل الانتخابات إلى مسرحيّة، أو مهزلة، أو القبول بإجرائها بشكل ديمقراطيّ ثم الانقلاب عليها كما في حالة قيس بن سعيد الرئيس التونسيّ الذي وصل الحكم بانتخابات ديمقراطيّة ما لبث أن غيَّر كافّة قواعد اللعبة السياسيّة لضمان بقائه في منصبه، وهي نفس حالة مصر أيضًا، وكلها تصرفات تستدعي التفكير حول ما إذا كان الحكام العرب يستخلصون عبر التاريخ، أم يكرّرون نفس أخطاء أسلافهم، وأقصد هنا أن تساقط الحكام في مصر وتونس وليبيا واليمن،
كان من المفروض أن يشكّل الدرس للخلف من الحكام بأن التصاقهم بالكرسيّ أمر غير ممكن، وبالتالي عليهم تغيير النهج والتصرّفات وتأدية مهامّهم وفق سلطتهم التي حصلوا عليها من شعبهم، وإلا فمن حقّ الشعب الذي أعطاهم السلطة أن يستردها، لكن الحالة كانت معاكسة فهذا السقوط ضاعف من مخاوف باقي الحكام، فزاد بعضهم من تمسّكه بالكرسي عبر مزيد من القمع والتخويف والإفقار المتعمّد لشعبه، وجعله يبيع صوته وقراره الديمقراطيّ في الانتخابات مقابل سلّة من الغذاء،
أو حفنة من المال، بينما دفع ذلك بعضهم إلى إصلاحات ظاهريّة تحاكي الاحتياجات الشكليّة للمواطنين كالسماح بمزيد من الترفيه والمسابقات الرياضيّة لإلهاء الشعب، ومنحه الشعور أن الحاكم يهتمّ بأمره، لكنها في حقيقة الأمر قضيّة أشدّ وأكثر مرارة، فهي الدليل على أن الأشخاص في المجتمعات العربيّة، وفي أغلب الأحيان إن لم يكن كلها، ليسوا هم أنفسهم قبل وبعد تقلد السلطة، أيّ سلطة كانت، وأن الحكَّام العرب لا يحملون أيّ احترام، أو حبّ، أو تقدير لشعوبهم، ولا يعيرون إرادتها أيّ اعتبار،
فلو كانوا يفعلون ذلك ولو كانوا يضعون مصلحة الوطن والشعوب فوق كل اعتبار، كما يتشدّقون، لكانوا أخلوا مناصبهم، جرّاء غضب الشعوب عليهم، كما يحدث في الدول الأوروبيّة والليبراليّة، وهو عكس ما يشهده العالم العربيّ وحتى الإسلاميّ في دول أخرى ومنها أفغانستان وغيرها، لينتهي بهم الأمر إلى حال بشار الأسد وزين العابدين بن علي ومعمر القذافي، لكن اللافت للانتباه هنا هو ان الانفراد بالسلطة والالتصاق بالكرسي، في المجتمعات العربية، بما فيها المجتمع العربيّ في إسرائيل، لا تتوقّف على الحكومات والسلطة السياسيّة الرسميّة فقط، بل تصل أيضًا مؤسّسات المجتمع المدنيّ، كالأحزاب والجمعيّات والمؤسّسات الاجتماعيّة وحتى تلك الحقوقيّة والدينيّة، ففي الكثير من هذه المؤسّسات يبقى عقودًا من الزمن في مناصبهم، ولا يغادروها إلا إذا تمرّدت عليهم قواعدهم الحزبيّة، أو أصاب أحزابهم ومؤسّساتهم الوهن والفشل، فهم الأهمّ وتاريخهم كذلك، وبالتالي فهم يشكّلون استمرارًا لما كان في معظم مراحل التاريخ العربيّ، والدول العباسيّة والأمويّة والفاطميّة والعثمانيّة، أو غيرها التي أقامت ووضعت نظامًا سلطويًّا فرديًّا مطلقًا، كانت السلطة فيه هي الأساس والمحور الذي يدور حوله كلّ ما في البلاد، تدعمه "سلطة وفتاوى" دينيّة من رجال دين وشهادات شرعنة من "مثقّفين" كان دورهم الأساسيّ، ومن هنا تدور كل أحداث التاريخ العربيّ حول الحكام والسلاطين والأُمراء، دون ذكر للناس العادييّن أو المجتمعات المحليّة .
السؤال الثاني وهو سؤال يمتنع كثيرون عن طرحه ومناقشته، خاصّة في منطقة الشرق الوسط والتي يمكن الجزم اليوم أنها تعيش صراعًا ربما يكون مصيريًّا بين رغبة الشعوب وخاصّة الجيل الشاب في الديمقراطيّة والليبراليّة، وبين تزايد مخيف لقوّة الحركات الدينيّة المتزمّتة والتي تريد السيطرة على الحكم وأجهزة السلطة ومواقعها، سواء تلك في العالم العربيّ،
أو في إسرائيل، هو السؤال الحقيقيّ حول ما إذا كان بالإمكان أصلًا التوفيق بين الأجندات الدينيّة المتزمّتة وبين الديمقراطيّة، فالجدل حول طبيعة العلاقة الممكنة بين الحركات الدينيّة الإسلاميّة وبين الديمقراطيّة مطروح منذ عقود، وتكفي هنا العودة الى ستينيات القرن الماضي في مصر ونشأة حركة " الإخوان المسلمين" برئاسة حسن البنا، وما قاله الرئيس المصريّ في حينها جمال عبد الناصر من أن البنا حاول إقناعه بضرورة فرض الحجاب على كافّة السيّدات والنساء والفتيات في مصر كلباس ملزم، وهو سؤال جوهريّ حول ما إذا كان تعريف الدولة التي تريدها هذه الحركات، سواء في غزة أو سوريا اليوم،
أو في تركيا أردوغان والتي تطمح إليها هذه الحركات في غيرها من الدول الإسلاميّة والعربيّة، ومنها محاولات خجولة للحركات الإسلاميّة في المملكة الأردنيّة الهاشميّة، بأنها دولة إسلاميّة فقط( سوريا اليوم) أو دولة إسلاميّة، ومن ثم ليبراليّة وديمقراطيّة(تركيا مثلًا)، تترك حيزًا لممارسة الديمقراطيّة، وهو نقاش متواصل منذ منتصف القرن الماضي وحتى اليوم، يتمحور حول إمكانيّات التوفيق والملاءمة، أو التناقض والتنافر بين أجندات دينيّة، هي في نظري تفسيرات سياسيّة وفئويّة خاطئة ومقصودة للديانات السماويّة التي دعت إلى المساواة والعدل، وتقديس الحياة والحريّات والعلم، وبين ثقافات تحقيق الذات وقيم الحريّة والديمقراطيّة والانتقال السلميّ للسلطة، وفوق كلّ ذلك فصل الدين عن الدولة.
ومن هنا ورغم حدة ما سأقول فإن النقاش هنا يبدأ أصلًا من الأهداف المتناقضة للحركات الدينيّة وللحركات الديمقراطيّة العلمانيّة، فهدف الأولى هو إنجاز الدولة "الدينيّة" أي دولة الدولة الإسلاميّة في أجندة الحركات الدينيّة الإسلاميّة، وهدفها أو مبتغاها خدمة الدين الإسلاميّ ونشره عالميًّا وتطبيق الشريعة المستقاة من القرآن والأحاديث النبويّة والسيرة النبويّة، تضمن المساواة بين المسلمين، وتضمن وضعًا خاصًّا لغيرهم من أتباع الديانات السماويّة، أمَّا الحركات والتوجهات الديمقراطيّة فتهدف إلى إنجاز مشروع “الدولة الديمقراطيّة”،
وهي في غالب الأحيان دولة علمانيّة والتاريخ يؤكّد أن تطوّر الديمقراطيّة في الغرب تزامن مع عصر العلمنة الذي كان ضروريًّا لتحرير الناس من حكم الملوك الذين كانوا يستخدمون نفوذ المؤسّسات الدينيّة، وكانوا يظلمون الناس باسم الدين يدخلون الجنة من يشاء ويدخلون النار من يشاء . لذلك تم الاتجاه نحو العلمنة، ونحو تحجيم الدين في المجتمع وبدرجات متفاوتة، عبر تشريعاته في البرلمانات المنتخبة ديمقراطيًّا، ومن هنا فهي تشريعات سلطة ونظام، هدفها خدمة الشعب مهما كانت دياناته وعقائده، وضمان حقوق الإنسان والحريّات الفرديّة والمساواة التامّة بين كلّ المواطنين والمواطنات،
وتطبيق مبادئها على الجميع دون استثناء ودون تفضيل بعضهم على الآخر من منطلقات دينيّة وعقائديّة، فكلّهم مواطنون ينطبق عليهم قانون واحد. يحقّ لهم تولّي كافّة المناصب وممارسة الحكم بمساواة تامّة، كما أن لهم الحق نشر وترويج عقائدهم وأفكارهم في المجتمع بحريّة كاملة كغيرهم، وهو الحال أيضًا في حالة إسرائيل، وهي اليوم جزء لا يتجزّأ من الشرق الأوسط فكريًّا ودينيًّا وتطرّفًا عقائديًّا، وازدياد التطرّف السياسيّ والدينيّ وقوّة الأحزاب الاستيطانيّة والمتزّمتة سياسيًّا ودينيًّا التي تريد إسرائيل دولة يهوديّة أولًا،
ومن ثم ديمقراطيّة، أو دولة لليهود ووطنًا قوميًّا لهم فقط، وهو نفس النقاش الأسبق بين نظام يريد تطبيق الشريعة اليهوديّة التي تريد بسط تعليماتها وتعاليمها. وهي لا تنحصر في طبيعة الدولة وحقوق مواطنيها واعتبار غير اليهود فيها فئات من الدرجة الثانية، أو الثالثة مطالبون بالولاء ودون حقوق يضمنها القانون والدستور، وهو ما سيطال ربما اليهود المعارضين لتوجّهات دينيّة وسياسيّة متزمّتة وظلاميّة وخلاصيّة، بل يتعدّى ذلك إلى تطبيق المفاهيم والقيم والتوجّهات السياسية والتي تتعلّق بحدود الدولة وفق تعليمات التوراة، وهي تشمل سوريا ولبنان والأردن ومصر والعراق أيضًا، وهي أصوات بدأت تعلو مؤخّرًا تدعو إلى الاستيطان من جديد في غزة ولبنان وغيرها.
مظاهر التهليل والتكبير الجماهيريّة، لكل نظام جديد في الدول العربيّة، واعتباره المنقذ والمخلّص هي موضع السؤال الثالث، وهي حالة خاصّة تثير القلق، تؤكّد الشعور السائد والمحبط في أوساط المجتمعات العربيّة، حول كون السلطة والتنافس عليها والتناوب والتبادل حولها، تناوب أو مُفاضلة بين السيئ والأسوأ، وبالتالي على المواطنين قبول " أهون الشرَّين" ، وهي شعارات وعبارات سمعناها في الأيام الأخيرة، بعد سقوط نظام بشار الأسد ملخّصها أنه" مهما كان القادم سيّئًا فإنه يبقى أفضل ممّا كان"،
وهذه حالة ربما نجد تفسيرها العلمّي والنفسيّ الاجتماعيّ، لدى العالم والباحث أريك فروم في كتابه "الهروب من الحريّة" الذي يقول فيه إن حكم الاستبداد يحتاج إلى حاكمٍ مُسْتَبِد، وبالمقابل إلى شعب يقبل الاستبداد، يسميه فروم " المستَبَدّ به" يكون الخاضع الخانع الذي يقبل بالألم الذي يقع عليه، ويقبل "النزعة المازوخيّة" تعبيرًا عن خوف من الذات، وما يرتبط بها من حريّة ومسؤوليّة، فالمازوخي فرد خائف لا يتحمّل ذاته الفرديّة المستقلّة واستقلاله يشكّل مصدر قلق له فيبحث عن شخصيّة،
أو ذات أقوى منه، ينضوي يخضع لها معتقدًا أنها تمنحه الأمان، وأنه يشعر من خلالها بالقوة، وهو ربما التفسير للترحيب في الدول العربيّة، بكلّ حاكم جديد يأمل العامة أن يكون أفضل ممّا سبقه، ويمنحهم الأمن والأمان، دون أن يتّخذوا أي خطوات، ودون أن يكون لهم أيّ دور في تحسين الحال، خاصّة إذا كان الحاكم المستبد، والجديد ربما والذي استولي على السلطة بالقوة.
وهو ما تكرر منذ عصور غابرة، واعترف به أول حكَّام بني أمية معاوية بن أبي سفيان. من استيلائه على السلطة بالقوة، أو بحسب عبارته ". فإني والله ما وليتها بمحبة علمتها منكم، ولا مسرّة بولايتي، ولكن جالدتكم بسيفي هذا مجالدة"، يتّخذ من الدين ستارًا وسندًا، خاصّة في الشرق حيث يعتبر الدين قوة فوق طبيعيّة يلجأ إليها الحاكم لإضفاء الشرعيّة على سلطة الحكم، عبر استغلال مشاعر متجذّرة في المنطقة، خاصّة وأن الدين، ومن يتحدث باسمه، يحتلّ مكانة جوهريّة في شخصيّة كل إنسان، ومن هنا السؤال حول القبول بالمستبِد،
وخضوع فئات كبيرة للاستبداد والظلم والاكتفاء بأفضل السيّئين، أو الأقل سوءًا دون السعي إلى الأفضل، وهو ما كان أثار دهشة إيتيان دو لابواسييه ، الكاتب والقاضي فرنسيّ وواضع النظريّة الفوضويّة، ومؤسّس الفلسفة السياسيّة الحديثة في فرنسا، خلال نظره إلى ظاهرة الاستبداد، وتحديدًا ليس فعل الإكراه الذي يمارسه الطاغية، بل فعل الرضوخ والانصياع الذي يستجيب به أفراد المجتمع لأوامر المستبِد.
خلاصة القول: لم تتضح الصورة بعد في سوريا، والتي كنت قد أشرت إلى أن نظام حكمها مصيره إلى الزوال، كغيره من الأنظمة الدكتاتوريّة التي لا تخدم شعبها، بل تريده أن يخدمها صاغرًا مظلومًا، لكن الأسئلة الثلاثة السابقة تنتظر الإجابات، وفوق كل هذه الأسئلة سؤال مصيريّ وهامّ، على كل عاقل طرحه، وهو دور السابع من أكتوبر 2023 وهجمات "حماس" فيه، في كرة الثلج التي عصفت بسوريا ولبنان وغزة وإيران واليمن ، وهل كانت ستحدث لولا هذه الهجمات التي كانت تعبيرًا عن خطوات غير محسوبة العواقب، تصرّف واضعوها ومخطّطوها وفق المتّبع في الشرق من عدم التفكير بعيد المدى، بل الاكتفاء بالنظر إلى طرف أرنبة الأنف، والبحث عن انتصار يغذي " الأنا" الآنيّ والفوريّ، دون تحليل للنتائج المحتملة.
وهي كانت واضحة لكل ذي بصر وبصيرة . والجواب هو إن ما حدث هو نتيجة مباشرة ومرحليّة لما فعلته "حماس" ، في السابع من أكتوبر 2023، والقادم أسوأ، وها هي النتائج ماثلة اليوم من قضاء على معظم مقوّمات الحياة في غزة وضرب "حزب الله" والدولة اللبنانيّة وقصف منشآت إيرانيّة وحوثيّة، وانهيار لنظام الأسد بعد إضعاف عكازتيه، إيران و"حزب الله"، وتدمير للمقوّمات العسكريّة والدفاعيّة للدولة، وهو تعبير آخر عن تفكير شرقيّ قصير المدى، اكتفى بالإطاحة بنظام حكم دون صيانة ما كان من الضروريّ صيانته وحمايته، وهو الجيش والأمن ووحدة وسلامة أراضيها، وبالتالي فهو ليس سقوط لنظام حكم عائلة الأسد فقط، بل سقوط لدولة كاملة،
أو إسقاط لها، بكافّة مواطنيها ومقدراتها وثرواتها ومائها وسمائها. ويبقى السؤال مرة أخرى: هل سبق التفكير الفعل وهل سبق العقل العاطفة، أو الرغبة في الانتقام، أم أنه تكرار لفصول سابقة انتظر فيها مواطنو دولة عربيّة الأقلّ سوءًا فكان العكس؟؟ الأيّام كفيلة بالردّ. وللختام هل سيعود تقسيم الدول العربيّة من جديد استمرارًا إلى اتفاق سايكس بيكو عام 1916 مع فرنسا والذي قسّم الشرق إلى مناطق سيطرة للأوروبيّين في حينه، ليعود التاريخ على نفسه مرة أخرى !!!