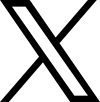الحروب الآنيّة بين الاعتبارات العسكريّة وهوس الكرامة القوميّة
لم تكن حالة القطب الأكبر الواحد، أو الدولة العظمى الوحيدة، والتي يعيشها العالم منذ تفكّك الاتّحاد السوفييتي مطلع تسعينيات القرن الماضي، وقبله تفكّك حلف وارسو، بعد أن فقدت الاشتراكيّة بريقها والشيوعيّة بقيادة الاتّحاد السوفييتيّ، صفتها كمحرّر للشعوب الفقيرة والضعيفة، وهي صفة تؤكّد حرب أوكرانيا زيفها.

وسنعود إليها لاحقًا، الحالة الأشدّ بروزًا من جهة، والأشدّ إيلامًا وخطورة ممّا هي عليه اليوم، خاصّة وأنها بخلاف الذي كان سائدًا خلال عقود تزاحمت فيه، وأحيانًا تصادمت رغبات ومصالح وتحالفات الكتلتين الشرقيّة والغربيّة، أو القوّتين الأعظم أميركا والاتّحاد السوفييتي. وكانت كلّ منهما مجبرة بحكم مكانتها على إبداء الجديّة والرصانة والعمل على أرض الواقع، لضمان تحالفها ومنع أيّ اعتداء عليه.
وأزمة الصواريخ الكوبيّة في السادس عشر من تشرين الأول 1962 بين الولايات المتحدة الأميركيّة والاتّحاد السوفياتي، وسببها اكتشاف الأميركيّين صواريخ نوويّة سوفياتية تم نصبها ونشرها على الأراضي الكوبيّة، وما ترقبه وراقبه العالم حينها من احتمال لوقوع مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة والاتّحاد السوفياتي، بل ربما وقوف العالم كلّه وعلى مدى أسبوعين على حافّة حرب نوويّة، هو الدليل على ما كان، وغيرها من القضايا بعضها يتعلّق بالشرق الأوسط منها حرب عام 1956، والمسمّاة عربيًّا العدوان الثلاثيّ على مصر.
لكن الحالة اليوم تختلف تمامًا فالعالم أحادي القطب خاصّة عسكريًّا وسياسيًّا ،ومصالح هذا القطب واضحة ومعروفة لا ينافسه فيها أحد، ولا يجبره أحد على فعل شيء ، بل إنها حالة جعلت هذا القطب يستغلّ قوته العظمى، أو يستخدمها فقط في حالة واحدة ووحيدة هي ضمان أهدافه الخاصّة والضيّقة والسياسيّة، ومصالح قياداته وداعميها والمتبرّعين لها، دون أيّ وزن أو اهتمام للقيم العليا من حيث حياة الإنسان والسعي إلى السلام، والعمل الجاد من أجل وقف النزاعات ومنع تفاقمها،
بل أسوأ وأخطر من ذلك، فقد تحوّلت "ممارسة" نفوذ القوة العظمى الوحيدة، أو تلك التي فقدت مكانتها، وتريد عبثًا العودة إليها بكافّة الوسائل والطرق، إلى مجرّد لقاءات قمّة بمجملها صورة للإعلام، إلى رحلات مكوكيّة فارغة المضمون لا تزحزح أيًّا من الأطراف المتنازعة عن مواقفه وربما غيّه، ولا تغير من الواقع شيئًا، وهذا في أحسن الأحوال، وإلى عبارات رنّانة وخطابات ناريّة لا رصيد لها، ولا نيّة للعمل خلفها، بل كلام في العموم للاستهلاك العام، دون التزام.
أقول هذا وأستذكر في آنٍ واحدٍ ورغم الفوارق في التوجّهات حدثين، أوّلهما لقاء القمة بين الرئيسين الروسيّ فلاديمير بوتين والإيرانيّ مسعود بزاشكيان، والذي رشح عنه أنه تمحور حول الأوضاع في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائيّة بين البلدين.
إلى جانب التأكيد على أن روسيا وإيران تعملان بتعاون في الساحة الدوليّة، وأن تقييماتهما للأحداث الدوليّة متشابهة، وأن موسكو تولي علاقاتها مع طهران أهميّة بالغة. وهو بيان يعيد إلى الأذهان وللأسف، بيانات فضفاضة امتاز بها الشرق الأوسط وما زال، من كلمات رنّانة تتطرّق إلى العموميّات، منمّقة ومزيّنة، لا تحمل في الواقع أيّ معنى،
أو أيّ مضمون، بل تعتمد الخطابة والفذلكات، فاللقاء المذكور ووسط الأجواء التي يعيشها العالم اليوم من حرب متواصلة في أوكرانيا، حوّلت روسيا إلى دولة منبوذة صدرت بحقّ رئيسها أوامر اعتقال من محكمة الجنايات الدوليّة، وجعلت من إيران دولة يعتبرها كثيرون في العالم سببًا لانعدام الاستقرار والهدوء في منطقة الشرق الوسط عبر دعمها لمنظمات مسلّحة أصوليّة ودينيّة في لبنان والعراق وسوريا واليمن وغزة وما يرافق ذلك، وينبثق عنه من إطلاق للصواريخ والمسيَّرات باتّجاه إسرائيل،
والتي تواصل البحث في سبل الردّ، ما يؤكّد أنه سيكون ردًّا فاترًا على أغلب الظن، كما رشح عن مصادر إسرائيليّة أكدت أن الردّ لن يشمل مهاجمة المنشآت النوويةّ في إيران المسؤولة في رأي أمريكا وإسرائيل عن انعدام الاستقرار في العالم، عبر دعمها لروسيا في حربها المتواصلة ضد أوكرانيا، بطائرات دون طيّار وغيرها. وثانيهما خطاب الرئيس الأميركيّ جو بايدن أمام الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة ،
وليس تحديدًا ما جاء فيه، بل ما افتقده هذا الخطاب من جديّة وحزم ورصانة، تشرح ربما ما يعيشه العالم عامّة والمنطقة خاصّة من استمرار للحرب رغم مآسيها، وعدم قدرة الولايات المتحدة على ضبط الأمور وفرض الرأي.
اتجهت أنظار العالم كلّه، إلى هذا الخطاب، وكان أمام الرئيس الأميركي بايدن أحد خيارين، أوّلهما إبداء نفس الحزم الذي أبداه في العاشر من أكتوبر عام 2023، خلال زيارته لإسرائيل ثلاثة أيّام بعد هجوم السابع من أكتوبر، محذّرًا "حزب الله" وإيران من مغبّة المشاركة في الحرب، وما رافقه من تحريك للقوات البحريّة الأميركيّة- كما في أزمة الصواريخ الكوبيّة وبالتالي ممارسة دوره ونفوذه كرئيس للدولة العظمى الوحيدة في العالم،
وطرح حلول في القضيتين اللتين تشغلان العالم حاليًّا، وهما استمرار الحرب في المنطقة واتّساعها لتصل لبنان وعاصمته وسط صمت عالميّ مطبق إلا من رحم ربي، كفرنسا التي لوّحت بمنع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وإيطاليا التي احتجّت على المسّ بقوات الأمم المتحدة "اليونيفيل" .
ولا أتطرّق هنا إلى ما يسمّى إعلاميًا العالمين العربيّ والإسلاميّ، فهما في مقام الحاضر الغائب، وبالتالي تكرار ما فعله وزير الخارجيّة الأسبق جون كيري الذي سئم محاولة إقناع رئيس الوزراء حينه إسحق شمير بقبول المشاركة في مؤتمر مدريد للسلام، عام 1989 وفشلت محاولاته السياسيّة والدبلوماسيّة، فكتب على قصاصة ورقيّة، رسالته القصيرة لكنّها الحازمة، فخط رقم هاتف البيت الأبيض ووزارة الخارجيّة وأضاف :"قرّروا ثمّ اتّصلوا بي" وبكلمات أخرى:" سئمت محاولة إقناعكم بالحسنى.
وجاء دور الضغط السياسيّ وغيره من تبعات"، أو على الأقلّ وضع تصوّرات أولويّة للحلّ واقتراحات أوليّة لذلك. لكن بايدن اختار الخيار الثالث، وقرّر أن لا يقرر على وزن وصف مجريات القمم العربيّة:" أن اتّفق الزعماء العرب على أن لا يتّفقوا"، فكان خطابه كثير الكلام قليل النتيجة، فاستعاض عن طرح حلّ للحرب الدائرة في غزة ولبنان، وفشله الحاضر واليوم في إقناع إسرائيل أو "حماس" بإبرام صفقة تبادل، أو "حزب الله" وإيران بالكفّ عن قصف إسرائيل، باستعادة ذكريات الماضي وبداية حياته السياسيّة،
في اعتراف ربما ضمنّي أنه يدرك انتهاء حياته السياسيّة ويسَّلم بأنه سينهيها بصوت خافت، وكمن ساهم في حربين لا نهاية تبدو لهما، في غزة بدعمه المطلق لإسرائيل، والذي بدأ بتحريك سفن الأسطول السادس وحاملتي طائرات وتدفّق غير محدود للأسلحة، وحرب في أوكرانيا بدأت نتيجة ما يبدو على أنه تعجرف وتكبّر أميركيّ خاصّة وأن أميركا بمخابراتها رصدت إشارات تشير إلى أن روسيا ستهاجم أوكرانيا، ولن تقبل بضمّها الكامل أو الجزئيّ، أو الضمنيّ إلى شمال الأطلسيّ، لكنّه أصر على عدم الحديث إلى فلاديمير بوتين مفضّلًا لغة التهديد، متناسيًا أن أطماع بوتين في أوكرانيا ليست سياسيّة ولا عسكريّة،
بل إنها تجسيد لعزم روسيا على استعادة مجدها وكرامتها التي مسّها تفكّك الاتّحاد السوفييتي، ومسّها أكثر نزعة أوكرانيا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسيّ، والتي اعتبرتها روسيا خيانة تذكّر بخيانة "بروتوس"، فاكتفى بايدن بالخطابة دون الخطاب. وعاد إلى تكرار شعارات عفا عليها الزمن، وربما ساهمت الولايات المتحدة نفسها في إفراغها من المضمون، منها قوله أن على الأمم المتحدة أن تواصل الحفاظ على السلام، ومنع نشوب الصراعات، وتخفيف المعاناة الإنسانيّة متناسيًا الواقع المرّ أن بلاده أوقفت تمويل منظمات إنسانيّة، وأنها تستخدم حقّ النقض الفيتو في مجلس الأمن صاحب القرارات الملزمة، بشكل تلقائيّ، لمنع اتخاذ قرارات تؤدّي، أو ربما تؤدّي إلى وقفف الحربين في المنطقة وأوكرانيا، فتحدّث عن السيادة وسلامة الأراضي وحقوق الإنسان كمبادئ أساسيّة لميثاق الأمم المتحدة، وركائز للعلاقات السلميّة بين الدول، دون الإشارة من قريب، أو بعيد الى دوره في تحقيقها أو دوره في جعلها ، بسبب مواقف بلاده، أمورًا أقرب إلى الشعارات الرنّانة والعناوين الإعلاميّة، وأضغاث الأحلام.
وإذا كنا نعتقد، أو إذا اعتقد البعض، أن عدم تحمل المسؤوليّة، هو مرض شرق أوسطي خاصّة بعد السابع من أكتوبر ، إسرائيليًّا وغزيًّا، ومن طرف إيران و"حزب الله" ، جاء خطاب بايدن ليؤكّد حالة العالم الجديد الذي يبدو أن شعار قوته العظمى الوحيدة فيه يتلخّص في أنها غير مسؤولة عمّا يحدث في العالم، وليس ذلك فقط، بل إنها غير مسؤولة عن إنهائه، فروسيا في نظر بايدن هي المسؤولة الوحيدة عمّا يحدث في أوكرانيا،
رغم أن بلاده بقيادته هو ومواقفه السلبيّة وربما المتعالية تجاه روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين الذي وصفه بأنه قاتل، حالت دون تحمل مسؤوليّته كدولة عظمى عليها لعب دورها في ضمان الاستقرار والسلام، فتغاضى عن ذلك حتى اندلعت الحرب، وواصل بعد ذلك نهجه بتدفّق أسلحة إلى أوكرانيا، دون أي محاولة لحلّ الأزمة، ودون أن ينظر إلى عبر التاريخ التي جعلت تيودور روزفلت رئيس بلاده وجوزيف ستالين، الزعيم الروسيّ بقسوته وبطشه المعروفين، يلتقيان ويتحدّثا، بل ويتحالفا لمنع السيطرة النازيّة التي كانت ستلحق بأوروبا كلّها الخطر الداهم، وزيارة الرئيس السوفياتيّ نيكيتا خروتشوف، الشهير بحادثة الطرق بحذائه على منصّة الخطابات في الأمم المتحدة وعدائه الشديد لأمريكا،
وذلك في أيلول 1957 أي في ذروة الحرب الباردة، ولقائه الرئيس الأميركيّ جون كينيدي بعدها عام 1961. وكذلك زيارة الرئيس الأميركيّ ريتشارد نيكسون للاتّحاد السوفياتي في أيار 1972 ليوقّع ومع الرئيس السوفياتيّ حينها ليونيد بريجنيف معاهدة للحدّ من نشر منظومة الدرع الصاروخيّة، فادّعى بايدن في خطابه أن روسيا هي الوحيدة التي لديها القدرة على إنهاء هذه الحرب على الفور، وأنها وحدها هي التي تقف عقبة في طريق السلام المؤكّد. وأن ثمن السلام الذي تطلبه روسيا هو استسلام أوكرانيا، وأراضي أوكرانيا وأطفال أوكرانيا، في تصريحات تذكّرنا بتصريحات مشابهة تتعلّق بالحرب في غزة يدّعي كلّ طرف فيها أن الطرف الآخر يريد إبادة كافّة شعبه، وأن استمرار الحرب من طرفه، هي دفاع عن الأمة والوطن، ومنعًا لأيّ إهانة قوميّة، أو مسّ بالكرامة القوميّة والوطنيّة، وليس لأهداف سياسيّة استراتيجيّة وعسكريّة قوامها استعادة الأمن.
وكما كان تطرّق بايدن إلى حرب أوكرانيا عامًّا ولفظيًّا وخطابيًّا، جاء تطرّقه إلى الحرب في الشرق الأوسط، فبلاده تصريحيًّا عازمة على منع نشوب حرب شاملة في الشرق الأوسط . والحلّ الدبلوماسيّ بين لبنان وإسرائيل هو السبيل الوحيد للأمن الدائم وللسماح لسكان البلدين بالعودة إلى ديارهم على الحدود بأمان، دون تطرّق إلى غزة واحتمالات وقف الحرب فيها، ولسان حاله يعكس اعترافًا بالفشل في خلق اختراق تضمن صفقة لتبادل الرهائن والسجناء، ووقف لإطلاق النار، أو حتى ضمان لاستمرار المعونات الإنسانيّة،
ما وصل ذروته هذا الأسبوع بتصريح أميركيّ من إدارة بايدن حول احتمال قرن استمرار الدعم العسكريّ لإسرائيل باستمرار دخول المساعدات الإنسانيّة، في معادلة قوامها دعم عسكريّ يضمن استمرار الحرب مقابل الغذاء ، متناسيًا حقيقة كشفها خطابه رغم محاولاته إخفاءها بعبارات رنانّة، قوامها أن الحربين الحاليّتين في أوكرانيا والشرق الأوسط، واستمرارهما وخاصّة الأخيرة رغم محاولات لوقفها، وأن كانت محاولات خجولة، سببهما ليس عسكريًّا، أو استراتيجيًّا وكذلك سبب استمرارهما، بل يتعلّق بما يمكن تسميته "الكرامة القوميّة"، أو الشعور بأن الكرامة القوميّة والكبرياء القوميّ قد تعرّض للمسّ والإهانة،
فحرب أوكرانيا بدأت ليس لأن أوكرانيا أرادت الانضمام إلى حلف الأطلسيّ، فهذا ما كان حلم الرئيس الأخير للاتّحاد السوفييتي ميخائيل غورباتشوف الذي وافق على توحيد شطري ألمانيا بمعنى التنازل عن ألمانيا الشرقيّة كدولة مستقلّة رغم عضويتها في حلف وارسو الذي أصبح أثرًا بعد عين، مقابل تعهّد أميركيّ بأن لا تحاول الكتلة الغربيّة، أو حلفاء الولايات المتحدة ضمّ أيّ من دول الاتحاد السوفييتي إلى حلف الأطلسيّ. كما أن الرئيس الروسيّ بوريس يلتسن أيّد هذا القرار لاحقًا معتقدًا أنه قد يمهّد الطريق لانضمام روسيا نفسها إلى حلف الأطلسيّ، علمًا أنه تعهّد بتحويل الاقتصاد الاشتراكيّ الروسيّ إلى اقتصاد سوق رأسماليّ،
وعلاج البلاد بالصدمة الاقتصاديّة، وتحرير الأسعار والخصخصة في جميع أنحاء بلاده، بل لأن روسيا فلاديمير بوتين والذي تعمّد تغذية النزعة القوميّة ، اعتبرت موافقة أوكرانيا على الانضمام إلى غريماتها، مسًّا بالكرامة القوميّة، وطعنة آلمتها أكثر من غيرها خاصّة وأن روسيا اعتبرت أوكرانيا دولة شقيقة، أو دولة تحت رعايتها ، وجزءًا لا يتجزّأ منها، وبالتالي فوقف روسيا الحرب اليوم هو قبول بالإهانة القوميّة.
أميركا في هذا الشأن كذلك، حرّكتها "الكرامة القوميّة"، أو شعورها بأن توجّهات روسيا نحو أوكرانيا، خاصّة وأن الولايات المتحدة، رغم أنها ليست عضوًا في الاتّحاد الأوروبيّ، هي من دعمت، بل سعت على أرض الواقع إلى ضمّ أوكرانيا ضمن مساعي توسيع الاتّحاد الأوروبيّ. وأنها هي التي أملت على الدول الأوروبيّة وحلف شمال الأطلسيّ، صيغة وحدة ووتيرة الردود على التلميحات الروسيّة المعارضة لضمّ أوكرانيا، والتي سرعان ما تحوّلت إلى تهديدات، وبالتالي كان التصعيد الروسيّ،
خاصّة على ضوء العلاقات المتوترة بين الرئيسين الأميركيّ جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، والذي وصفه مؤخّرًا الكاتب والصحفي بوب وودوورد، المقرّب من الرئيس بايدن والحزب الديمقراطيّ، في كتابه الجديد" الحرب" والذي صدر قبل أيّام معدودة، بأنه هتلر العصر الحاليّ. وقال إن غزو أوكرانيا، يوازي تصرّفات ألمانيا النازيّة، في نظر إدارة بايدن، محاولة روسيّة للمسّ بهيبة أميركا ومنعها من تنفيذ سياساتها ومخطّطاتها المتعلّقة بالاتّحاد الأوروبيّ.
وهي مخطّطات هدفت في القرن الماضي إلى إضعاف الاتّحاد السوفييتي، وما زالت تهدف اليوم إلى إضعاف روسيا، نحو عالم أحاديّ القطب والقوة العظمى. ومن هنا جاء التشدّد المتزايد في الردّ الأميركيّ الذي ردّ على التحذير الروسيّ لأوكرانيا بتحذير أقسى وأشدّ، لم يترك مجالًا أمام روسيا بوتين، والتي تحرّكها المشاعر القوميّة، للتراجع ولنفس المبررات المتعلّقة بشعور روسيا بوتين أن أميركا تتدخل في شؤونها وتمسّ بكرامتها القوميّة عبر إقناع الدول التي يعتبرها بوتين جزءًا من روسيا بالانسلاخ عنها والانضمام إلى الغرب، ناهيك عن الأبعاد الاقتصاديّة لهذه الخطوة وتحديدًا مجالات الطاقة. وكلّها اعتبارات حالت دون أن يتّخذ كلّ من الطرفين الأميركيّ أوّلًا والروسيّ ثانيًا، خطوة كان بإمكانها منع الحرب، عبر لقاء بين الرئيسين، كما حدث في السابق أكثر من مرة، ووسط ظروف من العداء الحقيقيّ بين البلدين.
وإذا كان هذا حال الحرب في أوكرانيا، فهو أشدّ وأقسى وأصعب في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط منذ عام ونيف، على جبهات غزة والشمال وإيران والحوثيين، فرغم محاولة كافّة أطرافها تغليفها بغلاف سياسيّ وعسكريّ واستراتيجيّ، وتسميتها بأسماء تخدم منطلقاتها وتبرّرها، أو تحاول ذلك، لكنها تكشف الحقيقة والدوافع ، وكلّها دوافع تتعلّق بالشعور المشترك بين كافّة الأطراف أنها حرب على أمرين أوّلهما تعزيز وكتكريس الرواية، وثانيهما وهو الأهمّ، الردّ على إهانة الكرامة القوميّة،
وهذا ليس بجديد في الشرق الأوسط، لكنّه يبرز هذه المرّة عبر التسميات ابتداءً من "طوفان الأقصى" من طرف "حماس" في استخدام واضح للمسجد الأقصى الذي لا يشكّل رمزًا دينيًّا للمسلمين فحسب، بل رمزًا قوميًّا للفلسطينيّين كلّهم، مرورًا بالسيوف الحديديّة وهي تسمية تعود في التراث اليهوديّ إلى التاريخ الغابر الذي حاولت مجموعة سكانيّة تسميها الكتب اليهوديّة " بليشتيم" منع اليهود، قبل آلاف السنين، من إقامة كيان مستقلّ وصيانته وضمان استقلاله ومنعوهم لذك من صنع السلاح، أو الوسائل القتاليّة وبضمنها "السيوف الحديديّة".
وشكّل ذلك مسًّا كبيرًا بكرامة اليهود وشعورهم القوميّ، وخاضوا حروبًا لمنع استمرار الحال على ما هو، أي أنها سلسلة أخرى من وجود عناصر تحاول المسّ بالكرامة والهويّة القوميّة لليهود وتحديد خطواتهم، وبالتالي يجب الردّ عليها، وعبر المصطلحات المستخدمة رسميًّا وحكوميًّا وحتى إعلاميًّا ومنها النصر المطلق وإخضاع "حماس" "وحزب الله" وردّ الاعتبار وترميم قوة الردع، وتلقين الأعداء درسًا، وتوجيه ضربة لن تُنسى، وإعادة لبنان وغزة مئات السنوات إلى الوراء، ووضع حدّ نهائيّ لأيّ تهديد عسكريّ لإسرائيل، مرورًا بأسماء منها " الوعد الصادق" الذي أطلقته إيران على إطلاقها المسيرّات والصواريخ في شهر نيسان من العام الحاليّ باتّجاه إسرائيل، وشعور إيران بأنه تم المسّ بكرامتها القوميّة خاصّة بعد اغتيال إسماعيل هنيّة على أراضيها، وداخل مبنى تابع للرئاسة الإيرانيّة. وغيرها وكلّها تضاف إلى أمور أخرى منها داخليّة تتعلّق بلبنان مثلًا تجعل من الصعب، بل من المستحيل على "حزب الله" أن يتراجع عن نهجه، فهو استطاع رغم كون الشيعة أقلية في لبنان، وأقلية حتى بين المسلمين في لبنان، فرض هيمنته وهيبته البرلمانيّة والحياتيّة والسياسيّة والمذهبيّة بفضل سلاحه وقوته العسكريّة، التي مكّنته ليس فقط من اعتبار نفسه مساويًا، أو ندًا لغيره من المجموعات الأكثر منه عددًا، بل التفوق عليها وكذلك التعالي عليها.
هذا ما كان في الشرق الأوسط منذ الأزل فالمفاوضات السلميّة بين مصر وإسرائيل دارت طيلة فترة طويلة على منطقة طابا، وتحديدًا منطقة أقيم فيها فندق معيّن، وكان استردادها كلّها حتى آخر شبر، أمرًا لا يقلّ أهميّة بالنسبة لمصر عن استرداد كافّة سيناء، حتى أن كثيرين اعتبروه استردادًا للكرامة القوميّة والأراضي المصريّة، وهو الحال أيضًا في قضية أراضي الباقورة التي أصرّ الأردن على استعادتها كلّها ضمن اتفاقيّة السلام مع إسرائيل، فهي رمز لسلامة الأراضي الأردنيّة والتنازل عنها هو مسّ بالكرامة القوميّة، مع اختلاف واحد أساسيّ وهو أن الرئيس المصري الراحل أنور السادات استطاع تخفيف حدّة شعور بعض الاسرائيليّين بأن إعادة سيناء إلى مصر هي مسّ بالكرامة القوميّة الإسرائيليّة، بفعل زيارته إلى إسرائيل، وكذلك الملك حسين الذي كانت زيارته للعائلات التي فقدت بناتها في حادثة الباقورة ، عام 1997،
أمرًا هامًّا ودليل قيادة ورفعة إنسانيّة أزالت الشعور بأن الحادث وملابساته ، يشكلان مسًّا بالكرامة القوميّة لإسرائيل. ولا أقصد هنا الجزم ما إذا كانت اعتبارات الكرامة القوميّة سيئة أم جيدة، فهي حقيقة واقعة وشعور قائم وطبيعيّ يجب التعايش معه وتفهّمه، وربما التسامح فيه أحيانًا أو الصفح، واستخدامها كمبرّر لخطوات ما ولكن بشكل مدروس وعقلانيّ، ولكن خطورتها تكمن في استخدامها منطلقًا للردود والسياسات خاصّة في حالات يشعر شعب ما أنه تعرّ ض للإهانة فيفضّل الردّ غريزيًّا، أو بفعل العواطف، خاصّة إذا شمل هذا الشعور بالإهانة معطيات حول اعتداءات جنسيّة واختطاف أطفال وغيرها، وهي أمور تحدّثت عنها إسرائيل، وتعتبرها مبررًا لإصرارها على وضع حدّ لوجود "حماس" وإبادته.
ومن هنا الخطر أن تتحوّل الحروب ضمن هذه المعطيات، والحرب في غزة ضمنها، إلى حروب تحرّكها مشاعر الرغبة في الانتقام وردّ الاعتبار، وردّ الصاع صاعين للعدو، بمعنى استمرارها رغم انتهاء مبرّراتها العسكريّة والاستراتيجيّة. وهو ما قاله وزير الخارجيّة السعوديّ، فيصل بن فرحان آل سعود في مقال كتبه في صحيفة" فايننشال تايمز" البريطانيّة قبل أسبوعين، من أن "ادعاء إسرائيل بأن حربها في غزة وإصرارها على مواصلتها بحجّة الدفاع عن النفس، لم يعد له أساس خاصّة على ضوء الوقائع على الأرض في غزة، بعد عام من الحرب، وبالتالي فإن الأهداف التي تريدها إسرائيل هي إلغاء وهدم مقوّمات الحياة في غزة لعدة عقود إلى الأمام"، وهو ما ينطبق على الضربات المتبادلة بين إسرائيل و"حزب الله" واستهداف المدن باعتبار أيّ عمل إسرائيليّ يعتبره "حزب الله" مسًّا بكرامته يجب أن يقابل بردّ تعتبره إسرائيل مسًّا بكرامتها.
خلاصة القول أن اعتبار الكرامة القوميّة المبرّر الحقيقيّ الأوّل لمواصلة الحرب، حتى لو حاول السياسيّون إخفاءه، يعني نزع صفة الإنسانيّة عن الطرف الآخر، وانعدام أيّ ضوابط تحرّم المسّ به، بل إن كلّ شيء يصبح مباحًا، وهذا الخطر الداهم. وهو ما يؤكّد ضرورة مراجعة الحسابات بعد انتهاء الحرب، فانتهاؤها عسكريًّا هو بداية لمرحلة أقسى وأشد وأعتى تنفيذًا تتلخّص في إعادة كلّ طرف من أطراف الحرب، صفة الإنسانيّة للطرف الآخر، وهي صفة نزعتها الردود الغريزيّة التي تحرّكها مشاعر الانتقام والرغبة في ردّ الاعتبار القوميّ وترميم الكرامة القوميّة. وهي مشاعر لا يمكن وفقها بناء دول متقدّمة ومتحضّرة، وبناء شعوب منتجة وآمنة،
أو ضمان الأمن للأمم والشعوب وتحقيق الهدوء والسلام والرخاء، بل إن سيطرتها على منطلقات السياسيين تعني أن تحرّكهم، أو تتحكّم بخطاهم وقراراتهم غريزة البقاء السياسي بفعل الحرب، أو أن تستعبدهم مشاعر الانتقام بداعي الكرامة، وهو ما جاء التحذير منه في قول الكاتبة والروائيّة الأميركيّة ماري آن شافير "هذا الهوس بالكرامة يمكن أن يفسد حياتك إذا سمحت بذلك"، ومن هنا خير لنا إذا استبدلنا الكرامة القوميّة بتلك الإنسانيّة، فذلك أجدر وأفضل.