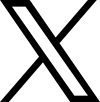إسرائيل ما بعد الحرب: دولة واحدة موحّدة أم كانتونات متّحِدة؟
كَمن "فَسَّر الماء بعد الجُهد بالماء"، وفق المثل الشهير الذي تناقلته الأجيال، والذي يُضْرَب فيمن تحدّث وكتب وقال دون أن يأتي بجديد ومفيد، كما يدلّ كذلك القول عن سماع جعجعة حجر الرحى، دون أن يرى أحدٌ طحنًا، والذي تجاوزت كلماته دلالاتها الأصليّة، لتصبح قولًا بلاغيًّا معناه، سماع جلبةٍ دون أن نرى عملًا ينفع

كمن يُكثِر القول دون فعل، جاءت نتائج التحقيقات العسكريّة التي أجراها الجيش الإسرائيليّ عامّة وقيادة منطقته الجنوبيّة خاصّةً
حول الملابسات والقصورات والإخفاقات التي رافقت اقتحام مسلّحي حركة "حماس" في السابع من أكتوبر 2023، البلدات الإسرائيليّة الجنوبيّة وتغلّبهم على جدار حديديّ اعتقدته إسرائيل خط بارليف بنسخته الغزيّة، وزوّدته بمجسّات وكاميرات وأجهزة استشعار يساندها جهاز مخابرات لا يترك شاردة ولا واردة،
بشكل عامّ، وما حدث في كيبوتس بئيري المتاخم للحدود مع غزة، والذي لقي أكثر من مئة من سكانه حتفهم قتلًا فور الاقتحام، وتمّ اختطاف عشرات منهم إلى غزة، وما زال بعضهم محتَجَزًا هناك حتى اليوم، جاء ليقول ما كان واضحًا ومعروفًا دون الحاجة إلى تحقيقات أيّ كانت ، فالنتائج على أرض الواقع أوضح من أيّ استنتاج، وأكثر شدّة وحدّةً وأسىً من أن تكون بحاجة لتحقيق،
بل إنّها ماثلة ومنتصبة أمام كلّ ذي بصر وبصيرة، من أن الجيش الإسرائيليّ أخفق في القيام بمهمّته الأساسيّة وهي الدفاع عن المواطنين والحدود عامّة، كما يقتضي اسمه إسرائيليًّا، ومن حيث تسميته "جيش الدفاع"، وعن مواطني "بئيري" خاصّة، وأنه لم يستعد أبدًا لهذه العمليّة من قبل مسلّحي "حماس" بمعنى أنه لم يتوقّع هجومًا بهذا الحجم وعدد مشاركيه، بل استعدّ لمحاولات اختراق فرديّة ونشر قواته بطريقة لتلائم ذلك، ما منع نقلها إلى "بئيري" وقت الحاجة،
أو تواجدها هناك في حالة الطوارئ، وذلك رغم أن المعلومات الاستخباريّة التي وفّرتها أجهزة الأمن منذ العام 2017، وأوصلتها إلى المستوى السياسيّ، وكشف عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في جلسة في أبريل نيسان من ذلك العام أمام اللجنة البرلمانيّة لشؤون مراقبة الدولة، والتي تمّ التغاضي عنها من باب ثقة المستويين السياسيّ (بنيامين نتنياهو رئيسًا للوزراء) ووزراء الأمن المتعاقبين من حزب نتنياهو وغيره، والأمنيّ كالموساد والشاباك والاستخبارات العسكريّة، من أن "حماس" خائفة وتخشى إسرائيل، وبالتالي لن تجرؤ على مواجهة مفتوحة تكسر قواعد اللعبة المتّبعة،
أو تخرق قواعد الاشتباك المتبادلة، وملخّصها جولات عسكريّة قصيرة المدى تليها هدنة، أو تهدئة، أو هدوء يسميها كلّ طرف ما شاء ويفسّرها كما يشاء، حتى وقع ما كان وقوعه محظورًا، ليتضح أن الجيش الإسرائيليّ لم يكن مستعدًّا وبالتالي، وجد مواطنو كيبوتس "بئيري" أنفسهم وخلال الساعات الأولى من يوم السبت السابع من أكتوبر، وحيدين مزوّدين بأسلحة خفيفة، أو حتى شخصيّة، في مواجهة مئات من مسلّحي "النخبة" الحمساويّة،
وهو ما لخّصه فريق التحقيق العسكريّ قائلًا إن الجيش الإسرائيليّ فشل في مهمّته المتمثّلة في حماية سكان الكيبوتس المذكور. واذا لم يكن ذلك الفشل كافيًا، أردف التقرير أن الإخفاق تحوّل بعد ساعات من الاقتحام إلى ارتباك وتخبّط وانعدام للقيادة، أسفر عن تجمّعٍ عدديّ، لقوات الأمن عند مدخل الكيبوتس، دون تواجد عمليّاتي وقياديّ، فانتظرت القوات الإذن، أو الأمر بالدخول بينما كانت "حماس" تنفّذ عمليتها، في إشارة واضحة إلى انعدام القيادة والسيطرة والتنسيق، وانعدام النظام بين القوّات والوحدات المختلفة، فهي كثيرة العدد عديمة الفائدة والجدوى.
هذا التقرير الذي يحاول الجيش الدفاع عنه بادّعاءات كونه الأول، أو مرحليًّا، أو واحدًا من سلسلة تقارير ستشمل كافّة الضباط والقطاعات والجوانب، والذي لم تأت نتائجه بجديد، أثار تساؤلات تصل حدّ المخاوف والقلق الحقيقيّ، من باب القول القديم قديمًا:" توضيحُ الواضحات من أشكل المشكلات"، فهو قد يعني التعامل مع مجموعة أيًّا كانت، لا تعي ولا تدرك ولا تفهم أبسط الأمور،
وتلك المُسَّلَّم بها، وهذا خطير، أو أنها تعني أن ذلك الذي يوضح الواضحات يدرك أن لا جديد لديه وبالرغم من ذلك، يعتمد الفذلكات الكلاميّة ومحاولات التضليل الإعلاميّة، أو الحيل النفسيّة والتسويقيّة، للتهرّب من الحقيقة الواقعة والمؤلمة والهرب من تبعاتها، أو للتنصّل من المسؤوليّة التي يعني تحمّلها ضرورة الردّ على أسئلة حادّة وشديدة، لا تكفي العبارات الرنّانة والصياغات البلاغيّة لذلك،
بل بحاجة إلى حقائق يجب عرضها على الملأ ودفع ثمنها. وهذه أي إعلان المسؤوليّة والاعتراف بالخطأ هي من صفات القائد الصالح أو الشجاع ، والفارق شاسع بينهما وبين السياسيّ، أو الزعيم السياسيّ، الذي سيحاول دائمًا العمل لمصلحته وتطويع كلّ شيء لخدمته حتى لو كان ذلك عبر الالتفاف على القوانين والأنظمة، وهو ما كان الحكيم أفلاطون مدركًا له حين قال إن الشخص الصالح لا يحتاج إلى القوانين،
لتخبره كيف يتصرّف بمسؤوليّة، أمّا الشخص الفاسد فسيجد دائمًا طريقة ما للالتفاف على القوانين، أو القول المنسوب للرئيس العراقيّ السابق صدام حسين، من أن القائد هو ذلك الرجل الذي يتحمّل المسؤوليّة، فهو لا يقول غُلب رجالي وإنما يقول غُلبت أنا، وهذا ما لم يتطرّق إليه التقرير حتى لو كان مرحليًّا، فهو تقرير يخوض في العموميّات ويكشف المكشوف، بل المفضوح،
دون أيّ إشارة إلى مسؤولين حاليّين أو سابقين، ودون الإشارة إلى مواقع القصور وأسبابه، أي دون تشخيص المرض وفق الأعراف الطبيّة، بل الاكتفاء بالإشارة إلى أعراضه وعوارضه فقط، وهذا ليس من سبل العلاج بشيء، بل إنه تهرّب واضح، حتى لو كان مرحليًّا من المسؤوليّة، التي أجاد بيتر أوستينوف، الممثّل والمؤلّف والمخرج البريطانيّ، وصفها قائلًا إنها الاستعداد التامّ لأيّ شخص للنهوض بالأعباء الموكلة إليه بأقصى قدراته، لكن في حالتنا هذه فإن التقرير المرحليّ،
وانعدام الإشارة ولو تلميحًا وغمزًا إلى وجود مسؤولين، أو مذنبين، أو مخطئين، يتجاوز في نظري معناه المرحليّ والآنيّ ، وصولًا إلى حالة يكشف فيها عمق المشكلة والمعضلة التي يعانيها المستوى القياديّ في إسرائيل، السياسيّ والاقتصاديّ والعسكريّ والاستخباراتيّ وحتى الحكم المحليّ، والتي تتعلّق بمفهوم المسؤوليّة وتحمّلها والاعتراف بالخطأ والتقصير،
ليس كوسيلة "لقطع الرؤوس" وظيفيًّا، بل كمقدّمة ووسيلة للتصحيح والإصلاح، وهو ما يعيد إلى الواجهة النقاش الأزليّ حول المعادلة غير الواضحة إسرائيليًّا بين " تولي المنصب" وبين تحمّل مسؤوليات ذلك، وبكلمات أبسط تلائم وتُلامس واقعنا الحاليّ، ذلك النقاش حول لجان التحقيق الرسميّة، وهي مطلب الكثيرين، بل ربما الأكثريّة اليوم، باعتبارها الوسيلة الأفضل لتوضيح الحقائق ووضع الإصبع على موضع الألم،
ومحاولة البحث عن علاج، وهي قضيّة تشغل الرأي العامّ الإسرائيليّ، منذ قيام الدولة عام 1948، وهي سنوات تخلّلها قيام أو تشكيل 16 لجنة تحقيق رسميّة وفق قرارات حكوميّة، بحثت قضايا متنوّعة منها إضرام النار في المسجد الأقصى عام 1969، وحرب يوم الغفران عام 1973، وأوضاع السجون في إسرائيل عام 1979، ومذبحة صبرا وشاتيلا عام 1983( لجنة كاهان)، وأسهم المصارف والبنوك عام 1985، ووسائل التحقيق التي يتّبعها الشاباك ،عام 1987، ولجنة "أور "للتحقيق في مواجهات أكتوبر 2000 ومقتل 13 مواطنًا عربيًّا، والتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء إسحق رابين عام 1995،
وقبلها بعام لجنة للتحقيق في مذبحة الحرم الإبراهيميّ أقيمت عام 1994 ، وآخرها لجنة التحقيق في قضية الغوّاصات ولجنة التحقيق الرسميّة في مصرع 44 مواطنًا يهوديًّا في منطقة جبل الجرمق(ميرون) والتي تشكّلت عام 2021، خاصّة وأن لجان التحقيق الرسميّة الأخيرة، وبفعل تسييس كافّة الأمور والقضايا في إسرائيل وابتعادها عن الأيديولوجيّات واحترام القانون والتنصّل من تحمّل المسؤوليّة، وهو ما كان أمير اوحانا، رئيس الكنيست الحالي، ووزير الامن الداخلي عام 2021، وقت حدوث كارثة جبل ميرون، قد قال عنها حينها: "أنا مسؤول كوزير لكن ذلك لا يعني أنني مذنب"،
إضافة إلى صبغ كل لجنة تحقيق رسميّة في عهد بنيامين نتنياهو والذي يمكن الجزم أنه يمقت لجان التحقيق الرسميّة بدليل عدم تشكيل لجنة كهذه بعد حريق جبل الكرمل عام 2010 والذي أودى بحياة 44 من مستخدمي مصلحة السجون وعدد من أفراد الشرطة وخدمات المطافيء والمتطوّعين، بصبغة سياسيّة تمامًا كما حصل في قضية الغوّاصات، وتحديدًا تلك الجزئيّة المتعلّقة بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شخصيًّا على أن تبيع مصانع "تيسنكروب" الألمانيّة غوّاصات متطوّرة لمصر دون الرجوع إلى الجهات الأمنيّة والجيش،
والتي اعتبرها نتنياهو ومؤيّدوه محاولة للمسّ به سياسيًّا، تمامًا كما هو الحال اليوم بين المطالبين بلجنة تحقيق رسميّة في أحداث السابع من أكتوبر، تشمل المستويين السياسيّ والعسكريّ وتكون توصياتها ملزمة تمامًا كتوصيات لجنة "كاهان" التي ألزمت وزير الأمن حينها أريئيل شارون بالاستقالة، ولجنة التحقيق في قضية الجرمق (ميرون)،
والتي منعت وزير الأديان في حينه يعقوب أفيطان من تولي أيّ منصب وزاريّ مستقبلًا، وأوصت بمنع وزير الأمن الداخليّ حينه أمير أوحانا من إشغال نفس المنصب مرة أخرى، إضافة إلى أنها موضع جدل حيث يعتبر البعض أن إقامة لجنة تحقيق رسميّة يعني الخلط بين المسؤولية السياسيّة والمسؤوليّة الجماهيريّة والمسؤوليّة الشخصيّة التي تشمل مركب الإدانة بتهمة،
أو بتقصير مقصود، كما يتعبره البعض أنه يعني عمليًّا خلق ساحة سياسيّة بديلة عن الجمهور والكنيست، وخلق ساحة قضائيّة إضافيّة غير المحاكم يتم فيها إصدار الأحكام على السياسيّين والموظّفين الرسميّين، لكنّ السؤال الأهم الذي تثيره نتائج وملابسات التحقيق العسكريّ هو مدى استعداد الحلبة السياسيّة الإسرائيليّة لتقبّل لجنة تحقيق رسميّة تشكّلها الحكومة، خاصّة وأن الحكومة الحاليّة ترفض مجرّد الحديث عن الموضوع، وتصرّ بغالبيّة مطلقة من ائتلافها وأعضائها على أن يتمّ أولًا تحقيق النصر المطلق على حركة "حماس"، وإعادة المختطفين وإعادة النازحين من بيوتهم ومدنهم في الشمال والجنوب،
وربما سيتم إضافة أهداف أخرى يجب تحقيقها، منها مثلًا النصر على "حزب الله" أو إعادته إلى مواقع خلف نهر الليطاني وفق القرار 1701،قبل الحديث عن لجنة تحقيق رسميّة، وفوق ذلك مدى استعداد رئيس الحكومة لمثل هذه اللجنة خاصّة وأنه يمتنع منذ بداية الحرب عن إبداء رأيه في الموضوع، وليس ذلك فحسب، بل إنه يمتنع حتى عن ذكر كلمة "تحقيق"، ويكتفي بالقول كلما تمّ سؤاله عن ذلك، باستخدام عبارة" سيتم فحص كافّة الأمور، وسيضطرّ الجميع لتوفير الإجابات بما فيهم أنا". وهذا أمر يمكن أن تقوم به لجنة تحقيق برلمانيّة توصياتها غير ملزمة، وهو كما يبدو ما تشير إليه تصريحات مقرّبيه وآخرها تصريحات رئيس مجلس الأمن القوميّ، تساحي هنجبي، التي اعتبر فيها ما حدث في السابع من أكتوبر مجرد "خللًا"، وبالتالي يبقى السؤال، حتى لو تشكّلت اللجنة فهل سيتمّ تنفيذ توصياتها ؟.
وهو سؤال يؤكّد في هذا الباب، أن ما كان يناقض ويخالف سلطة القضاء بما فيها لجان التحقيق الرسميّة، سيرفض أيّ توصيات، أو قرارات تمسّ القادة والسياسيّين ولا سيّما سيعتبرون توصياتها تصفيات سياسيّة، في تعبير إضافيّ عن تردّي الثقة بالمؤسّسات القضائيّة، والقبول بالتسيّب والفساد السياسيّ، دون مساءلة أو محاسبة، وهذا يبعث على القلق، خاصّة وأنه كان من المعروف أنه ليس هناك في أيّ دولة، قوّة سياسية للجان التحقيق، كما هي الحال في إسرائيل. وهذا نهج جديد يتلاءم مع الانقلاب الدستوريّ.
على كلّ حال يبدو أن احتمالات تشكيل لجنة تحقيق رسميّة في ظلّ المعطيات الائتلافيّة والحكوميّة الحاليّة، ضئيلة حتى شبه معدومة، فهي ستؤدّي إلى توصيات تدين رئيس الوزراء نتنياهو، وتلزمه بالاستقالة خاصّة وأنه اعتلى سدّة الحكم طيلة السنوات التي تعاظمت فيها قوّة "حماس" وحصلت خلالها بموافقته ووفق طلبه على ملايين الدولارات سنويًّا، ومن هنا فإن تشكيلها لن يتم قبل الانتخابات القادمة وموعدها غير واضح، لكنّ الواضح اليوم وجرّاء تصرّفات السياسيّين والمسؤولين، ورفضهم تحمل مسؤوليّة إخفاقاتهم، أو حتى الإشارة إليها، أن إسرائيل اليوم لا تشبه تلك التي كانت قبل السابع من أكتوبر،
وكم بالحري تلك التي كانت قبل الانقلاب القضائيّ الدستوريّ، فهم كيانات سياسيّة ثلاثة مختلفة تمامًا وإن كانت نفس الدولة، فالأول وما قبل الانقلاب القضائيّ الدستوريّ، كان دولة تكن الاحترام ولو كان محدودًا وغير كامل للقوانين وجهاز القضاء، ويتحمّل قادتها مسؤوليّة وتبعات أعمالهم، وهي استمرارا ولو ضحل لما كان منذ قيام الدولة، من تحمل للمسؤوليّة ودفع أثمانها السياسيّة، كما فعل إسحق رابين الذي استقال على خلفيّة حسابٍ مصرفيّ لزوجته خلافًا للقانون، ومناحيم بيغن الذي استقال بعد أن اتّضح أنهم غرروا به حول أهداف حرب لبنان عام 1982،
وأعداد الجنود القتلى، وقبلهم دافيد العزار رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيليّ في حرب يوم الغفران، أكتوبر عام 1973، والذي استقال بعد الحرب بنصف عام بفعل توصيات لجنة التحقيق، وأخيرًا الضابط أهارون حليفة رئيس شعبة الاستخبارات العسكريّة الذي استقال بعد السابع من أكتوبر 2023، معترفًا بفشله وإخفاقه، وهو بذلك صوتٌ صارخ في البرِّيّة. أما إسرائيل بعد محاولة الانقلاب الدستوريّ، فهي كيان أراد السياسيّون فيه تخليص أنفسهم من أعباء الرقابة القضائيّة، بل أن يجعلوا أنفسهم في حِلٍّ من النزاهة الشخصيّة والأخلاقيّة،
وأن يكون جهاز القضاء خادمًا ومطيعًا يتم تعيين أفراده وفق انتماءاتهم السياسيّة والحزبيّة وولاءاتهم العقائديّة، وليس وفق مؤهّلاتهم المهنيّة وسمعتهم القضائيّة، أي وفق سجلّهم الشخصيّ والفئويّ، وليس سجل إنجازاتهم المهنيّ، وجعل الحريّات الشخصيّة قضيّة فيها نظر، بل اقتصارها على من يشاطرون السلطان والسلطة نفس مواقفها ، وجعل التعبير عن الرأي أمرًا مشروطًا برضى وزير الأمن الداخليّ الذي يعتبر التظاهر مسًّا بالأمن، ومعارضة الحكومة وخطواتها خروجًا عن الإجماع الإسرائيليّ اليهوديّ، ويريد قمع معارضيه، فكم بالحريّ موقفه من المواطنين العرب.
وكلّ ذلك وسط تنافر اجتماعيّ وسياسيّ وفئويّ يقترب من الصدام، وانهيار اقتصاديّ وصناعيّ سبّبته خطوات الانقلاب الدستوريّ، وكلّها مركّبات زادتها الحرب حدّة حيث تزايد التنافر ومشاعر البغضاء المتبادلة، والدعوات المتبادلة بين مركّبات الشارع اليهوديّ إلى الإقصاء المتبادل، وإجماع على رفض أيّ حل سياسيّ بعد الحرب، وإخراج عرب الدولة من كافّة الحسابات القضائيّة والسياسيّة والماليّة وحتى الأمن الشخصيّ والعمل والتعليم وغيره، حتى وصل الأمر حدّ صدور دعوات علنيّة إلى الفصل بين اليمين والمتدينين وبين الباقين من اليهود في دولتين، إسرائيل للمعتدلين واليسار، ودولة يهودا لليمين والمتدينين والمستوطنين، وإذا كان الأمر كذلك قبل الحرب، فقد تحوّل اليوم إلى تقديس لرئيس الوزراء واعتباره منزّهًا فوق المساءلة والتحقيق واتهام قادة الجيش بالمسؤوليّة، بل وتخوينهم واتهامهم بالتآمر على الأمن القوميّ والدعوة إلى سجنهم، إضافة إلى اتهام المعارضين سياسيًّا بالتنسيق مع قوىً أجنبيّة للإطاحة بنتنياهو وبضمنها ليس فقط أميركا بايدن، بل دول عربيّة وحتى السلطة الفلسطينيّة.
ما سبق أثار أصواتًا ونداءات لإنقاذ إسرائيل من نفسها، والتأكيد على أن ما كان هو ليس ما سيكون، وأن القادم أسوأ، بل إن إسرائيل بصيغتها الحاليّة كدولة واحدة لليهود على اختلاف انتماءاتهم السياسيّة والعقائديّة والأيديلوجيّة والدينيّة من المستوطنين يمينًا حتى اليسار، ومن المتزمتين دينيًّا حتى العلمانيّين، وإلى ذلك يضاف المواطنون العرب،
قد أنهت مهامها واستنفذت إمكانات استمرارها وبقائها، وبالتالي واستمرارًا للحديث والمخاوف حول مصير الدولة قبل بلوغها الثمانين انطلاقًا من عبر التاريخ اليهوديّ، جاء اقتراح طرحه يوجين كيندل الخبير الاقتصاديّ ورئيس المجلس الاقتصاديّ القوميّ في عهد بنيامين نتنياهو،
ومعه رون تسور المسؤول الكبير السابق في مفوّضيّة خدمات الدولة، لا يكتفي بدولتين على شاكلة دولة إسرائيل ودولة يهودا، بل يقترح إقامة ثلاثة كيانات داخليّة، أي كانتونات ، الأول يهوديّ علمانيّ ليبراليّ، والثاني يهودي توراتيّ متديّن والثالث عربيّ، دون فصلهم جغرافيًّا، يعمل كلّ واحد من هذه الكانتونات على وضع وصياغة قوانينه وقيمه وميزانيّته وتعليماته الضريبيّة وقضايا التربية والتعليم، بينما تضمن القوانين الفيدراليّة ( قوانين الدولة العامّة) عدم تدخّل السلطات العامّة في شؤون الكانتون الداخليّة،
وأن يتم تعيين السلطة الفيدراليّة، وليس انتخابها منعًا لسيطرة تامّة لفئة دون أخرى، بحيث تُعنى السلطة الفيدراليّة بالشؤون الخارجيّة والأمن والصحّة العامّة وجودة البيئة، والبنى التحتيّة القوميّة والعامّة، أما الميزانيّة العامّة، أو الفيدراليّة للدولة فهي حصيلة ميزانيّة الكانتونات الثلاثة ووفق عدد سكان كلٍّ منها، على أن تشمل الخدمة الأمنيّة العسكريّة الإجباريّة جميع المواطنين في كافّة الكانتونات. وهو اقتراح ينطلق من الإدراك الواعي لحقيقة التنافر والانقسام الداخليّ في إسرائيل قبل وخلال الانقلاب الدستوريّ وبعده خاصّة، وهي انقسامات زادت من مشاعر التفتّت الداخليّ وضعضعة مكانة الهيئات الرسميّة والقضائيّة وذلك بدعمٍ وتشجيعٍ ومبادرة من المستوى الحزبيّ والسياسيّ،
وصولًا إلى استبدال للوحدة ومشاعر التعاضد والتكاتف بتوجّهات "نحن" و "هم"، وأحيانًا "نحن " أو "هم"، بينما يأتي الاقتراح الجديد في محاولة لوضع حدّ لتنامي مشاعر الكراهية الداخليّة والعنف الداخليّ، عبر الكفّ عن فرض قواعد لعبة ،موحّدة وواحدة ومشابهة على الجميع رغم اختلاف انتماءاتهم ومواقفهم وأجنداتهم، بمعنى أن استمرار وجود الدولة رهن بتحطيم المفهوم القديم، بل الكلاسيكيّ حول كون منظومة واحدة من القوانين والتعليمات والتوجّهات، حتى لو تم فرضها عنوة، سببًا لوجود وبقاء الدولة، والانتقال إلى مفهوم آخر يقول إن بقاء الدولة للعقود القادمة ممكن فقط إذا توقفت محاولات فرض منظومة موحّدة وواحدة وجماعيّة من القوانين والأنظمة التي تضعها الأغلبيّة، دون استشارة الأقليّة، ودون الأخذ برأيها وأحيانًا رغم أنفها،
علمًا انه من الواضح أن أربعة شروط يجب أن تتوفّر لضمان نجاح هذه الفكرة وفقًا لأصحابها، أي الكانتونات الثلاثة، وهي عدم فرض القيم بالقوة السياسيّة أو غيرها، وضمان كون هذا الترتيب والشروط غير مؤّقت وغير قابل للتراجع عنه، بل أبديّ ودائم، وخلق مسؤوليّة اقتصادية ووعي مالي لجميع الفئات والقطاعات وتشكيل حكومة مهنيّة- تكنوقراط- وناجعة.
خلاصة القول، أن إسرائيل بعد الحرب الحاليّة لن تعود إلى سابق عهدها، فما كان لن يكون، فالانقسامات خطيرة وبعضها غير قابل للردم والندوب عميقة وبعضها لن يُشفى. أما مشاعر الوحدة الحالية والتي بدأت تتصدع فسببها الحرب، ومصيرها أن تنتهي بانتهائها لتحلّ محلّها مشاعر الكراهية المتزايدة تحت شعارات "إمّا نحن أو هم" وشعور الطرف الخاسر أيًّا كان أن الطرف الفائز يسرق له موطنه ودولته،
ويغيّر وجهها وشكلها ووجهتها دون رجعة، وبالتالي هذا هو وقت وساعة القيادات الحقيقيّة التي لا تكتفي بتولي المنصب ونعَمِه، بل تتحمل مسؤوليّته وتبعاته بنجاحه وفشله وتدفع الثمن إذا لزم الأمر، وتدرك أن المنصب تكليف وأمانة وليس تشريفًا وحصانة، وتدرك القول الصحيح أن المناصب لا تصنع الرجال، فهي فقط تمنحك لحظة ضوء قد تضيء أو تحرق، فهل ستفهم القيادات هذه اللحظة، وهل ستكون لحظة تنير الطريق، وتضمن وحدة الدولة وبقائها، ام تحرق الأخضر واليابس، أو ما تبقى منه، وتنتهي إلى تقسيم وتفكيك لا رجعة فيه؟