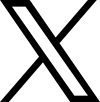التطرّف في كلا الاتّجاهين مآله الخراب والدمار
بخلاف الاعتقاد السائد بين كثيرين في عالمنا وحتى في بلادنا، من أن سلطة قويّة في دولة ما، وحتى متطرّفة سياسيًّا ودينيًّا، وربما متهوّرة ومندفعة ومغامرة، هي الردّ الشافي والوافي على التهديدات التي تشكّلها سياسات الدول الجارة، أو تلك المتنازع معها، جغرافيًّا أو سياسيًّا, أو اقتصاديًّا أو عقائديًّا، بل إنها الرادع والوازع لكافة التوجّهات المتطرّفة المعادية والمقابلة.

وهو اعتقاد سمعناه كثيرًا بعد الانتخابات البرلمانيّة الأخيرة في إسرائيل، والتي تمخّضت ائتلافًا يمينيًّا متطرّفا سياسيًّا ودينيًّا واجتماعيًّا، إذ تردّد على لسان المحلّلين والسياسيّين الذين أكّدوا أن هذه النتائج التي أفرزتها تلك الانتخابات ستشكّل رسالة هامّة، ملخصها أن إسرائيل حسمت أمرها، وأنها بحكومتها الحاليّة، وسياساتها التي كانت واضحة منذ البداية وحتى قبل إعلان برنامجها الائتلافيّ، ستشكّل رادعًا لكافّة الحركات المتطرّفة السياسيّة والدينيّة في المنطقة وخاصة" حزب الله" و"حماس" وحتى الفلسطينيّين كافّة في عرف اليمين الإسرائيليّ،
بما في ذلك السلطة الفلسطينيّة، وبعدها إيران والتي كرّر كثيرون تصريحاتهم بأن الحكومة الحاليّة هي الرادع لإيران من مواصلة تسلّحها، أو مشروعها النوويّ، وهو الرادع لكلّ من تسوّل له نفسه أن يرفع راية المنافسة، أو المواجهة، وهو نفس الاعتقاد الذي ساد روسيا فلاديمير بوتين، قبل أن تقرّر اجتياح أوكرانيا، فهي اعتقدت أن تطرّفها السياسيّ والعسكريّ، وإعلان الحرب على أوكرانيا، وقبل ذلك تحذيراتها المتواصلة من مغبّة انضمام أوكرانيا إلى الإتحاد الأوروبيّ، ستشكّل رادعًا لمواقف أوكرانيا التي اعتبرتها موسكو تطرّفًا وعداءً وانفصاليّة،
بل وتهديدًا عسكريًّا، دون أن يتمّ ذلك ، وليس ذلك فقط فقد خاب اعتقاد روسيا في أن تشدّدها العسكريّ، سيردع أوكرانيا بعد فترة ويجعلها تتراجع ليتّضح العكس، وهو ما كان قبل سنوات حين انتخب الأمريكيّون دونالد ترامب رئيسًا، ليردّد البعض تصريحات حول كون تشدّد ترامب الاقتصاديّ وسياساته الاقتصاديّة خاصّة تجاه الصين ، وكونه شخصيّة سريعة الغضب والتهوّر، سيردع موسكو سياسيًّا وبكين اقتصاديًّا، وهو ما حاول ترامب فعله بفرض الضرائب على الصادرات الصينيّة والجمارك بمئات مليارات الدولارات، دون أن يؤدي ذلك إلى تضييق الخناق على الصين باعتبارها المنافس الاقتصاديّ الأوّل، بل الوحيد في العالم للولايات المتحدة، بل بالعكس حيث كانت النتيجة اتّجاه الصين إلى فتح أسواق جديدة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها، وكلّها أمثلة تؤكّد أن التطرّف لا يشكل رادعًا، أو أنه لم يعد يشكّل رادعًا، خاصّة اليوم ونحن في عالم تتبدّل فيه التحالفات من جهة،
ويغذي التطرّف في طرف من النزاع تطرّفًا في الجهة الأخرى، يؤدّي إلى التصعيد انطلاقًا من آيديولوجيّات الحركات المتطرّفة والدول المتطرّفة التي لا تقبل الحلول الوسط ولا الحوار العقلانيّ، فدينهم وديدنهم عدم الاستقرار ومحاولة إذكاء نيران الخلاف والحرب السياسيّة والعسكريّة، ونهايتها بالنسبة لهم واحدة ووحيدة هي القضاء نهائيًّا على الخصم.
هكذا هي الوقائع على الأرض في كافّة نقاط ومحاور الخلاف في العالم اليوم، فالتشدّد يغذي التشدّد، والتطرّف يزيد التطرف حدّة، وعلى نقيض القول العلميّ إن اللقاء في الدوائر الهندسيّة يتم بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، بمعنى أن أقرب نقطتين في كلّ دائرة هما أقصى اليمين وأقصى اليسار، فإن دائرة الصراع الحاليّ في المنطقة على جبهاته الخارجيّة الثلاث، غزة والحدود اللبنانيّة وإيران ومعها حلفائها وأتباعها في اليمن والعراق وغيره، تجعل من الممكن القول بما يقترب من التأكيد على أن مصالح المتطرفين تتقاطع وأن توجّهاتهم تلتقي،
وأن وجود واحد منهم يغذي الآخر، أو لا يردعه على الأقلّ، بل ربما يزيد من تطرّفه اعتقادًا منه أنه بذلك يردّ على التطرّف باللغة التي يفهمهما، متناسين القول المعروف للفيزيائيّ والرياضيّ والفيلسوف فرنسي بليز باسكال: "يقود التطرّف إلى التهوّر ويُفضي الاعتدال إلى الحكمة"، وأن الحديث عن تشدّد في طرف ما يردع التشدّد المقابل، إنما هو فهم خاطئ لطبيعة النزاعات والصراعات خاصّة بعد الحرب العالميّة الثانية، والتي كانت الحرب الأخيرة التي نجحت فيها دول ما، عبر قوّتها العسكريّة بإنهاء عهد توجّهات متطرّفة ومتشدّدة هي النازيّة والفاشيّة، ككيانين سياسيين فقط، بإخضاع ألمانيا النازيّة واليابان،
وليس بهزم الأفكار المتطرّفة التي تبنتها ألمانيا، فالأفكار النازيّة ما زالت قائمة وماثلة حتى اليوم، فالتطرّف سياسيًّا كان أم دينيًّا، هو فكر لا يمكن إخضاعه بقوّة السلاح. وهذا ما يرفض كثيرون في منطقتنا والعالم إدراكه، فيكرّرون مرّة تلو الأخرى نهج محاولة إخضاع الطرف المقابل المتطرّف، أو الذي يعتبرونه متطرّفًا بقوّة السلاح، أو العقوبات الاقتصاديّة والسياسيّة والمقاطعة، ويكون الفشل حليفهم كما فشلت أميركا في أفغانستان والعراق وغيرها، وكما يحدث اليوم في الحرب المتواصلة في غزة، فزيادة التشدّد اليمين والدينيّ في إسرائيل وتعنّت حكومات اليمين المتعاقبة في إسرائيل ، وتضاؤل قوّة اليسار، أو ما يسمّى باليسار الإسرائيليّ،
وهو في الحقيقة يمين من حيث المنطلقات، ويسار من حيث الممارسة والوسائل، لم يردع الجماعات المتشدّدة فلسطينيًّا وتحديدًا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلاميّ"، بل كانت نتائجه عكسية فهي أضعفت السلطة الفلسطينيّة وأنهكتها، بل أفرغتها من محتواها. وهذا ما يصبّ عمليًّا في مصلحة الفصائل الفلسطينيّة المتشدّدة والمتطرّفة، التي استفادت من هذا التشدّد، لتسويق فكرتها وأجنداتها التي تؤكّد أن الجهاد هو السبيل الوحيد لتحرير الأرض، وأن إسرائيل لا تريد التفاوض ولا تبحث عن السلام، ولا تنوي الاعتراف بأيّ من حقوق الشعب الفلسطينيّ، وبالتالي يجب اتّخاذ كافّة الوسائل، لتحقيق ذلك بوسائل عسكريّة تستوجب بناء الأنفاق وشراء الأسلحة وتصنيعها واستغلال أيّ فرصة ممكنة، لتحقيق إنجاز عسكريّ ولو مؤقّت، وإفهام إسرائيل أن "حماس" والمقاومة الفلسطينيّة وفق الوصف الفلسطينيّ، جاهزة لمواجهتها ليس فقط عبر مواجهات محدودة وحملات عسكريّة تمتدّ أسبوعًا، أو شهرًا، بل عبر حرب حقيقيّة كان السابع من أكتوبر 2023 ذروتها وقمّتها، في عمليّة عسكريّة شكّلت الدليل القاطع لكلّ من أراد أن التشدد في عرف "حماس" نهج حياة وبالتالي فإن التشدّد المقابل يغذّيه ويعزّزه.
والعكس صحيح، فتشدّد حركة "حماس" وإصرارها على نهج الجهاد والتسلّح وحفر الأنفاق، دون الخوض حاليًّا في أسباب ومصادر التمويل ومن وافق وشجع ودعم، ومواصلة إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه الأراضي الإسرائيليّة، ومعه تعزيز قوّة ونفوذ وتواجد مسلّحي الحركة في الضفة الغربيّة والعمليّات العسكريّة التي ينفذونها ضد الإسرائيليّين من جنود ومستوطنين، لم تخفّف من تشدّد الحكومات الإسرائيليّة المتعاقبة في موضوع رفض الحوار معها، ولم تخفف من التشدّد في التوجّهات الاستيطانيّة والرافضة لأيّ تفاوض مع الفلسطينيّين، وأي انسحاب من الضفة الغربيّة، بل بالعكس فقد ازدادت حدّة هذا التشدّد ووصل إلى البرلمان ممثّلون ووزراء لا يكتفون برفض الانسحاب التامّ من الضفة الغربيّة وبناء ميناء في غزة فحسب، بل يرفضون أيّ مفاوضات،
وأي انسحاب مهما كان مختصرًا ويطالبون بالضمّ، كما يرفضون أصلًا أيّ محاولة لمنح غزة كمنطقة تسيطر عليها حركة "حماس" أيّ سمة من سمات السيادة والكيان، وأيّ منفذ إلى العالم الخارجي لا تتم السيطرة عليه ومراقبته، والنتيجة في عهد حكومة التغيير برئاسة نفتالي بيني وبعده يائير لبيد، منع وصول المال القطريّ إلى غزة، وبعدها حتى اعتبار لقاء الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس من قبل الوزير بيني غانتس، عملًا مرفوضًا ووصمة عار، ناهيك عن ازدياد التشدّد بكلّ ما يتعلّق بالحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى وغيره، وصولًا إلى ما نحن عليه اليوم من حرب شعواء ومحاولات لتغيير الوضع القائم، تنذر بمواجهة إقليميّة، أو مع دول تربطها بإسرائيل حتى اليوم معاهدات سلام، وكلّ ذلك وسط إيمان مطلق وسط المتشدّدين المتديّنين اليهود أنصار المستوطنين أن الحرب والنزاع هما ما يوحّد الشعب في إسرائيل.
في الشأن الإيرانيّ، لا يختلف الوضع فالتشدّد الذي أبدته الولايات المتحدة بتشجيع من بنيامين نتنياهو وقرار الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب عام 2018، الانسحاب من الاتفاق النوويّ، وفرض العقوبات الاقتصاديّة المتشدّدة، وتجميد الأصول الماليّة ومنع استيراد النفط الإيرانيّ أو تكريره، لم يغيّر ولم يخفّف من التشدّد الإيرانيّ السياسيّ والعسكريّ والأيديولوجيّ الذي يعتبر امتلاك الأسلحة النوويّة جزءًا من توجّهات ولاية الفقيه وواحدة من طرق نشر الدعوة الخمينيّة ومواجهة إسرائيل وأميركا، واستعادة أمجاد الإمبراطورية الفارسيّة، وبسط السيطرة على منطقة الخليج ، وتسليح منظّمات شيعيّة، وأخرى مسلّحة في مختلف بقاع الشرق الأوسط، خدمة لأهداف طهران وتنفيذًا لطموحاتها الإقليميّة والدينيّة،
وهو الحال بالنسبة لتشديد المواقف الإسرائيليّة، ورفضها لأيّ اتفاق دوليّ يضمن رقابة عالميّة على النشاطات النوويّة الإيرانيّة ، والذي تضاف إليه عمليّات عسكريّة متنوّعة تنسبها وسائل إعلام غربيّة، وربما إسرائيليّة إلى إسرائيل منها هجمات سيبرانيّة على منشآت نوويّة إيرانية واغتيال لعلماء بارزين منهم مسؤولون كبار عن المشروع النوويّ كلّه، وكذلك مسؤولون عسكريون إيرانيون ينشطون في إدارة التمدّد العسكريّ الإيرانيّ في مناطق الشرق الأوسط، ومنهم قاسم سليماني وغيره،
لم تنجح في كسر وتحطيم هذا التشدّد ووقفه عند حدٍّ معيّن يمكن التعايش معه، وصولًا إلى ما نحن عليه اليوم من حيث درجة تخصيب اليورانيوم واقتراب إيران من قنبلة نوويّة، تحاول واشنطن منذ عام 2020 وبداية عهد جو بايدن، استخدام الوسائل الدبلوماسيّة، لمنع هذا الوصول، لتنجح في إبطاء وتيرة التخصيب دون وقفه، وهو ما فشلت فيه تصرّفات وسياسات التشدّد الأميركيّ والإسرائيليّ طيلة سنوات.
وهو الحال وبشكل متبادل بكلّ ما يتعلّق بالمواجهة بين "حزب الله" وإسرائيل، فتعاظم "حزب الله" عسكريًّا وامتلاكه الصواريخ الدقيقة وبعيدة المدى وتشدّده السياسيّ داخل لبنان، وتحوّله باعتراف الكثيرين الى جهة آمرة وناهية في لبنان، يمثّلها في البرلمان اللبنانيّ أعضاء وفي الحكومة اللبنانية وزراء تسيطر على مقدرات الدولة، وتحدّد سياساتها الخارجيّة، لم يخفّف من تشدّد مواقف إسرائيل تجاهها واعتبارها جهة خطيرة على أمن إسرائيل كلّها، وليس المنطقة الشمالية فحسب، وهو ما نراه اليوم خلال الحرب الحاليّة وآخرها عمليّات التفجير التي طالت أجهزة اتّصال يستخدمها مسلّحون ومنتسبون مدنيّون تابعون لحركة "حزب الله" وإيران في سوريا ولبنان، واغتيال شخصيّات قيادة للحزب في مناطق لبنان المتعدّدة ومنها الضاحية الجنوبيّة في بيروت ومنهم فؤاد شكر،
وقيادات قوة "رضوان "العسكريّة وغيرها من الضربات، وبالمقابل لم تنجح هذه الردود الإسرائيليّة القاسية في تخفيف رغبة "حزب الله" في المواجهة وإطلاق الصواريخ والمسيَّرات باتّجاه اسرائيل وتوسيع رقعة المواجهة، وبالتالي يمكن الجزم أنها معادلة يغذّي التشدّد من طرف واحد التشدّد في الطرف الآخر، ويشكّل في نظر مؤيّديه مبررًا لممارسته من جهة وللردّ على تشدّد الطرف الآخر بكافّة، وفق مبدأ " والبادئ أظلم" نحو دائرة مفرغة من العنف والعنف المتبادل، تخاطب المشاعر الدفينة، بل الغرائز البدائيّة، لا تكترث للعواقب، وهو ما يحدث اليوم خاصّة في قطاع غزة من حيث الحقيقة الساطعة، والتي تقول أن استمرار الحرب هناك منذ عام تؤكّد أن التشدّد يُذهب المنطق، وأنه لا يترك للعقل مجالًا ، وبالتالي لا تكترث القيادات المتشدّدة بمصير مواطنيها وحالهم، فأجنداتها ومنها شخصيّة وحزبيّة وفئويّة هي الأهمّ.
والأمر لا يقتصر على التشدّد العسكريّ بين العداء على جانبي الحدود، بل إنه يصل السياسة والقضايا الداخليّة ايضًا، وهذا ما تشهده إسرائيل منذ نحو أربعة أعوام، عبر تشدّد وتمترس سياسيّ في اليمين من جهة، وفي المركز واليسار من جهة أخرى، غذيَّا بعضهما بعضًا وصولًا إلى أربع انتخابات انتهت دون تشكيل حكومة قابلة للحياة، وبشكل خاصّ بداية عهد الحكومة الحاليّة، أي منذ انتهاء الانتخابات بفوز معسكر اليمين بأربعة وستين مقعدًا في البرلمان، وتشكيل حكومة بنيامين نتنياهو السادسة، والتي انتهجت وبنشوة الفوز البرلمانيّ، التشدّد السياسيّ، ووجّهت سهامها وتشريعاتها القاسية نحو الجهاز القضائيّ معتبرة إيّاه العدوّ الأوّل في تعبير عن العداء الذي يكنّه الجناح اليمينيّ الاستيطانيّ في الحلبة السياسيّة والحزبيّة الإسرائيليّة للجهاز القضائيّ على خلفيّة قرارات وتركيبة محكمة العدل العليا، ومحاولات اليمين السيطرة على الجهاز القضائيّ بكافّة هيئاته ومراحله، وبالتالي إرخاء الحبل على غاربه، لتعيينات سياسيّة وفساد سلطويّ،
مع رفض أيّ محاولة للوساطة، أو للحلول الوسط، بل خوض تشريعات دون منح المعارضة أيّ إمكانيّة للتعبير عن المواقف وجلسات مطوّلة للجان البرلمان فقط، لبحث وتسريع الانقلاب الدستوريّ، وتهديد للقضاة والمستشارين القانونيّين، ومحاولات لإفراغ دور الجهاز القضائيّ والتشريعيّ من مضمونه، وتحويل البرلمان إلى ختم مطاطيّ للحكومة وهي السلطة التنفيذيّة، يطيع أهواءها ويمتنع عن رقابتها،
في تشدّد أدّى إلى احتجاجات عالميّة وهروب للاستثمارات الخارجيّة والأدمغة وشركات الهايتك وتحذيرات من شركات التصنيف الائتمانيّ بخفض مستوى التصنيف الائتمانيّ الإسرائيليّ وغير ذلك، ليقابل هذا التشدّد بل التهوّر، بتشدّد مقابل من المعسكر الرافض للانقلاب الدستوريّ الذي استطاع وطيلة نحو أربعين أسبوعًا تنظيم مظاهرات أسبوعيّة وأيام تشويش والإصرارعلى منع الانقلاب، بل أخرج عشرات الآلاف إلى الشوارع ردًّا على قرار رئيس الوزراء نتنياهو إقالة وزير أمنه يوآف غالانت ممّا اضطرّه للتراجع عن قراره،
وهو تشدّد ازدادت وتيرته الشعبيّة ومظاهره القضائيّة والبرلمانيّة والإعلاميّة بشكل متواصل وبموازاة التشدّد التشريعيّ، بشكل ما زال حتى اليوم رغم توقّفه لأسابيع بسبب الحرب، ليتّسع نطاقه وحدته المتبادلة، وصولًا إلى حالتنا اليوم من تقاطب وتنافر داخليّ يؤكّد كثيرون أنه التهديد الداهم على إسرائيل، وأنه أشدّ خطورة من كافّة التهديدات الخارجيّة، بل ينذر باحتمالات صعبة منها الحرب الأهليّة والانقسام إلى دولتين، والأمثلة على ذلك كثيرة خاصّة في منطقتنا.
ما سبق يعيدني إلى كتاب" المؤمن الصادق" لمؤلّفه المفكر الأمريكيّ إيريك هوفر الذي يثبت خطأ الاعتقاد، أو القول أن هناك تناقضًا بين الحركات المتطرّفة والمتشدّدة، وأضيف هنا خاصّة دينيًّا وعقائديًّا، حتى لو كانت هذه الحركات تحارب بعضها، بل إن هذه الحركات والتوجّهات والحكومات والدول المتشدّدة والمتطرّفة تقف في موقع واحد معًا، دون فارق بينها فطروحاتها مختلفة وروحها ومضمونها واحد، وبالتالي لا نقاش ولا خلاف، وربما لا فارق أو فوارق بينها. فالمتطرّفون سواسيّة لا فارق بينهم، أما الفارق الحقيقي فهو بينهم جميعًا، وبين العقلاء،
والنتيجة واحدة، وهي أن لا لقاء في الفكر بين الجهتين، فالعداء بين الحركات المتطرّفة وفق إيريك هوفر هو خلاف بين إخوة أعداء، وهو ما يُفسّر ربما حالات كثيرة انتقل فيها يساريّون متشدّدون في إسرائيل مرّة واحدة إلى أقصى اليمين، ومنهم الوزير الأسبق يوفال شتاينتس والكاتب إيال ميجد " وتحوَّل شيوعيّون ملحدون فيها إلى دعاة إسلاميّين ومتشدّدين للغاية. والأمثلة حتى في مجتمعنا العربيّ في إسرائيل كثيرة ومتعدّدة وبارزة،
وغيرها من تحوّلات. ومن هنا يؤكّد هوفر صعوبة، بل استحالة تحويل متشدّد عن مواقفه بالحوار العقلانيّ والمنطقيّ، الذي يجبره على التفكير والمقارنة والمقاربة، وربما تقديم التنازلات، فالمتطرّفون والمتشدّدون يرفضون، بل يخافون الحلول الوسط، أو أنصاف الحلول، ولذلك من الصعوبة إقناعهم بتخفيف حدّة تشدّدهم، بل إن التشدّد المقابل يعزّز شعورهم بصدق تشدّدهم وصحّته، بل نجاعته وضرورته، فالأسهل لهم هو التمسّك، بل الالتصاق بكيان، سواء كان شخصًا أو حزبًا، أو دولة أو معتقدًا سياسيًّا أو دينيًّا.
وإظهار وتأكيد الولاء الأعمى لهذا الكيان، انطلاقًا من معرفتهم لضعف كيانهم الذاتيّ، وأن لا قيمة لهم خارج هذا الإطار، ومن هنا الطريق قصيرة نحو التمسّك المرعب والغيبيّ بمواقف وأفكار وطروحات، يعتبرونها مقدّسة تستحق في نظرهم خوض الحرب من أجلها، ثمّ يبحث عن غيرها إذا ما شعر بالهزيمة، أو إذا انتهى دوره المرحليّ، وعلى سبيل المثال الانتقال من حركة "المجاهدين" ضد التواجد الروسيّ في أفغانستان إلى منظّمة،
أو تنظيم "القاعدة" وبعدها "طالبان"، وبعدها "داعش" وحركة" الشباب " في الصومال وغيرها وغيرها، وكذلك الحركات النازيّة الجديدة التي تعود إلى الحياة في المانيا وبولندا بعد هزيمتها أيّام الحرب العالمية الثانية، والحركات الدينيّة المختلفة التي تتجاوب مع بعض مواقف هذه الحركات.
إن عالمنا اليوم ابتداءً من أوروبا فلاديمير بوتين الروسي وفلودومير زلينسكي الأوكراني مرورًا بفيكتور أوربان في هنغاريا والأحزاب اليمينيّة الأخرى في أوروبا، مرورًا بأنصار ومؤيّدي دونالد ترامب في الولايات المتحدة والمتطرّفين الجدد مع اختلافهم في الأرجنيتن والبرازيل وغيرها في جنوب أمريكا، وانتهاءً بشرقنا الذي يعاني التشدّد في كافّة مواقعه وجبهاته، ليشهد حروبًا متتالية وممجوجة الأسباب والمبررات،
هو المثال على خطورة التشدّد وضرورة البحث عن سبل لوضع حدّ له. وهو ما لا يمكن للأفكار الديمقراطيّة أن تفعله، فهي لا توفّر للمتطرّفين قضايا مقدّسة ولا جماعات تُلغي الفرديّة، فيصبح المواطن رقمًا في جماعة متشدّدة تحارب جماعات أخرى، ومأساتنا أن كلًّا منها يؤمن أنه صاحب الحقّ، وأنه يملك الحقيقة المطلقة، وهذا هو الوصفة الأكيدة لحروب طويلة ونزاعات تدوم وتدوم توقع القتلى والجرحى وتهدم الاقتصاد والمستقبل، وسياسيّون وزعماء يستغلّون ذلك متناسين القول الشهير للحكيم فولتير:" الخلاف الطويل ، يعني أن كلا الطرفين على خطأ".