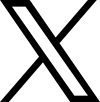حرب غزة بين القانون المُتاح والعمل العسكريّ المُباح
في علاقة يسودها التناقض والتوافق والتوازي والتقاطع في آنٍ واحد معًا، تتعايش وتتواجد، بل تختلط في ساحات الحرب في العصر الحديث عامّة، وسنوات ما بعد الحرب العالميّة الثانية خاصّة، أصوات المدافع وأزيز الرصاص وضجيج الطائرات والدبابات والتصريحات الحربيّة الرنّانة، بأصوات الحديث عن حقوق الإنسان وحريّة الرأي والتعبير والقانون بشقيه المحليّ والدوليّ

وضرورة ضمان عدم المسّ بحياة المواطنين الأبرياء، والذين يحلو تسميتهم" غير المتورّطين في الحرب".
وذلك انطلاقًا من قوانين وأعراف دوليّة يتزامن الحديث عنها مع الحروب والحملات العسكريّة عامّة، وتلك التي تدور في الشرق الأوسط خاصّة، ومنها سوريا ولبنان والعراق والضفة الغربيّة وقطاع غزة، والتي تسودها حالة مشتركة هي " الخلط"، أو الاختلاط بين الجماعات العسكريّة المسلّحة ومنها "داعش" في سوريا والعراق، و"حزب الله" في لبنان و"حماس" و"الجهاد الإسلاميّ" في قطاع غزة، وبين المدنيّين.
وهو ما تؤكّده من جهة إسرائيل، المرافقة اللصيقة والدائمة، التي رشح الحديث عنها، للمستشارين القضائيّين للعمليّات العسكريّة الإسرائيليّة ضد قطاع غزة، وذلك لضمان " سلامة" المشاركين فيها في مرحلة ما بعد الحرب، ومنع محكمة الجنايات الدوليّة من تقديم لوائح اتهام بحقّهم، وربما إصدار أوامر اعتقال ضدّهم، كما حدث مع ضباط ومسؤولين منهم وزيرة الخارجيّة السابقة تسيبي ليفني وقائد المنطقة الجنوبيّة الأسبق الضابط دورون ألموغ، ومواجهة الضغوط الدوليّة والأمميّة خلال الحرب، والاستجابة لطلبات وتمنيات دول العالم المختلفة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة هذه المرة ورئيسها جو بايدن، الالتزام بالقوانين الدوليّة وضمان حقوق الإنسان، أو ما يسمى " الممرات الإنسانيّة" والمساعدات الغذائيّة، وتقليص المسّ بالمدنيّين ومنع "كارثة إنسانيّة"، فهي دولة ذات سيادة وتخضع سواء شاءت أم أبت، للقوانين الدوليّة نفسها التي تطالب الآخرين الالتزام بها، خاصّة تلك التي تتعلّق بالمدنيّين وغير المسلّحين،
وهنا يجب القول إن الأمر ينطبق أيضًا على حركة "حماس" رغم أن عددًا كبيًرا من الدول في العالم وفي مقدّمتها إسرائيل، أعلنت حركة "حماس"، تمامًا كما "حزب الله"، حركة إرهابيّة، وهو تصنيف سياسيّ وليس قانونيّ فحسب، يهدف بالأساس إلى نزع صفة السياسيّ عنها، من جهة، وإخراج ما تفعله من دائرة السياسيّ والعسكريّ إلى حيز العمل الإجراميّ الذي لا تحكمه المعايير الدوليّة والقانونيّة، بل مشاعر الكراهية والانتقام والعداء.
هنا لا بدّ من الإشارة إلى أن القوانين الدوليّة تنطبق في حالتنا الحاليّة، أي الحرب في قطاع غزة، والتي تنهي اليوم أسبوعها الثالث، على الطرفين المشاركيْن فيها ونقصد إسرائيل، وحركة "حماس"، فالقانون الدوليّ، وخاصّة البند الثالث من ميثاق جنيف الرابع لحماية المدنيّين من ويلات الحرب، يؤكّد ذلك، وينصّ على أنه في حالة قيام، أو اندلاع نزاع مسلّح بين طرفين، يجب على كلّ طرف أن يلتزم بعدم المسّ بأولئك الذين لا يشاركون بشكل مباشر في العمليّات العسكريّة، أو تلك المسمّاة "الأعمال العدائيّة"، سواء كانوا من المدنيّين، أو حتى من المسلّحين الذين ألقوا أسلحتهم، وعدم المسّ بالأطفال، أو المسنّين والأشخاص العاجزين عن القتال، فضلًا عن عدم المسّ بالمختطفين والرهائن،
ومعاملتهم في كافّة الأحوال، معاملة إنسانيّة، علمًا أن ما سبق يمنع بشكل مطلق أيّ اعتداء على ألأبرياء وخاصّة القتل بجميع أشكاله، والتسبّب بجروح والحرمان من العلاج الطبيّ الضروريّ واللازم، والتعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصيّة ( وهو أمر حتمته الدلائل عن عمليّات اغتصاب واسعة نفّذها جنود وأفراد مليشيّات مسلّحة في الشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها)، إضافة إلى تحريم ومنع إصدار الأحكام والعقوبات دون إجراء محاكمة، حتى لو كان الأمر يتعلّق باعتقال مسلّحين نفذوا اعتداءات، مع السماح لهيئة إنسانيّة كاللجنة الدوليّة للصليب الأحمر، بزيارتهم والاطّلاع على أوضاعهم، حتى ولو كانوا ينتمون إلى منظّمة مسلحة لا تعتبر وفق القانون الدوليّ، أو القوانين في إسرائيل، كيانًا سياسيًّا معترفًا به عالميًّا ودوليًّا.
قضيّة الرهائن، أو المختطفين من الرجال والنساء من مختلف الأعمار من المدنييّن والجنود، وكم بالحريّ الأطفال، الذين أسرهم أو اختطفهم مسلحو حركة "حماس" حازت على اهتمام العالم عامّة وأوروبا والولايات المتحدة خاصّة، لأسباب كثيرة، أوّلها أو منها أن بعضهم، يحمل إلى جانب الجنسيّة الإسرائيليّة، جنسيّة أوروبيّة، أو أميركيّة (وبالتالي كان عدد من أولئك أول من يتم اطلاق سراحهم من أسر حماس)، إضافة إلى ما تمّ نقله عن بعض مسلّحي "حماس" الذين تم التحقيق معهم بعد اعتقالهم،
والذين كشفوا النقاب عن أن التعليمات والأوامر التي تلقوها، نصّت على اعتقال، أو اختطاف أكبر عدد ممكن من الرهائن من النساء والرجال والأطفال، وليس الجنود فقط، ما يؤكّد أن حركة "حماس" أخرجت نفسها من سياق، أو مصاف الدول، أو الكيانات ذات السيادة، وأنها لا تعتبر نفسها كذلك، فالتاريخ لا يشمل الكثير من الأمثلة التاريخيّة التي تذكر، أو تثبت وجود دول ذات سيادة، وضعت في مقدّمة سلّم أولوياتها اختطاف، أو قتل أكبر عدد ممكن من المدنيّين،
باستثناء حالتين شهيرتين منهما الأوامر التي أصدرها عام 1944 هاينرخ هيمل قائد المخابرات الألمانيّة والغستابو لقتل مئة رهينة مقابل كلّ جندي يقتله مسلّحون في تشيكيا، واوامر مشابهة صدرت للجنود اليابانيّين في مانيلا العاصمة الفليبينيّة في نفس العام، علمًا أن هذه الأوامر والتعليمات التي صدرت عن قيادة "حماس" تعني أن المنظمة ليست كيانًا ذات سيادة، أو سلطة تحترم القانون الدوليّ،
ومن هنا فإن بنود القوانين الدوليّة المتعلّقة بالحرب (ميثاق جنيف الرابع من العام 1949) لا تنطبق عليها، باستثناء البند الثالث، الذي يلزم الدولة ذات السيادة وهي إسرائيل في حالتنا اليوم، بضرورة توفير شروط الحياة الأساسيّة للمواطنين في الطرف الثاني، بمعنى الغذاء والماء والدواء وعدم المسّ بالمدنيّين، وعدم قتلهم عمدًا أو أسرهم. وهو البند الذي حذار لإسرائيل من عدم تنفيذه، فهو عمليًّا يرسم حدود المسموح والممنوع، بمعنى أنه يتيح لإسرائيل فعل كلّ ما تريد، باستثناء القتل العمد للأبرياء، بما في ذلك هدم البنى التحتيّة في قطاع غزة كلّها أو بعضها، بغية الوصول إلى ما تسميه إسرائيل" غزة التحت أرضيّة"، أي سلسلة الأنفاق التي تتحدّث إسرائيل عن وجودها تحت مدينة غزة ، وهي كلّها وفق القانون الدوليّ أهداف عسكريّة مشروعة، بفعل كون "حماس" حركة عسكريّة، ومن هنا الحديث الإسرائيليّ المتواصل عن عمليّة عسكريّة بريّة، تنتهي كما أعلنت إسرائيل إلى القضاء على حركة "حماس" عسكريًّا وسياسيًّا وتنظيميًّا، وهو هدف وإن كان كثيرون يشكّكون في إمكانيّة تنفيذه وتحقيقه، يشكِّل اعترافًا إسرائيليًّا صريحًا بفشل النهج الذي تبنته إسرائيل في السنوات الخمس عشرة الأخيرة ، ومنها 14 سنة كان نتنياهو فيها رئيسًا للحكومة، والذي اعتبر "حماس" حالة يمكن التعامل معها أو مواجهتها ، وتهديدًا مقلقًا لكنه ليس بالخطير، ناهيك عن أن بقاءه في غزة يحقّق أهداف حكومات اليمين المتعلّقة بإضعاف السلطة الفلسطينيّة، وذلك إلى جانب اعتبارها ليست شريكًا لمفاوضات سياسيّة، كما كرّر نتنياهو ذلك.
ليس ذلك فقط، فتصرّفات مسلحي "حماس" في السابع من أكتوبر 2023،تثير التساؤلات والأسئلة حول الأهداف الحقيقيّة، إذا كانت هناك كتلك، للهجوم المسلح المذكور، وهل كانت الأهداف واضحة ومعروفة ومحدّدة، أم أن الهدف كان اجتياز الحدود والجدار الفاصل، ومن ثم ليفعل كلّ مسلح ، وبعده كلّ مدنيّ اجتاز الحدود، ما يحلو له من أعمال دون حسيب، يتم في النهاية استغلالها ضمن الحرب الدعائيّة التي تدور خلال الحرب وبعدها، ويمكن القول إنه ربما كانت لحركة "حماس" ثلاثة أهداف أراد تحقيقها، الأول هو إعادة فتح وإحياء ملفّ الأسرى والمعتقلين والسجناء الأمنيّين الفلسطينيّين المحتجزين في السجون الإسرائيليّة. وهي قضية تتجاهلها إسرائيل، بل إن وزير الأمن الداخليّ في حكومتها الحاليّة، يعمل على تضييق الخناق عليهم ، بينما هي قضية تحاول "حماس" استخدامها ورقة لتحقيق إنجازات مقابل، أو أمام الفلسطينيين تمامًا كما كان الحال، خلال صفقة تبادل الأسرى التي تم فيها إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط، بعد نحو 5 سنوات من الأسر في القطاع، أما الثاني فهو تحقيق نصر معنويّ يبقى ماثلًا لسنوات طويلة وربما لعقود ملخّصه اختراق الحاجز الحدوديّ والسيطرة على معسكرات للجيش، وعدد من البلدات اليهوديّة، كردٍّ رمزيّ على احتلال الأراضي الفلسطينيّة،
وعمليّات القتل المستمرّة في الضفّة الغربيّة واستمرار اقتحامات المسجد الأقصى وكلّها أمور كانت الدول العربيّة قد حذّرت إسرائيل منها، خاصّة مصر التي حذّرت من تشديد السياسات المتطرّفة في الضفّة الغربيّة وشرقي القدس، وازدياد أعداد ووتيرة وقوة أصوات المنادين بتفجير وهدم المسجد الأقصى، والدعم الذي يحصلون عليه سياسيًّا، بينما كان الهدف الثالث فكان كما يبدو سياسيًّا ، فقادة "حماس" ورغم إدراكهم أن الردّ الإسرائيليّ على اجتياحهم سيكون "تسوية غزة بالأرض" في حربٍ لا تُبقي ولا تذر خاصّة إذا انضمّت إليها حركة "حزب الله" في الشمال، ورغم ذلك أدركت هذه القيادات أن حملة، أو حربًا كهذه بما فيها من ضحايا وسفك للدماء، ستمنع أيّ تقدم نحو التطبيع بين السعوديّة وإسرائيل، خاصّة على ضوء الجدول الزمنيّ القائم، بالنسبة لإسرائيل وإدارة بايدن، وهو ربما ما سيحدث الآن، ويثير السؤال حول ما إذا كان الردّ الإسرائيليّ سيكون ردًّا يطمح إلى تحقيق أهداف منها القضاء على "حماس" فقط، أم أن الردّ سيكون مجبولًا باعتبارات أخرى منها السياسيّة الخارجيّة كقضيّة التطبيع مع السعوديّة، أو ردّ الاعتبار لسمعة الجيش والمخابرات وغيرها، إضافة إلى أن أحدًا في إسرائيل لا يمكنه اليوم الردّ على السؤال الضروريّ والهامّ، وهذا نوع من التجاهل، أو دفن الرؤوس في الرمال،
حول ماذا سيحصل في غزة بعد انتهاء الحرب، ومن سيسيطر على قطاع غزّة بعدها، وهل سيكون ذلك منظومة أمميّة، أو دوليّة، أو غير ذلك من الأفكار والاقتراحات والمقترحات، أم السلطة الفلسطينيّة التي تم طردها بانقلاب مسلّح من حماس من القطاع عام 2007، والتي فقدت قواعدها وتأييدها ومكانتها منذ ذلك الحين، وهو حلّ معقّد ومرَكَّب يبدو الأبعد من حيث الإمكانيّة ولكنّه الأفضل لكافّة الأطراف، لكن مهما كانت هويّة وطبيعة الجهة التي سيتم منحها السيطرة على القطاع بعد الحرب الحاليّة، فإن المواقف الدوليّة والغضب العالميّ وانحسار الدعم الدوليّ للقضيّة الفلسطينيّة، رغم الحقيقة القائلة أن "حماس" لا يمثّل الفلسطينيّين كلّهم،
ولا حتى فلسطينيي قطاع غزة، فإنه يمكن الجزم أن "أكتوبر 2023" أنتج حقيقة واحدة سريعة وواضحة، وهي وأد القضيّة الفلسطينيّة ودفنها عميقًا داخل النسيان " أو داخل الارض"، وتضاؤل أعداد الإسرائيليين الذين ما زالوا يؤيّدون حلّ الدولتين، أو أي نوع من منح الفلسطينيّين، أي حلّ ينتهي إلى إقامة كيان سياسيّ أيًّا كان، مع الإشارة إلى أن معظم مواطني المستوطنات الإسرائيليّة المتاخمة للحدود هم من مؤيّدي حلّ الدولتين ومؤيّدي السلام مع الفلسطينيّين.
والعلاقة بين الحرب والقانون، أو بكلمات أخرى العلاقة بين كون الدولة في حالة حرب وبين وضع وحالة الديمقراطيّة بكافّة أبعادها في الدولة، لا تنتهي هنا ، بل تتجاوز ذلك ولا تقلّ أهميّة في بعدها المحلّيّ، أو الداخليّ، خاصّة وأنه من الواضح والمعروف، أن أيام الحرب هي " أيام الامتحان والاختبار" الأهمّ والأوضح لمدى الديمقراطيّة وقوّتها ومتانتها داخل الدولة، وفي الدول الديمقراطيّة، وخاصّة إسرائيل التي تعيش حالة خاصّة، بحكم وجود أقليّة عربيّة كبيرة تبلغ نحو ربع مواطني الدولة، تربطهم بالشعب الفلسطينيّ والدول العربيّة علاقات الانتماء القوميّ، وبالتالي تزداد أهميّة وحدة السؤال حول ما إذا كانت السلطات في الدولة، ستنجح في ضمان الديمقراطيّة، وما تكفله من حقّ التعبير عن الرأي،
ويبدو وفق مجريات الأمور حتى اليوم أن إسرائيل قريبة من الفشل في هذا المجال، أو أنها ستمنى بالفشل، خاصّة وأنني أخشى أن تنزلق الأمور من مجرّد محاولات يمكن تبريرها وفهمها، لمنع أيّ منشورات، أو معلومات أو مواقف تعتبر وتشمل، أو تشجع التحريض، وتحثّ على العداوة والكراهية، إلى ملاحقة غير مبرّرة للمواطنين العرب عامّة لمجرّد كونهم عربًا، وهو ما عبّرت عنه تصريحات المفتّش العام للشرطة يعقوب شبتاي، الذي قال خلال لقاء مع قادة الألويّة في الشرطة:" من يريد أن يكون مواطنًا في إسرائيل فأهلًا وسهلًا به، أمّا من يريد التضامن مع غزة، فأنني أدعوه إلى اعتلاء الحافلات المتّجهة إلى غزة وسوف أساعده شخصيًّا في ذلك"، وهي تصريحات غير ملائمة لشخصيّة أمنيّة كبيرة مثل شبتاي، كقائد عامّ للشرطة في دولة ديمقراطيّة، من واجبها حفظ حقوق المواطن التي يتيحها النظام الديمقراطيّ،
ومنها حريّة الرأي والتعبير. ومن الواضح أنه لا يحقّ لأيّ هيئة كانت في الدولة أن تصادر حقّ مواطني الدولة في التعبير عن الرأي حتى لو كانت هذه المواقف مثيرة للغضب وتختلف عن رأي الأغلبيّة، ما دامت هذه المواقف تندرج ضمن تعليمات القانون، ولا تصل حد التحريض والخيانة، فالنظام الديمقراطيّ يضمن حريّة التعبير عن الرأي، وحتى التظاهر بخلاف ما أعلنه المفتّش العام قائلًا: "اليوم ليس الوقت للتظاهر أو للاحتجاجات.. لا مكان للتسامح وانصح الجميع بعدم تحدّينا"، متناسيًا أو متجاهلًا عمدًا وربما لأسباب " شخصيّة وخاصّة" منها ربما رغبته في استعادة ثقة الوزير المسؤول عنه، إيتمار بن غفير، والبقاء في منصبه للسنة الرابعة على التوالي، ومتناسيًا أن المواقف والتهديدات الموجهة ضد الأقليّات، أو أصحاب المواقف المغايرة داخل إسرائيل، هي منزلق خطير للغاية، وأن " انعدام التسامح" الذي تحدث عنه المفتّش العامّ، قد يكون بداية النضال من أجل ضمان الديمقراطيّة" .
استمرارًا لما سبق، من الواضح من الأصوات العالية في الإعلام بأن إسرائيل تعيش اليوم مرحلة من الانتقام، أو جباية الثمن الباهظ، وأنها قد تشنّ حملة انتقاميّة واضحة ومخطّطة ومدروسة وعلنيّة. والسؤال هو ما إذا كانت حملة الانتقام هذه لها ما يبرّرها من أسباب ووقائع عقلانيّة لا بديل عنها، أم أنها حملة تنبع من رغبة عاطفيّة، أو غرائزيّة وقلوب يسودها الحزن والأسى، تحول دون التفكير في خواتم الأمور ونهاياتها، أو ما بعد مرحلة أو حملة الانتقام والثأر، كما تحول دون التفكير مليًّا في الثمن الباهظ للحرب من حيث عدد القتلى بين صفوف الجنود جرّاء العملية البريّة، وهل ستتم بكامل تفاصيلها تأخذ بعين الاعتبار القوانين الدوليّة وأخلاقيّات الحرب التي تتغنّى إسرائيل بها، أم أنها وهي تتم بدافع الثأر والانتقام ستتغاضى عن ذلك، وهو ما سيشكّل ربما تحقيقًا لأهداف غير معلنة وضعتها حركة "حماس" دون أن تأخذ بعين الاعتبار الويلات للشعب الفلسطينيّ الذي يعاني أكثر من مئة عام من أعمال فصائل مسلّحة لم توصل هذا الشعب إلى سيادة على أرضه، بل شرّدته وجعلت الملايين منه لاجئين في العالم وحتى في أرض غزة ,
بمعنى أن القيام بعمل عسكريّ يدفع إسرائيل إلى الردّ انتقامًا وثأرًا دون ضوابط قانونيّة، وهو ما تريده "حماس" ، مدركة أنه لا يمكنها الانتصار على الجيش الإسرائيليّ، وبالتالي فإن انتصارها سيكون في واحدٍ من ثلاثة، فإمّا جرّ الجيش الإسرائيليّ إلى عمليّة بريّة وحرب في مناطق مأهولة يتكبّد خلالها خسائر غير محتملة، أو وقف لإطلاق النار دون عمليّة بريّة، أو دون تحقيق إسرائيل كافّة أهدافها وهي بالمناسبة ضرب من شبه المستحيل، أو ضم جيوش من دول أخرى الى هذه الحرب، ما يجعل إسرائيل دون أن تريد ربما أمام حرب إقليميّة قريبًا من حرب عالميّة جديدة، وبالتالي وهذا ما تؤكّده تصريحات الرئيس الأميركيّ جو بايدن، مساء الإثنين من هذا الاسبوع التي قال فيها، ردًّا على سؤال لأحد الصحافيّين حول استعجاله إنهاء مؤتمر صحفيّ حين قال:" أنا متوجّه إلى غرفة قيادة الحرب"، ثمّ حاول تصحيح الأمر بأنه ذاهب لتلقّي معلومات حول الحرب، وهو تصريح يؤكّد لمن ساوره الشكّ أن أميركا تدير الحرب بشكل أو بآخر، وأنها تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، إلا أنها تهتم بأن لا ترتكب أخطاءً كارثيّة ومصيريّة، ربما ستحدث أو تزداد احتمالات حدوثها خلال عمليّات عسكريّة بفعل العاطفة وغير محسوبة.
موقف بايدن هذا يفسّره البعض على أنه كان السبب وراء تأجيل الاجتياح البريّ، ويجعله عرضة للنقد، أو حتى السخريّة من أنه "رئيس الوزراء الإسرائيليّ الفعليّ"، أو مدير الحرب، والذي يريد أولًا ضمان أهدافه وهي تحرير الرهائن وخاصّة من حملة الجنسيّة الأميركيّة، وضمان عدم إغضاب حلفاء أميركا من العرب، أو عدم إحراجهم أمام شعوبهم، وهو دور لا يقبله الرأي العامّ الإسرائيليّ الذي يكرر عبارات تصف حماس" بأنها داعش، أو "نازيي العصر الحديث" في محاولة لشيطنة كافّة من يقيم في القطاع، وتبرير استمرار القصف الذي أوقع آلاف القتلى. وهي المواقف السائدة التي تحرّكها مشاعر الانتقام أو غريزة الثأر، وهما نوعان معروفان من المشاعر يعتبرهما الكثيرون" في مرتبة الدونيّة ضمن قائمة المشاعر لدى الإنسان" لكن ما قام به مسلحو "حماس" وما رشح عنه، كان ربما كافيًا لتحويل هذه المشاعر المكروهة والتي تتسم بالدونيّة، ويعمد كثيرون إلى ذمّها واخفائها، بل مشاعر استخدمتها إسرائيل لوصف "دونيّة المشاعر العربيّة التي تؤمن بالانتقام والأخذ بالثأر" ، إلى مشاعر مشروعة .
ختامًا: ما سبق وذكرته حول مشاعر الانتقام والثأر وأخطارها يعيد إلى ذهني، تفاصيل ومجريات الرواية الشهيرة" المسلخ رقم 5" التي كتبها كيرت فونيغوت عام 1969، وتحوّلت إلى واحدة من أشهر الروايات المتعلّقة بالحرب العالميّة الثانية، وتحوّلت إلى فيلم يسرد قصف دول الحلفاء لمدينة دريزدن الألمانيّة بعد نهاية الحرب العالميّة الثانية، عبر بطله الذي يروي قصّة عمله كجنديّ يخدم في الجيش، تم اختطافه وكان اختفاؤه مع حراسه الألمان في ملحمة، أو مسلخ تحت الأرض سبب نجاته، والفيلم هو واحد من تلك الأفلام النادرة، بل الصادقة بشكل يشبه الأفلام الوثائقيّة، والتي تحاول سرد تفاصيل ومجريات وحيثيّات قصف الحلفاء الوحشيّ لمدينة دريزدن انتقامًا من ألمانيا والشعب الألمانيّ،
وذلك بعد أن استسلم الجيش الألمانيّ كلّه وانتهت مقاومته نهائيًّا، أي بعد أن انتهت الحرب العالميّة الثانية فعلًا في العام 1945، وهو قصف أسقط الآلاف من الضحايا المدنيّين، وتسبّب بدمار واسع وكبير للمدينة صاحبة التاريخ المعماريّ المميّز، وهو قصف تم بشراسة وبرغبة صافية في الانتقام والأخذ بالثأر( وإن كنا نتحدث عن شعوب أوروبيّة)، ودون أدنى إحساس بالذنب، أو تأنيب الضمير من قبل جيوش الحلفاء التي لم تتوقّف عملياتها العسكريّة حتى بعد أن اتضح انتصارها العسكريّ، فهل يعيد التاريخ نفسه؟؟